في هذه السنة، أي في عام 2017، يكون قد مر على إعلان بلفور مئة سنة، وكذلك مئة سنة على احتلال الجنرال أللنبي مدينة القدس، ومئة سنة أيضاً على هزيمة الدولة العثمانية وانسحابها من بلاد الشام. وبهذا المعنى فإن الحدث الأكثر خطورة في مصير المشرق العربي كان انتقال السيطرة على فلسطين وبلاد الشام من الدولة العثمانية إلى الاستعمارين البريطاني والفرنسي اللذين قسّما هذه البلاد، بموجب اتفاقية سايكس- بيكو، إلى كيانات طائفية: دولة العلويين للعلويين ودولة جبل الدروز للدروز ودولة دمشق ودولة حلب للسنة، علاوة على إعلان تأسيس لبنان كدولة للمسيحيين. ومع أن الثورة السورية الكبرى التي قادها سلطان الأطرش في سنة 1925 قبرت ذلك التقسيم في سورية، إلا أن سايكس – بيكو وكذلك مقررات سان ريمو غيّرا معالم المشرق العربي جغرافياً وسياسياً، وخلقا تحديات مازلنا نعيش نتائجها الكارثية حتى اليوم كالنزاعات الطائفية والكيانية والإثنية.
الحدث الثاني الأكثر خطراً والذي ما كان يمكن أن يحدث لولا سايكس – بيكو، هو قيام دولة لليهود في فلسطين في سنة 1948. فاليهود الذين كانوا أقلية في العالم العربي تمكنوا، لأسباب كثيرة، من تأسيس دولة منيعة في قلب العالم العربي. وهذا الحدث قلب الأمور في المنطقة العربية رأساً على عقب، وخلق تحدياً لا سابق له لدى العرب، خصوصاً في المشرق العربي، وها نحن اليوم بعد سبعين عاماً على صدور قرار التقسيم وبداية المعارك العسكرية في فلسطين سنة 1947، نجري نحو مسايرة العدو الصهيوني وتجنب خطره وفتح أبواب دولنا له من موقع الهزيمة لا من موقع الاقتدار. ومن المعروف، أن كل ثورة تحتاج حماية أو ظهيراً او ملاذاً. ولا يمكن أن تنتصر، أي ثورة، إذا لم تتحقق هذه الحماية. انتصرت ثورة فيتنام لأن الصين وروسيا وقفا يوآزرانها. ولم تنتصر ثورة السود في جنوب افريقيا إلا لأن دول الطوق الافريقية مثل أنغولا وزيمبابوي حمت النضال الجنوب افريقي وتحملت أثمان هذه الحماية. ولم تنتصر ثورة الجزائر لولا دعم جمال عبد الناصر لها. وما كان لحزب الله أن ينتصر في معركة تحرير الجنوب اللبناني لولا دعم سورية له، وايران أيضاً. أما الثورة الفلسطينية التي تلقت الدعم في بداياتها من الصين والجزائر، فما كان من إمكانها أن يشتد عودها لولا سورية ثم مصر عبد الناصر. واليوم ها هي فلسطين وحدها تقريباً، فلا أحد يشد أزر شعبها ، ولا دولة تقف إلى جانبها، وهي محاصرة في السياسة والأمن والاقتصاد، والأبواب العربية مغلقة أمامهاـ بينما الأبواب نفسها تفتح أمام الدولة الاسرائيلية. وها هي اسرائيل تتدرج في السياسة الخارجية من التسلل خفية إلى القصور الملكية والأميرية العربية، إلى الجهر بالغرام الجديد مع العرب. وانتهت على ما يبدو مرحلة العشق السري بين اسرائيل وبعض العرب حين أعلن رئيس الموساد مئير داغان أن اسرائيل مثل العشيقة السرية؛ الجميع يستمتع بها، لكن لا أحد يريد أن يعترف بذلك، وانتقل ذاك العشق إلى العلن مع وصول أنور عشقي إلى القدس، وكان آخر العشاق العلنيين الأديب اللبناني أمين معلوف والمعارض السوري كمال اللبواني.
الظهير المفقود
في خضم هذا المسار المتعرج، فإن في الامكان القول إن من بين أسباب تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية، علاوة على الأسباب الذاتية، وهي الأساس، هو عدم وجود ظهير عربي لها اليوم، لا في الأردن ولا في العراق أو سورية أو لبنان أو مصر. ومن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية الاستقطاب (ايران) والتدويل (اسطمبول).وهكذا صارت اسطمبول تصوغ سياسات فلسطينية عدة (المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد في شباط الماضي بدعوة من حركة حماس)، وباتت إيران لاعباً مهماً في الشأن الفلسطيني، بل إن بعض المنظمات الفلسطينية استطاب اللعب في الملعب الايراني من دون الملعب الفلسطيني. وهذه تحولات خطيرة جداً ربما تعيدنا إلى الاحتراب الداخلي، فهل ننسى ما أنزله صبري البنا (أبو نضال) بالحركة الوطنية الفلسطينية تنفيذاً للارادة العراقية تارة، أو للارادة الليبية تارة أخرى؟وهل ننسى إرسال مقاتلين فلسطينيين، ولبنانيين أيضاً، إلى القتال في شريط أوزو بين ليبيا وتشاد تنفيذاً لإرادة معمر القذافي، ولقاء بضعة ملايين من الدولارات؟
التحولات الاسرائيلية
ما برحت قضية فلسطين تراوح في مكانها منذ وقف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، بل قبل ذلك بالطبع، والواضح أن لا أحد يريد أن تخطو هذه القضية خطوات إلى الأمام. فمنظمة التحرير الفلسطينية واهنة جداً ولنعترف بذلك، ولا تملك، هي والسلطة الوطنية، أي رؤيا سياسية للمستقبل، ولا أي بديل عملي أو خطة بديلة بعد فشل سياسة التفاوض المباشر. والعرب مشغولون بأحوالهم وبالعنف الذي يدمر مجتمعاتهم ودولهم وشعوبهم. ولا توجد أيضاً أي ملامح واضحة للسياسة الأميركية تجاه قضية فلسطين، فعملية السلام لدى الإدارة الأميركية الجديدة غير مدرجة في قائمة أولويات سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، بل إن الإنحياز إلى اسرائيل سيكون قاطعاً في الولاية الأولى لدونالد ترامب. واستقالة ريما خلف (وهي فتحاوية بالمناسبة) من الأمانة العامة للإسكوا بعد التقرير الذي خُصص للوضع الفلسطيني والذي اتهم اسرائيل بإنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، هو برهان إضافي على قدرة الضغط الأميركي، والاسرائيلي استطراداً، على التأثير في الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس. وفي المقابل تغيرت اسرائيل كثيراً خلال العشرين سنة المنصرمة، فبعدما كانت النخب الاشكنازية تحكمها وتتحكم بالسياسات العامة وتصبغها بطابع أوروبي إلى حد بعيد، صارت دولة من دول العالم الثالث إلى حد كبير، فهي دولة واقعة جغرافياً عند أطراف العالم الثالث، وقد ازداد نفوذ المجموعات السفاردية فيها، وتحولت جموع اليهود إلى اليمين المتطرف، وأنغمرت في التعصب الديني الذي يظهر أكثر ما يظهر لدى المستوطنين. والجديد اليوم في اسرائيل أن الصراعات السياسية التقليدية ما عادت تجري على النمط الأوروبي، أي ما بين يمين ويسار ووسط، بل إنها تدور بين المتدينين المتطرفين والليبراليين اليمينيين. وهذا تحول جديد نحو العالمثالثية، حيث تزحزحت اسرائيل من أطراف المتوسط الأوروبي إلى تخوم العالم الثالث، وصارت مشكلاتها الداخلية تشبه مشكلات العالم الثالث كالعنصرية والتفاوت الاجتماعي والفساد والرشوة وتهميش بعض الفئات السكانية كالفلاشا والعرب ويهود اليمن، وصعود موقع المتدينين في جهاز الدولة. وهذا التحول بدأ مع وصول الليكود برئاسة ميناحيم بيغن، ثم يتسحاق شامير، إلى السلطة في أيار 1977، وها هو اليوم يبلغ الذروة.
إن ما يهم اسرائيل حقاً هو أن تبقى دولة يهودية قوية. وهذا يشير إلى التحولات التي طرأت على اسرائيل نفسها؛ ففي الماضي كانت اسرائيل تطالب العرب بالاعتراف بها ونبذ الأرهاب فحسب، أما اليوم فقد انتقلت الى مطالبة العرب والفلسطينيين بأن يعترفوا بها دولة يهودية للشعب اليهودي، وهذا يعني الاعتراف بها دولة قومية لليهود. والاعتراف بها دولة قومية يعني أن لليهود الحق في تقرير المصير في فلسطين. أي أن النضال الفلسطيني كان كله عدواناً على إسرائيل. والاعتراف باسرائيل دولة يهودية هو إلغاء صريح لحق العودة، وشطب نضال الفلسطينيين في أراضي 1948، فكأن اسرائيل تريد أن يوقع الفلسطينيون وثيقة استسلامهم يأيديهم.
في هذه الأوضاع المعقدة جداً يدرك الرئيس محمود عباس ان لا حلّ للقضية الفلسطينية. لكنه يدرك أيضاً أنه عالق في وضع لا يستطيع أن يبقى واقفاً في مكانه، خصوصاً أن الانقسام بين غزة والضفة قد ترسخ جداً، وهو برأيي ما دمر جوانب كثيرة من عناصر قوة الفلسطينيين وحيويتهم، على الطريقة التشبيهية التالية: لو أخذت قلم رصاص وقسمته قطعتين، فيصبح لدي قلمان، أستطيع أن أستخدمهما. لكن لو أخذت عصفوراً وقسمته قسمين فيصبح لدي قطعتان من لحم منتن لا عصفورين. وهذا ما حصل في انقسام غزة. وبالمناسبة، لماذا لا يذهب قادة حماس إلى غزة بدلاً من العيش في قطر وتركيا ولبنان.
في هذه المعضلة هناك خطابان: خطاب المصالح وخطاب الحقوق. خطاب المصالح صفر، لأن لا شيء لدى الفلسطينيين ليبيعوه إلى العالم. في الماضي كانت لديهم القدرة على تهديد مصالح بعض الدول، وبالتحديد حين كانوا حركة تحرر وطني. أما اليوم فلا يوجد لدينا إلا خطاب الحقوق: أي الحق في مقاومة الاحتلال، والحق في الاستقلال، والحق في مواجهة العنصرية، والحق في النضال من أجل العدالة والديمقراطية... وهكذا.
إنهم يخربون الأحلام
لسنا وحدنا في مأزق. اسرائيل نفسها في مأزق. فبعد نحو سبعين سنة على النكبة وصلنا إلى عجزين: عجز الاسرائيليين عن إطفاء شعلة التحرر الوطني لدى الشعب الفلسطيني، خصوصاً الشبان، وعدم قدرة الفلسطينيين على تحرير وطنهم. فإسرائيل غير قادرة على ضم الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بسكانها الفلسطينيين، وغير قادرة في الوقت نفسه على الانسحاب منها بعدما أصبح عدد المستوطنين فيها، من دون القدس، نحو 600 ألف فلسطيني. وما تعرضه يرفضه الفلسطينيون، وما يريده الفلسطينيون لا يمكن أن تقبل به اسرائيل. إذاً فالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي مفتوح على مصاريعه كلها. والصمود في المكان، والتشبث بالأرض هما من مقومات القوة في المستقبل.لكن يأبى كثيرون من الجماعات التكفيرية إلا أن يخرّقوا الأمل. فالحلم جميل جداً وكبير، وقضية فلسطين عظيمة، غير أن بعض الفلسطينيين يصر، مع الأسف، على التصاغر، وهؤلاء أصبحوا بالفعل صغاراً جداً جداً. أَليس هذا ما يحدث في عين الحلوة؟ وقد كان محمود درويش رائياً كبيراً حين قال: الطريق إلى البيت أجمل من البيت.












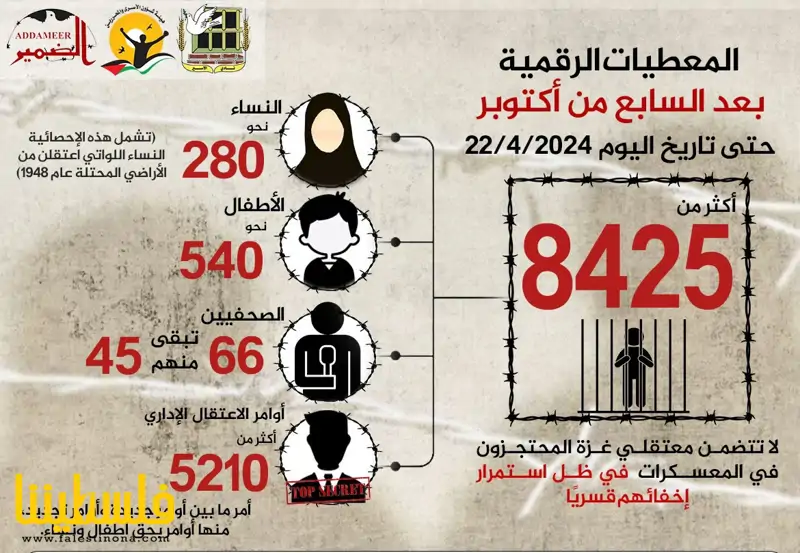


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها