خاص مجلة القدس العدد 332 تشرين ثاني 2016
اعداد: خالد أبوعدنان
الحلوة دى قامت تعجن فى البدرية * والديك بيــدن كوكو كوكو فى الفجـرية * يلا بنا على باب الله يا صـنايعية.... (سيد درويش).
عمال فلسطين ملح الأرض وبارود الثورة، طبقة اجتماعية تشكلت بسبب المشاريع الصهيونية الاستيطانية التي عملت على طرد الفلاحين من قراهم وتهجيرهم قسراً للمدن الفلسطينية الساحلية بداية القرن العشرين، فكانت بداية التداخل بين ما هو أكل فلاحي وما هو أكل أهل المدن. هذا الانقلاب في السلة الغذائية للفئات الفقيرة في المجتمع الفلسطيني ألغى الفوارق الجغرافية بين الشمال والجنوب أو الساحل والجبل فلا يوجد أكلة لا يعرفها الجميع، والمدهش أن الطبقة الفقيرة من عمال المدن اليهود تأثروا كثيرا بأكل القرية الفلسطينية. وهدف الدراسة تبيان ما هو أكل فقراء فلسطين؟ ومعرفة تاريخ المطاعم الشعبية؟ وأيضاً مقارنة أكل العمال الفلسطينيين واليهود في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
نبدأ الدراسة بالحديث عن تاريخ المأكولات في فلسطين ومعضلة اثبات ما يرويه لنا أجدادنا عن فلسطين وخيراتها، وقد يكون مفيداً فهم ما يعني أننا من الشعوب الشفوية التي تنقل ميراثها الحضاري من جيل إلى جيل عبر الاستماع والحفظ، وهذه الأزمة حقيقية في أمور تخص علم الأنساب والمعاملات التجارية، من هنا يكون توثيق مأكولاتنا أمر بغاية الصعوبة إلا إذا اعتمدنا على مصادر غير فلسطينية. وتؤكد بيان نويهض أن التاريخ الشفوي في فلسطين كان مقتصرا على النخبة القادرة على تدوين مذكرات ويوميات مثل خليل السكاكيني وإحسان النمر وكذلك المقالات الصحفية والعرائض الحكومية لكنه لم يدخل حيز تسجيل الذكريات إلا في بداية الخمسينات من القرن الماضي، أما الآن يعد التاريخ الشفوي الفلسطيني الأكثر تطوراً في المنطقة العربية بسبب كثافة الأحداث والبعد عن الوطن. بل إن مشكلة التدوين متأصلة بالتاريخ الفلسطيني .فقد كتب فراس السواح: المشكلة الحقيقية في تاريخ الكنعانيين أنه كان تاريخا شفويا غير مدون، وقليلة هي الآثار الباقية الدالة على نمط حياة الفقراء، فكل ما هو معروف لدينا عبارة عن ولائم القيادات العسكرية المنتصرة، فلا يمكن تحديد نوع الأكل من هذه القوائم الدسمة المليئة باللحوم. فالتدوين لم يكن مهماً بالحضارة الكنعانية فحتى التوراة والإنجيل فقد تم تدوينها بعد أكثر من مئة عام على نزولهما ولم يكن التدوين ممكنا لولا احتكاك رجال الدين بالثقافة الفرعونية ثم بلاد الرافدين.
ومن هنا يكون معرفة ما يأكله الفقراء في فلسطين خلال القرن التاسع عشر صعباً، إلا إذا قرأنا كتب الرحالة والقناصل الأجانب في المدن الفلسطينية، ويعد كتاب الحياة في البيوت الفلسطينية لماري إليزا روجرز مصدراً مهماً لكنه بالغالب أكل الطبقة الغنية والنخبة فهي دائمة ذكر الولائم واللحوم والشوكولاتة والباستا وأكلات أوروبية وأكلات تحوي على بندورة وبطاطا وهذا كله قبل عام 1860. أما في كتب القناصل الإيطاليين فقد ورد: أن العمال في عكا عزيزو النفس ويرفضون البغشيش، كما أن الإقطاعيين يأكلون معهم ولا يوجد مقاصف لطعام العمال، بل يبدو أن الطعام يحضره الاقطاعي فكل وكالة بخانات عكا تحوي على مطبخ كبير حيث يعدون الطعام للعمال وموظفي المكاتب، بل أن بعض التجار كانوا لا يحبون أن يأكلوا معنا باللوكندات والخانات المخصصة للطليان، رغم معرفتهم الجيدة بالأكل الإيطالي، فهناك عشرون طباخاً إيطالياً يعملون في بيوت الباشوات.
ويوضح المؤرخ شارل العيساوي ذلك: أن أجور العمال ارتفع الضعفين بين أعوام 1904-1914 في المدن الفلسطينية مع بقاء تكلفة المعيشة مساوية لما هو موجود في دمشق وحلب، مما سبب في انتشار مطاعم المشاوي وسندويشات الكبد والمعاليق وانخفاض حاد بتناول الفول والحمص الذي بات يصدر لدمشق وحلب. وكتب وجيه كوثراني: لم يكن هناك طبقة عاملة في فلسطين بالقرن التاسع عشر، فهي بلد الفلاحين بامتياز حيث شكلوا 85% من السكان طيلة هذا القرن، وهذا السبب الحقيقي بارتفاع أجرة العامل الفلسطيني مقارنة بالعامل المصري أو السوري، بل إن بعض الشركات الأوروبية كانت تستقدم عمالاً مصريين أو سوريين لمدينتي عكا ويافا لتحميل البضائع على سفنهم، ولم تتحول حيفا إلى مدينة العمل والعمال إلا بعد شراء الصهاينة أراضي مرج بني عامر والمناطق الساحلية من التجار العرب في أوروبا وبعض الأعيان الفلسطينيين من ثم طرد الفلاحين من قراهم وهجرتهم القسرية للمدن بحثاً عن مصادر عمل.
كتب القنصل البريطاني في يافا عام 1904: لابد أن لا نبالغ أن الشاي أصبح بديلا للقهوة، وأن مستوردات الشاي خفيفة مقارنة بالعراق ومصر، بل إن زراعة الشاي أصبحت منتشرة في قرى غزة والرملة وهي تهدد تجارة الشاي الهندي، كما أن الأرز الاسترالي رغم رخص ثمنه إلا أنه غير مرغوب لدى العوام التي تفضل الأرز المصري والهندي، فهذه البلاد لها ذوق خاص ولا تتأثر بغلاء الأسعار. وتذكر مدام بيل: أنه في يوم 11/12/1900 في القدس استضافتني السيدة فريدة اليامصة وقدمت لي الكاكاو ومعجنات عربية حلوة جداً والفستق الذي أحبه. وتذكر أن الفنادق في القدس وأريحا وحيفا تقدم المأكولات الأوروبية، وتُسهل عمليات البيع والشراء وتوفر مرافقين للرحلات البعيدة وكذلك الأحصنة، ولقد سجل الجيش الألماني عام 1911 الطعام في فلسطين: إن الفلسطينيين لا يأكلون إلا الأكل المطبوخ، وأن أكلهم بالغالب يحوي اللحوم أو البيض ويتم تطهيته بالفرن الذي يبيع الخبز بالمدن، فهو يصنع صواني الكبدة والكفتة والباميا والدجاج وغيرها، كما أن إفطارهم من المعجنات والمناقيش وأقراص الزعتر والجبنة، ويوجد بالقرب من كل فرن محل لبيع الخضروات ومقهى لبيع الشاي، وهم لا يشربون القهوة مع الطعام، بل يشربونها فقط مع الحلويات وخاصة المعمول والبرازق.
وهنا نرى أن فقراء فلسطين كانوا قادرين على توفير طعامهم في الظروف العادية، وهذا مشابه لما سجله واصف الجوهرية عن أكل الفقراء في عام المجاعة بأغنيته (كرشات كرشات محشية * بيضات بيضات مشوية * يا سمك يا سمك يا سمك مقلي * واسكب واشرب وغني واطرب * بادر بادر واشرب * ما على الانسان من مهرب * فالسكر أنفع * منه لا تفزع * قبوات قبوات مقلية * كبة كبة كبة باللبنية * يا جزر يا جزر يا جزر محشي * أقم في كرشي * كوسا كوسا كوسا بلحمة * كشكة كشكة كشكة بالشحمة * يخني بتنجان * مع رز مفلفل * يا كنافة لا تغيبي أبداً عني * يا مهلبية منيتي وقصدي * يا هريسة اللوز إنت أفخر * المأكول بعد المحشي * فستق بيدق طقش فقش * عبّي الأركيلة وحشش * وعن القطايف فتش * بعدها أسنانك نكش * أكل هالألوان * لازمله حمام). وسجل يسرى عرنيطة أغنية عن انحباس المطر في رام الله: ( يا ربنا يا ربنا واحنا الصغار ويش ذنبنا * طلبنا الخبز من أمنا ضربتنا على تمنا * شوربنه شوربنه * يا ربنا ما هي بطر تعجل علينا بالمطر * شو بدك ع قلة بده مطر بده سيل * يا ربي بل الشرموح واحنا تحتك وين نروح * شوربنه شوربنه). فالفقير في فلسطين لن يموت جوعاً فهي فعلا أرض اللبن والعسل.
عام الجراد والمجاعة عام 1915 الذي حصد أرواح عشرات آلاف بالمدن السورية واللبنانية لم يكن بهذه القسوة في فلسطين، فقد ذكر سليم تماري: أن التجنيد الإلزامي والموت في الحرب العظمى وغياب أعداد كبيرة من الرجال والشباب عن عائلاتهم السبب الحقيقي في انتشار الجوع والفقر والدعارة بالمدن الفلسطينية، ولم يصل الجراد إلى القدس إلا في صيف عام 1915 وبعدها انتشرت أمراض الكوليرا والتيفوس، إلا أن الوضع في سوريا ولبنان كان كارثياً ومأساوياً بينما كانت فلسطين تحت السيطرة نوعاً ما. ويضيف مؤرخ تاريخ الهيكليين الألمان في فلسطين بول سوور: في منتصف شهر إبريل وصل الجراد لمنطقة الولجة (قضاء حيفا) وكان أصفر اللون لكن كثافته حجبت ضوء الشمس، وقد نصحنا الفلاحون العرب من عدم شرب المياه مباشرة فهي بحاجة للغلي، لكننا فقدنا كل محاصيلنا الزراعية والكثير من الحيوانات والدواجن. أما في قرية سارونا (قضاء يافا) فقد كانت الاحتياطات أفضل وتعلمنا من الفلاحين العرب طرق حرق الجراد وإبعادها عن الحيوانات، لكننا أيضاً خسرنا محاصيلنا الزراعية، لقد قتلنا الكثير من الجراد حتى باتت الأرض صفراء من كثرة الجراد إلا أن الجراد كان يأتي ويأتي إلى ما لا نهاية، فمهما كانت لدينا تقنية ومهندسون وخبراء صحة، فالجراد كان بكميات لا توصف وقد أصيب العديد من الأطفال والنساء بأمراض التيفوس والكوليرا لكننا استطعنا توفير العلاج المبكر لهم. كما دوّن إحسان الترجمان: إن الجراد لم يُبقِ ما يأكله الفقراء لكن التكايا والزوايا كانت توزع الخبز مجاناً وبشكل يومي، كما أن الحصار البحري الذي فرضته الأساطيل البريطانية والفرنسية تسبب بإيقاف تصدير البرتقال، مما جعل البرتقال أكل الفقراء فكانوا يطبخونه بوصفات مستحدثة، إلا أن هذا كله لا يعني أن الجوع لم يكن منتشراً بل أن بعض الفقراء أكلوا من المزابل.
وذكر محمد إسعاف النشاشيبي: أن الجيش العثماني أثناء الحرب العالمية الأولى سبب كسادا اقتصاديا ضخماً في المدن الفلسطينية بسبب ما أخذه من التجار من تموين للعساكر شملت على الخراف والأبقار والدواجن والأرز والبطاطا والحبوب والسكر والشعير والتبن وزيت الزيتون والصابون ، ويضيف صالح البرغوثي: كان الجيش يطلب منا إفطارا كل صباح يشمل على خبز الطابون وجبنة وزيتون والبيض المسلوق والشاي مع سلطة خضروات تشمل على الخيار والبندورة والبصل. أما الأستاذ عادل جبر فذكر أن الجيش العثماني فقد طرق امدادته وإنه من الطبيعي أن يطلب العون من الأهالي، وهناك مبالغة بأن الجيش أفقر المدن الفلسطينية بل إن التجار سعوا لتعويض خسائرهم عن طريق رفع الأسعار، لكنني كنت أجد الدواجن واللحوم على موائد علية القوم حتى في عام الجراد (1915). كما أن الحرب أوقفت تجارة التصدير فلم يجمع الكثير من البرتقال، وعام الجراد هو عام البرتقال بامتياز حيث أنه أصبح أرخص الموجود بالأسواق وتم إدخاله في الطبيخ والسلطات، بل إن البعض بالغ بشربه بدل الماء الملوثة من الجراد. إلا أن أغلب المؤرخين يتفقون على أن انقطاع الطحين هو سبب تسمية ذلك العام بالمجاعة، حيث أن الناس كانوا يعرضوا على الجيش العثماني مبادلة الطحين بمحاصيل أخرى إلا أن الجيش كان يُصر على نظام الحصص المقننة لكل منطقة، إلا بداية شهر رمضان كانت نهاية للمجاعة، حيث أمر السلطان بتوزيع الخبز مجاناً في المدن والبلدات وأقيمت الإفطارات المجانية في الجوامع والتكايا والزوايا والمقامات، بل إن يوم التاسع من رمضان عاد الطحين للأسواق ومنها جاءت المقولة الشهيرة فلسطين بتعشق الطحين الله ينصر سلطان السلاطين. وفي العشرة الأواخر عاد البصل إلى الأسواق وكان له هالة كبيرة أكثر من اللحوم والحبوب الأخرى. وقد سجل وزير إدارة التغذية الأمريكي هربرت هوفر عام 1917: الطعام سينتصر في الحرب، ويصنع السلام، من يصمد ينتصر.
وبدخول القوات البريطانية إلى فلسطين كان نمط أكل العمال يعتمد أساساً على الزوادة وهي أكل يجلبه العامل معه من البيت، وفي الغالب يكون أكلاً مطبوخاً قبلاً بيوم، ويسمى بايت أو توالي الأكل، وهو أكل يحتاج إلى الخبز لتغميسه وبعض المخللات مثل الزيتون أو الخضراوات الطازجة مثل البندورة والخيار والجرجير والبصل، إلا أن عمال الأسواق كانوا يأكلون بالسوق من محال صغيرة متخصصة مثل الفوال والحمصاني والكبابجي والجبّان وبائع اللبن، ويكون الأستاذ جهاد دكور شاملاً عندما يحدد ما يمكن أكله بالأسواق: المطعم التقليدي يبيع شواء اللحمة خاصة الكبدة على الفحم والكانون والصاجية، كما يبيع الفلافل والحمص والفول والمسبحة والفتة والبيض المسلوق ولبن ولبنة وزبدة والمقالي وجبنة. أما المشروبات الباردة فلها محلات خاصة تبيع سوساً وتمر هندي وتوتاً وليموناضة وبوظة على عيدان وأسكيمو وكازوزاً وقهوة. إلا أننا لم نجد إلا محال متخصصة بأحد الأصناف بالكتب القديمة، ولا نرى أنه كان هناك مطاعم قادرة على تقديم هذه اللوائح الطويلة من المأكولات. وفي تفصيل بعض الحرف يذكر دكور: القهوجي كان يحمل بكرجاً خاصا فيه جزأين الأول للجمر والثاني للقهوة المطبوخة بالهال، وكان يجول بالأسواق والمنتزهات وأغلب أصحاب المهنة من عرب البلاد المجاورة. أما الدوّارة: هم عمّال عرب من بلاد المجاورة يجمعون أكياس الخيش المستعملة من الأسواق ويقومون ببيعها لخياطي الخيش الذين كانوا بالغالب من اليهود. وبخصوص الجبّان المدني هو بالغالب يهودي يتجول في القرى والحارات لجمع الحليب لصناعة الأجبان، وأهم أنواع الجبنة التي كان يبيعها اليهود للقرى الفلسطينية هي القرمانية والمغلية والزيتية والمشروشة.
ومن هنا نرى أن الفلسطينيين من شعوب الخبز التي تعتبره مرافق لجميع المأكولات حتى التي تحوي على الأرز، لكن طريقة الأكل هي بتغميس الجوامد الهلامية مثل الفول أو تقطيع الخبز داخل الحساء مثل فتة العدس وغيرها. أما مفهوم فطيرة أو لفة أو عروسة المرادف لسندويشة أو برجر عند البريطانيين فلم يكن من ضمن ما يمكن شراؤه من الأسواق، بل إن هذا النمط دخل إلى فلسطين بعد عام 1920 ضمن خدمات مقدمة للجيش البريطاني. ويذكر ضباط الجيش البريطاني لوكندة مرقص بالقدس كأفضل مكان لتناول الإفطار على النمط الإنجليزي، وهي نفس اللوكندة التي قال عنها الجنرال اللنبي أنها جزء من بريطانيا واستغرب كثيراً عندما علم أن الطهاة كلهم عرب ولا يجيدون اللغة الإنجليزية رغم ذلك يطبخون وفق الأصول البريطانية. وهذا الإجحاف بحق الفنادق الفلسطينية مكرر كثيراً في فترة الانتداب، حيث أنهم لم يكونوا على إطلاع على عراقة الخدمات الفندقية في فلسطين في العهد العثماني، ولا بحجم زوار فلسطين من الحجاج المسيحيين الأوروبيين، وهذا كله جعل البريطانيين يضغطون كثيراً لتحويل ملكية الفنادق للصهاينة أو التجار الأوروبيين، وخلال فترة خمس سنوات استطاع الصهاينة شراء العديد من اللوكندات الكبرى في عكا وحيفا والقدس بمساعدة الجيش البريطاني الذي فرض العديد من الأحكام العرفية لإفلاس هذا القطاع قبل بداية الانتداب السياسي عام 1922. ومما قاله الإنجليز عن مصر أنها مملكة العدس، فمهما كان الفقر مستفحلا إلا أنها قادرة على إنتاج العدس الكافي لفقرائها، ونظرية العدس هذه مأخوذة من القصص العتيقة لليهود، وقبل أن نورد أهم قصتين للعدس بالتراث اليهودي، لابد أن نذكر أن الإنجليز فرضوه كطعام واحد على السجناء الفلسطينيين الذين حاربوا مع الجيش العثماني، لكنهم وجدوا أن السجناء يرفضون أن يأكلوه كطبق يومي كما أن هناك أكلاً أرخص منه بالمدن الفلسطينية.
بخصوص ذكر العدس فقد ورد في سفر التكوين: أن يعقوب (عليه السلام) طبخ يخنة عدس (مكونة من العدس المجروش والسُماق والبصل وهي جامدة وتُغمس بالخبز أو الطريقة الحديثة هي عملها اليخنة السائلة وتفتيت الخبز بها وأكلها بالمعلقة)، فجاءه أخوه عيسو يطلب القليل من الطعام، فطلب منه يعقوب أن يمنحه البكورية ( أي البيعة ليصبح نبياً بالوارثة بعد أبيه إسحاق بن ابراهيم عليهما السلام)، فقال عيسو أنه يريد أن يأكل ولا يستطيع أن يصبر على الجوع، فأعاد يعقوب طلبه، فقبل عيسو بالبيعة وأكل الصحن وحده. ويخبرني الرفيق جاي غيلور: أن هناك رواية مشهورة في التناخ (كتب الشريعة اليهودية) وهي أن في المغارة المكفيلية بالحرم الابراهيمي كان هناك وقف يهودي يصنع يخنة العدس على طريقة يعقوب عليه السلام مع خبز عشرة آلاف رغيف خبز طابون للفقراء وزوار المغارة، وكان عدد الذين يأكلونها بالمغارة بشكل يومي سبعة آلاف يهودي. فقلت له أن هذا بحاجة لميزانية ضخمة، فقد يكون ذلك بموسم ديني معين، فرد علي جاي: لا يوجد شيء محدد بالكتاب، لكنه يتحدث فترة ازدهار المملكة اليهودية الجنوبية يهوذا.
أما عن أن الخبز لا يعتبر أكلاً كافياً للعمال ولابد أن يكون مصحوباً بشيء من البقول فذكر ناثان أوسوبيل: قصة الجائع من التراث اليهودي، يُقال أن بافزي (Bavsi) كان أغنى رجل في العالم في زمن الملك سليمان (عليه السلام) لكنه كان يظلم عبيده ويجعلهم يعملون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دون أن يضع على خبزهم أي طعام، ولم يكن للعبيد حق الشكوى للسلطات ضد مالكهم، إلا أنهم صاروا يخبرون الناس عن بافزي البخيل الظالم، ولمّا علم الملك بالأمر دعا بافزي لتناول وليمة العشاء معه، ففرح بافزي بهذا، إلا أن حارس الملك طلب منه الحضور في الصباح دون أن يحضر أي هدية معه، فقال له بافزي: هل يبدأ العشاء الملوكي من الصباح حتى المساء؟ يبدو أنني سأقضي يوماً رائعاً. ولما دخل بافزي القصر تم إجلاسه على أريكة قرب باب المطبخ وأصبحت رائحة الطبيخ تملأ أنفه، إلا أن انتظاره طال وصار يتضور جوعاً، ويسأل متى سيأتي الملك؟ ولا أحد يجيبه، وفي وقت المغيب طلب بافزي أن يغادر القصر إلا أن الحارس منعه وألزمه الجلوس على نفس الأريكة. في المساء جاء الملك وجلس مقابل بافزي وطلب طعاماً، فجاء الخادم بصحن واحد به سمك مشوي فأكل الملك وبافزي يناظره، ولما شبع الملك طلب من الخادم أن يأخذ الصحن ويمرره قرب أنف بافزي ثم غادر، ثم طلب الملك الحساء، فجاء الخادم بحساء اللحم بالخضراوات وكان لعاب بافزي يسيل فسأله الملك هل تتمتع بضيافتي؟ فقال بافزي: أنه أجمل أيام حياتي. شرب الملك من الحساء ثم أمر الخادم ليمرره قرب أنف بافزي ثم يغادر، فقال الملك لقد شبعت الآن، فقال بافزي: إذن أتركك حتى ترتاح فاسمح لي بالانصراف، فقال الملك: لابد أن تسمع بعض الأغاني معي، فطلب الملك المغني والعازفين وبدأ يغني وبافزي يتضور من الجوع، إلا أن الملك سهر حتى منتصف الليل ثم قام وقال أنه ذاهب للنوم، وقال لبافزي: ستنام الليلة هنا وسألتقي بك في الصباح. لم ينم بافزي من شدة الجوع وصار يفكر لماذا يتصرف الملك معه بهذه الطريقة؟ حتى فهم الحكمة من ذلك وفي الصباح اعتذر من الملك وقال له سوف أطعم عبيدي قبل أن آكل.
إلا أن الأكل ليس شيئاً من مكونات الدين بل هو جزء من الهوية القومية لأي شعب، ولا يمكن التحدث عن وجبات تخص ديناً محدداً إلا بالحديث عن طقوس الصوم أو المواسم الدينية التي يكون لها أكل موسمي لا يؤكل إلا بوقت محدد من السنة. ومهم جداً ما ذكره شلومو ساند: أن الصهيونية أرادت أن تصنع قومية يهودية عن طريق التطبيق الحرفي للتوراة كأسلوب حياة، لكنها فشلت منذ البداية بإلزام المستوطنين الأوائل بأكل ما ورد بالتوراة فقط، لكنها اكتفت بالرقابة على الذبح على الطريقة الموسوية الكوشر، وكل ما يُقال عن طعام عبري هو هراء، فأكل المستوطنين متنوع من كافة أماكن قدومهم. ويشرح كوهين ذلك: فاليهود عاشوا مع غيرهم من الطوائف في نفس المدن في فلسطين العثمانية ولم يكونوا معزولين كما كان عليه حالهم في أوروبا وظل الوضع كذلك في معظم الوقت، حتى أنهم كانوا ممثلين في المجلس العمومي والإداري العثماني في القرن التاسع عشر. ويسجل عبد الوهاب الكيالي: كان يزور فلسطين يهود من اليمن كغيرهم من اليهود، حيث اعتادوا على القدوم إلى فلسطين في آخر حياتهم للبقاء والموت فيها أو لزيارة الأماكن المقدسة ولكن أعداد هؤلاء كانت قليلة كما أن هجرتهم إلى فلسطين لم تكن هجرة منظمة بل فردية وطوعية وشجع هؤلاء على المجيء أيضا وجود نوع من الحركة التجارية بين فلسطين واليمن في تلك الفترة، ولتشجيع يهود اليمن على الهجرة إلى فلسطين زارهم من القدس الحاخام اليهودي يعقوب سافير1858م ومكث عندهم سنتين خلالها بذل جهودا لاقناع هؤلاء بالهجرة.
فأغلب الهجرات اليهودية العربية لفلسطين كانت من طائفة القرائين قبل ظهور الفكر الصهيوني، وهي كما ذكر بنيامين التطيلي: القرّاؤون فرقة يهودية أسسها في العراق عنان بن داود المتوفي عام 800م نتيجة خلاف نشب حول توليته منصب رأس جالوت ( تحريف للفظ الآرامي رشتا جالوتا أي زعيم الطائفة أو الجالية) حيث أن أعضاء المجلس ذكروا فساد سيرته وقلة تقواه، لكن العراق في ذلك الزمن كان يحفل بالنزعات الفلسفية مثل إخوان الصفا والمعتزلة، وقد تأثر علماء اليهودية بهذه الثقافة وصاروا ينتقدون الحاخامات ويخرجون ببدع مخالفة للتناخ وخاصة التلمود، لكن عنان روّج لمذهبه وبنى كنيسا له بالقدس وأصبح له أتباع في مصر والشام والعراق وحتى جزيرة القرم. أما التسمية فهي قادمة من بني المقرئ التي شرحها بكتابه الفذلكة، حيث اعتبر أنه يتمسك بالمعنى الحرفي بالتوراة ويرفض باقي التناخ. وقد هاجر المئات من أبناء الطائفة من مصر والعراق واليمن في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى فلسطين، إلا أن قوميتهم العربية ساعدت في اندماجهم السريع بالمجتمع الفلسطيني وتميزهم خاصة بصناعة الجبنة والخياطة والعطارة والطب. وكتب الشيخ عبد الحميد السائح: أن اليهود العرب كانوا جزءا من المجتمع الفلسطيني بل إن العلاقة كانت أكبر من مجرد جيران وشركاء بالعمل، بل إن هناك مصاهرة ونسباً مشتركاً في العديد من المدن الفلسطينية خاصة يافا والقدس وصفد.
ذكرنا اليهود اليمنيين بشيء من التفصيل لأنهم رواد المطاعم الشعبية في الدولة العبرية، بل أنه ولغاية الآن يعتبرون أصحاب أغلب المطاعم الشعبية في تل أبيب وحيفا. وهم بامتياز أصحاب فكر العمل الحر بعيداً عن فكر العمل العبري والقرى التعاونية المعروفة بالكيبوتس وباقي صيغ العمل التي فرضها اتحاد العمال الصهيوني المعروف اختصاراً بالهستدروت. وقد طلبت من الرفيق جاي غيلور ترجمة بعض الدراسات عن الأكل الشعبي في فترة الانتداب البريطاني. ترجم لي ما كتبه يفانإييل ماتالون: في كتاب ذكريات تل أبيب من 1919 إلى 1939: ( في العشرينات الفلافل لم يكن مقبولا من الأشكنازيين القادمين من شرق أوروبا وروسيا، إلا أن أطفال تل أبيب عشقوا طعم الفلافل رغم أنه لم يكن هناك أي مطعم عصري يبيعها، ولكن اليهود اليمنيين هم من أدخلوها على تل أبيب وكان موقع مقاصفهم مقابل مدرسة منطقة هرتسيليا العبرية معروفة باسم الجيمينازيا، وهي قرب منزل أحد مؤسسي تل أبيب أكيبا إريا وايز أي منزل رقم 2 في شارع هرتسل. في وقت الغداء كان مئات الطلاب يتوجهون لمقاصف الفلافل لأكل الفلافل ومشروب الصودا، ولا يأكلون الفطيرة التي أحضروها معهم من البيت. مقاصفهم كانت على عربات متحركة لينقلوها بسرعة إذا جاءت الشرطة البريطانية. وهي عربة لها قطع خشب مسطحة يوضع عليها جاط من الفلافل الجاهز للقلي، وبالقرب منها مقلاة كبيرة بها زيت يغلي، ومن الجهة الأخرى من الخشبة هناك ربطات خبز بيتا (الخبز اليوناني بيتا المقابل الأوروبي الشهير للخبز العربي الذي يفتح من المنتصف إلى رقائتين) . كان المعلم يجهز كرات الفلافل قبل الساعة الحادية عشرة. ويأتي الأطفال ليأخذوا أتوقع خمس حبات فلافل مع القليل من الطحينة أو سلطة الخضراوات ورغيف خبز واحداً.
ويتابع يفانإييل ماتالون: في يوم من أيام 1926 (كان عمر الكاتب سبع سنوات) وأنا متجه إلى جيمينازيا وبالقرب من زاوية شارع أحاد حاعام، فجأة شرطي بريطاني طويل يشبه الشرطة البريطانية في انكلترا. ذهب إلى مقصف الفلافل وصرخ عليه بالعربية: يلّة إمشي. والبائع تفاجأ وهو يحضر خلطة الفلافل وحاول أن يقول شيئا للشرطي، إلا أن الشرطي بدأ بركل العربة وقلبها على الأرض وتناثرت مكوناتها في الشارع. ثم ذهب الشرطي أما البائع اليمني المسكين بدأ بلملمة أغراضه وذهب من الشارع. هذا الحدث صدمني، شعرت بالشفقة على البائع المسكين والغضب على الشرطي البريطاني، لكن والدي شرح لي: القانون البريطاني ليس مثل القانون العثماني القديم، فالبريطانيون قلقون على صحة الناس من أجل مصلحتهم، ثم ذكر لي ما قاله الدكتور المشهور بلاتكا ليكون مشرفا على الصحة العامة في تل أبيب نيابة عن وزارة الصحة في القدس. القانون البريطاني يعمل من أجل مصلحة المستوطنين ويحاربون الفلافل من أجل الحفاظ على صحة العامة ، ليمنعوا انتشار الأمراض التي يسببها أكل الباعة المتجولين غير الصحي. كما أن مدير مدرسة جيمينيزيا اقتنع بتوجيهات طبيب المدرسة لحياربة بائعي الفلافل المتجولين. ثم قررا الطلب من المسؤول عن المقصف الداخلي للمدرسة برويدا وزوجته ليتعلما كيف يعملان الفلافل لأنهما منعا خروج الطلاب من المدرسة وقت الغداء، وأي طالب يريد فلافل يمكن أن يشتريه من كنتين المدرسة. لما قضم التلاميذ أول لقمة من الأشكنازي فلافل قالوا جميعا: هذا ليس فلافل أرجعوا لنا أموالنا. ولم يعجبهم الفلافل ولم يعد برويدا يصنع الفلافل، وسُمح للطلاب أن يذهبوا للباعة المتجولين من جديد حتى تم افتتاح مطاعم الفلافل الرسمية بالمدينة وهي بالغالب لليهود اليمنيين.
يشرح كاسترو نوم ميزة الفلافل: أنه يناسب الصيام وكذلك الأكل الكوشر الذي لا يخلط اللحوم مع المنتوجات الحيوانية الأخرى مثل اللبن والبيض. وهذا مذكور بالتفصيل في كتاب الأكل الإسرائيلي من الجوانب الإثنية في المجتمع الإسرائيلي تأليف أوز الموق من مركز صومائيل نيمان للدراسات والعلوم والتكنولوجيا وأيضا في كتاب المطاعم في إسرائيل – أحداث تاريخية مهمة الفصل الأول.
وفي كتاب مطابخ الشغيلة والمطاعم التعاونية وأكل البيوت كجزء ملازم للتطور الثقافي في فلسطين (إي . آي) صدر عام 1925: (عانى المستوطنون الصهيونيون الأوائل من ظروف معيشية صعبة، والطعام على طاولتهم كان قليل الكمية وضعيف الجودة وبالكاد يحوي على السعرات الحرارية والفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحتهم. في العديد من المستوطنات كان الناس ينامون جياعا، كما أنهم اعتادوا على طبيخ المتقشف المكون من مادة واحدة. على سبيل المثال في قرية ييهوشا (هي كيبوتس تعاوني عاشوا نظاما اشتراكيا صارما حيث الأكل والمشرب والمبيت مشترك) كان عندهم قائمتان لطعام الغداء: الأولى وجبة الملفوف وهي تشتمل على طبيخ مخلل الملفوف، وسلطة ملفوف، الملفوف مشوي، حلوى الملفوف. أما القائمة الثانية فهي قائمة حبوب الفاصوليا المجففة وتشمل على حساء الفاصوليا وفطائر الفاصوليا وحلوى الفاصوليا. ومن أغاني الكيبوتس الفلكلورية: لم نأكل بعد لم نشرب بعد وهو يعد النشيد الوطني للمستوطنين العمال في تلك المرحلة، ثم أصبح من أناشيد الشبيبة والكشافة في الحركات الطلابية والتجمعات الشبابية التي حارب الطبقية في المجتمع الصهيوني حيث يعيش الفقير على الفتات ويتنعم الغني بكل شيء. إن المستوطنين الأوائل منعوا الاحتفالات التي تحوي على الولائم ليس بسبب مواردهم الفقيرة وصعوبات وجودهم في فلسطين فحسب، لكن بسبب إيمانهم بالاشتراكية الشعبية التي ترفض البذخ وتحث على التقشف. كما أن أكل اللحم المجفف كان له متعة وبهجة لدى الجميع طبقا للقبول الرسمي من القيادات العمالية التي رفضت الأفكار الأنانية وجعلت نفسها قدوة للأجيال العمالية الصهيونية في طريقة بناء المجتمع المتقشف والاعتماد على الذات من خلال تطبيق العمل العبري.
ويتابع الكتاب التغني بالعمل العبري إلى أن يصل إلى فصل التغيير الفكري عام 1927 وهنا يذكر: إن استفحال الآليات البيروقراطية في الوكالة اليهودية والأحزاب العمالية وأيضاً التوسع اللامنهجي في عدد عمال البناء في المدن، أجبر قيادات المستوطنين للبحث عن فكر توافقي بين نمط الحياة البرجوازية ومئات المبادئ الاشتراكية. فجاءت حلولهم جديدة عن طريق إقامة إسكانات للعمال في المدن وهي خطوة لم تكن تحظى بقبول ديني ولا فكري إلا أنها بداية ظهور الأفكار الصهيونية العملية، أما على صعيد إعداد الطعام للعمال فقد تم قبول أربعة حلول ورفض باقي الصيغ البرجوازية، والحلول المقبولة لها صيغة أكل الشعب والمطاعم الشعبية، أبسطها كان يُسمى أكل البيوت وهي نقل فكرة مطبخ الكيبوتس للمدن، حيث يتم تحضير الطعام من قبل الزوجين في منزلهم ثم يستقبلون العمال في غرفة ضيوفهم. أما صيغ أكل الشارع فقد تنوعت وشملت على أكشاك ومقاصف مشاريع متعددة مثل مشروع مطاعم تِنوفا للمنتوجات الحيوانية الطازجة من الألبان والأجبان والحليب والبيض والزبدة والخضروات الحقلية خاصة الخيار والملفوف والبندورة القادمة من برامج العمل العبري في الكيبوتسات. تُعد شركة تنوفا أول مشروع يراعي المقاييس الأوروبية في القيم الغذائية للعمال والطبقات الشعبية مما شجع العديد من المشاريع في المدن لخدمة الطبقة العاملة مثل المطاعم التعاونية مثل بيت برينر تل أبيب و هايم في شارع الإخلاص حيفا. ومطعم هايم كان أول من قدّم المأكولات الأوروبية الشرقية بأسعار رخيصة مثل الشنيزيل ومهروس البطاطا ومخلل الخيار ورز بحليب وفطائر السمك والباذنجان المشوي وفطائر بودنغ. أما مطاعم الشغيلة التابعة للهستدروت بالغالب رغم أن بعضها كان ملكية خاصة لبعض العائلات الفقيرة في حيفا، إلا أن ما تقدمه من طعام كان مماثلاً لما هو موجود في كيبوتسات حيث نوع واحد من الطعام لكل يوم، وكان أرخص طعام متوفر للشغيلة إلا أن هذه المطاعم واجهت العديد من الصعوبات الإدارية بسبب القرارات المركزية في الهستدروت وهي لا تتناسب مع مفهوم مطاعم الشغيلة التي تكون بحاجة لقرارات آنية. وآخر هذه المشاريع كان في مواقع الإنشاءات الكبرى حيث كانت تحوي على مطبخ للعمال يشرف على إعداد الطعام لهم طباخ محترف لكنه لا يُقدم إلا وجبة غداء وللعاملين في المشروع فقط.
أما في كتاب نوستالجيا عن كيبوتس بيت هاشيتا: إغلاق مطاعم العمال ومطابخ الشغيلة جاء بسبب أن الشغيلة لم يعودوا جياعا، بل أن مدخولهم تضاعف بشكل كبير مما حول المدن إلى سوق استهلاكية ضخمة تستورد المأكولات من كل مكان في العالم وهذا السبب الحقيقي في فشل تجربة العمل العبري. وفي عام 1930 أجري أول مسح عن استهلاك الطعام والعادات الغذائية من جوانب متعددة في المستوطنات الصهيونية في البلاد وأشرف على المسح إسرائيل ياعكوف كليغر مدير قسم علم البكتيريا في الجامعة العبرية، و سارة برومبريغ مديرة قسم التغذية في مستشفى هداسا وبيلوجي الأسكندر جيجر والاقتصادي ديفيد غورفيتز: وتوصلوا إلى أنه لا يوجد أكل يهودي محض ومن الصعب أن نأكل ما هو مذكور بالتراث اليهودي فقط، كما أن بعض مأكولات العرب يتقبلها المستوطنون الأوروبيون. وأن الكثير من المأكولات الأوروبية منتشرة بين المستوطنين لكنها من المحاصيل المحلية ومطابقة لمواصفات الكوشر الشرعي، أما قضية أن التلمود هو أصل كل الأكل الصحي وفقط يعني أننا نوقف ابداع أطباق جديدة وهذا مخالف للتطور الحضاري.
ذكرت إيرنا ماير في كتابها الشهير كيف تطبخ في فلسطين: استخدم العديد من وصفات الأكل غير الأوروبية وهي بالغالب مغربية وعراقية وسورية، كما أنها استخدمت الأسماء الفلسطينية للخضراوات ومكونات الطبخات مثل الكوسا والبرغل والنعنع والباذنجان، كما أوصت بمحاكاة الفلاحة الفلسطينية باستخدام زيت الزيتون وتقليل نسبة اللحوم والحبوب، وهي أول من قدم طريقة تحضير الحمص بالطحينة باللغة العبرية والألمانية، صدر كتابها عام 1936 على نفقة الهستدروت لمساعدة المهاجرات الجدد لتغيير نمط أكلهم الأوروبي، وفي كتابها دائماً تذكر اسم البلد فلسطين والناس الفلسطينيين، رغم أنها صهيونية متعصبة. ومن جانب آخر يعتبر كتاب كلوديا رودين (1968) من أهم كتب الطبخ التي تتحدث عن الأكلات الشرقية للمجتمع البريطاني فقدمت وصفات وطرق تحضير عملية لأغلب الأكلات الشرقية، وكتبت الكثير عن تميز المطبخ المصري وأن هناك أكلات كثيرة يعتبرها البريطانيون أكلات تركية أو إيرانية بينما هي في الحقيقة مصرية. إلا سيدة كلوديا لم تر أن هناك بلدا اسمه فلسطين وأن لها مطبخاً عريقاً، بل أنها لم تذكر أي أكلة على أنها فلسطينية حتى الكنافة فهي أصلها يوناني أو تركي واسمها الأصلي كاديف، وأيضاً أن الفلافل والطعمية أسماء لشيء نفسه وهو من الفول لا من الحمص، وهو من اختراع الأقباط المصريين في الأسكندرية، وظهوره كان بفترة معرفتهم بالملوخية. وقد أورد العديد من الطلاب السوريين والفلسطينيين في جامع الأزهر أن في رواق الشوام بالأزهر كان هناك مقصف يبيع المأكولات الشامية وخاصة الفتة والفلافل، وكان هناك عدد من المحال الصغيرة قليلة العدد تبيع الحمص والفلافل بالقاهرة في القرن التاسع عشر، وقد ذكر الشيخ عبد الحميد السائح: قبيل الحرب العالمية الأولى ذهبت للدراسة بالقاهرة في الجامع الأزهر، وهناك التقيت خالي الذي كان يملك مطعماً في مدينة المنوف.
وهنا لابد أن نذكر أن الباحثة كاثي كوفمان: لم تجد في الآثار الفرعونية أو التركية أو الأغريقية أو الفارسية أو في بلاد الرافدين مصدراً أقدم من الساحل الفلسطيني وخاصة غزة وعسقلان للبصل أو الملوخية بل أن البصل اشتهر أنه البصل العسقلاني ومدون بأكثر من خمسين مصدراً، وأما الملوخية بأنواعها الثلاثة (السلطة ، الجامدة وتأكل مع الخبز، والحساء مع اللحم والأرز) كلها من منطقة غزة. أما الحمص بنوعيه (الأخضر وجاف) فأقدم أحافيره تعود إلى أريحا، وفي التاريخ اليهودي يذكر العدس أكثر من أي حبوب أخرى كطعام للفقراء، إلا طائفة السامريين فهي الوحيدة التي تذكر الكتب إفطارهم الحمص مع البصل. وبالنسبة للطحينة فأقدم أثر لها وجد عند الآشوريين شمال العراق وكانت ضمن الزيوت المستخدمة في المعابد، ويذكر أنها مستوردة من فينقيا، وبهذا يكون مصدرها من المنطقة بين عكا وصيدا ولا يمكن أن تكون أصولها مصرية بالمطلق.
وفي التراث العربي ذكر ابن العديم في كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب بالقرن الثالث عشر ميلادي، ذكر تحضير الحمص بالطحينة وذكر العديد من الأكلات التي تدخل الطحينة بمكوناتها. وهناك مصادر أجنبية تؤكد أن الحمص بالطحينة كانت من وجبات الإفطار عند الصليبيين ومنها ما هو باللحم والصنوبر ويُسمى الحمص العكاوي عندهم وهناك الحمص المخلوط بالفول ويُؤكل بالمعلقة والمعروف عندهم بالحمص الصوري. تسمية الطحينة عربية مولدة وهي مذكورة بكتب الأقدمين باسم الراشي أو الرهش أو حلوب السيرج وهو مادة مضافة للأكل البارد أو المطبوخ مدون بكتاب التاريخ لهيرودوس الأغريقي في وصف المدن الكنعانية عام 2500 قبل الميلاد. ذكر ابن سيار الوراق العديد من طرق طبخ العجة بالخضراوات واللحوم، كما أورد طرق صناعة النقانق باللحوم وأيضاً بالخضراوات. بل أنه ذكر أن الفقراء بالعصر العباسي لم يكونوا قادرين على أكل الكنافة بسبب غلائها وذكر العديد من الشواهد على ذلك نذكر منها: ما رأتُ عيني الكُنافة إلا عند بَيّاعها على الدُّكانِ * ولعَمْري ما عاينت مقلتي قَطْراً سوَى دمعها من الحرمان * ولكم ليلة شبعت من الجوع عيوناً إذ جزتُ بالحلواني * حسراتٌ يسوقها القلب للطَرف فوَيلٌ للطرف عند العِيانِ.
لكنني كنت أبحث عن معلومات إضافية بخصوص أكل الشغيلة، وقد نصحني جاي غيلور باتصال مع سول، وقد رتبت لي اللقاء الرفيقة سيفان، وعقدنا حلقة دراسية أنا مع الرفيق سول سلابي والرفيقة سيفان بارك وهم جميعاً من اليهود الاشتراكيين المناصرين للثورة الفلسطينية، ويتميز سول بأنه مهتم جداً بكتب المأكولات في فلسطين، وبدأ زيارتي له بأن أخذني بجولة في مكتبته، واستغربت كثيراً عندما وجدت أن هناك أكثر من عشرين كتاباً باللغة العبرية عن الأكل الفلسطيني وأغلبها تأليف فلسطينيين من الناصرة وحيفا، أما مكتبته الانجليزية فهي مقاربة لما عندي، ثم سألته عن الأكل العبري؟ فأجاب: هي تقصد اليهودي أم الإسرائيلي؟ ثم تابع سأقدم لك ضيافتي كعكة بولندية وقهوة فرنسية هذا هو باختصار المطبخ الإسرائيلي. فلا يوجد أكل محدد للمجتمع المتعدد الثقافات، وها نحن في استراليا، فهل هناك أكل استرالي؟ بالتأكيد إذا استثنينا أكل السكان الأصليين فإن استراليا ليس لها أكل خاص بها، بل إن هذا تنوع بالمأكولات يجعلنا نعشق فكرة التعدد الثقافي وقبول الآخر، واحترام اختلاف الأذواق بين من يحب الأكل بالبهار والفلفل أو من يرغبه محلى بالعسل.
فسألت سول: ما هي قصة فلافل تل أبيب؟ فقال: المذكور بالكتب واضح أن اليهود اليمنيين هم من أدخل الفلافل لتل أبيب وقد تعلموا صناعته بمصر قبل مجيئهم لفلسطين؟ فقلت له: أنت تعلم أن المصريين يسمون الفلافل طعمية؟ كما أن هناك أكلة يمنية مشهورة اسمها الباجيه وهي إحدى أقارب الفلافل؟ فالباجيه تصنع من اللوبياء الرفيعة وتُسمى باليمني دكره والطعمية من الفول والفلافل من الحمص. فقال سول: فلافل اليمنيين في تل أبيب كان من الفول، ولم أسمع قط بكلمة باجيه. تدخلت سيفان وحاولت إيجاد الكلمة بالقواميس العبرية الخاصة بالمأكولات لكنها غير موجودة إلا باللغة الإنجليزية وليست ضمن قائمة أي مطعم في تل أبيب أو حيفا. وهنا عقب سول: أذكر أنني قرأت تقريراً من مستشفى هداسا أتوقع عام 1940 يصف فيه أن اليهود المغاربة عندهم مرض الفوليك أي أنهم يمرضون إذا أكلوا الفول، وبعدها صدرت توصية بعمل الفلافل من الحمص. فقلت له أن نسبة اليهود المغاربة ليست كبيرة مقارنة باليهود الاشكناز بتلك الفترة ولا أتوقع أن يفرضوا ذوقهم على الغالبية بتغيير أكثر أكلة شعبية في تلك الفترة. فقال سول: هذا ما نقرأه بالكتب وأعلم أن دراستك ستكون أكثر من مهمة بخصوص أكل الشغيلة. فسألته: هل تصرفات الشرطة البريطانية ضد المطاعم الشعبية كان صحيحاً؟ فقال سول: الفلافل وجبة ساخنة ومغذية ولا يمكن أن تكون مسببة لأمراض، إلا إذا تُرك الزيت يغلي لفترات طويلة فأكاسيده تسبب مرض السرطان، وهو لم يكن معروفاً بتلك الفترة، لذا فإن تصرفات الشرطة البريطانية كانت ضد الفقراء وهناك حوادث كثيرة تبين أن البريطانيين كانوا يتعاملون بوحشية ضد الفقراء من العرب واليهود.
سألت سول عن قطار الحليب فقال: أن هذا المشروع رغم أهميته التاريخية إلا أنه لم يكن المصدر الرئيسي للجبنة والحليب في تل أبيب فهو كان مقتصراً على حيفا، أما تل أبيب فكانت سوق لمنتوجات شركة ألبان سارونا الألمانية. ثم ذكرت له ما كتبه جوني عبود: لا يعتبر خط سكة الحديد للقطارات الواصلة مدينتي حيفا ودرعا موافقاً للتصاميم الهندسية الأصلية حيث ضغط الهستدروت لتحويل سكة القطار من المناطق العربية إلى المستوطنات الصهيونية، حيث أن للسكة 17 محطة منها فقط ثلاث للمناطق العربية (بيسان وسمخ وشطة)، كما أن هرتسفيلد أمين عام المركز الزراعي للمستوطنات كان يجعل القطار مكتباً متنقلا حيث كان يلزم القطار بضرورة انتظاره لحين تفقده أمور كل مستوطنة ثم يتابع عمله بكل محطة. وقد وافقت إدارة السكة على مشروع قطار الحليب لشركة همشبير التعاونية لمنتجات المستوطنات عام 1929. وقبلها كانت شركة تنوفا للإنتاج الزراعي ومنتجات الألبان قد حصلت على ترخيص جمع منتوجات المستوطنات وتسويقها في حيفا.
وما ذكر هيلمت غرينك ( طائفة الهيكليين المسيحيين الألمان قرية سارونا قضاء يافا): أكثر من 90% من العمال ( غير الحرفيين) في سارونا كانوا من العرب الفلسطينيين يعملون معنا في المزارع والمصانع وحتى في البيوت، أما أمهر العمال الحرفيين كانوا يعملون عند عائلة يعقوب بلانيش أصحاب شركة ألبان سارونا، كان هناك منتوجات أوروبية وأخرى عربية لكن تحضير وتعبئة اللبنة والجبنة المغلية كانت من اختصاص العاملات الفلسطينيات، ويعتبر هذا المعمل أول من أدخل اللبنة على تل أبيب في العشرينيات من القرن الماضي.
ثم تحدثنا عن قابلية الفلسطينيين على إدخال مأكولات جديدة خاصة أنهم أول العرب الذين أدخلوا البيتزا إلى أطباقهم الشعبية في نهاية القرن التاسع عشر، فقال سول: أوافق الرأي وهذا جعلهم لا يجوعون أبداً لأنهم يبحثون عن الرخيص مهما كان مصدره، فعندما كانت المعلبات غالية خاصة التونة والسردين كانوا يفضلون الرخيص الطازج، والآن انقلب الوضع فصاروا يفضلون المعلبات، ولكن الخطر الحقيقي هو الاعتماد على الخضراوات المثلجة لأن الكهرباء أول ما يفكر أن يقطعه الجيش الإسرائيلي. ثم قالت سيفان: الخضراوات المجففة أصبحت موضة قديمة وغير مقنعة للعديد من الفقراء رغم أنها حل مثالي في ظل ظروف الحصار والصعوبات الاقتصادية الحالية.
وفي موضوع أهمية التغيير الكبير بالمأكولات الفلسطينية بسبب إدخال البندورة لطعام الفقراء عام 1807 والبطاطا عام 1864، وإنها أدخلت تغييراً شاملاً بالمطبخ الفلسطيني، قال سول: البندورة قلبت العالم وهي أصبحت البديل الأرخص من اللبن أو مرقة اللحم في العديد من المأكولات في أوروبا وآسيا، أما البطاطا فهي رمز الفقراء في أوروبا بل هي أحياناً بديل للخبز نفسه خاصة في إيرلندا وروسيا، ثم قلت له ما أورد خالد محمد صافي: أثناء الحكم المصري (1831-1840) تم إجراء تجارب لزيادة انتاجية البطاطا في فلسطين من أجل زيادة انتشارها في فلسطين. ثم قلت له أن البطاطا كانت ضمن مخطط حكومي لمحمد علي باشا في فلسطين لكن البندورة فقد تدرجت بشكل أكثر سلاسة من بيوت الباشوات إلى الفلاحين الفقراء، ولا أتصور أن المطبخ الفلسطيني يستطيع الاستغناء عن البندورة والبطاطا، فختم سول النقاش قائلا: يستطيع أن يستغني عن الحمص نفسه عليك أن تبحث عن شيء وحيد لا يمكن أن يستغني عنه المطبخ الفلسطيني بعد الخبز.
من جانب آخر تذكر لوزية بزاز: إن الثقافة الاستهلاكية في فلسطين لها جذور قبل عام 1860 حيث أن هناك مستوردات كمالية مثل العطور والألبسة والحلويات ومواد التجميل مسجلة ضمن المستوردات الفلسطينية من فرنسا وإيطاليا، كما أن منتجات شركة نسيلة سويسرية من كان لها شهرة واسعة فهي كانت موجودة حتى في الأرياف قبل الحرب العالمية الأولى، رغم أن فلسطين كانت مصدرة للأجبان في تلك الفترة. وكانت الشوكولاتة السويسرية والبلجيكية رائجة في تلك الفترة، لكن بعد الحرب تغيرت الكثير من المنتوجات نظرا لأن حكومة الانتداب البريطاني أصدرت قرارا بإلغاء كافة الامتيازات للتجار الأوروبيين ووضع ضرائب على كل المستوردات غير البريطانية مما نقل السوق الفلسطينية لنمط استهلاكي بريطاني مختلف يسعى لتغيير جذري في العقلية الفلسطينية، ولعل أكثرها جاء من زاوية ملتوية، فإعلانات شركة صابون بالموليف الإنجليزية كانت تركز على البشرة الناعمة للفتاة الشقراء وجاذبيتها، رغم أن الصابون النابلسي معروف بجودته وعراقته فهو من مستوردات بريطانيا منذ القرن الرابع عشر ميلادي، بل إن الملكة اليزابيث الأولى أمرت أن يكون الصابون الوحيد المستعمل في قصور العائلة المالكة.
وعن ازدواجية المعايير لحكومة الانتداب كتب ميكائيل برينهاك: لم يكن هناك قانون خاص لتنظيم التجارة والأسواق، بل أن حكومة الانتداب طبقت القانون البريطاني بحذافيره، فقسمت البلاد إلى مدن رئيسية وبلدات وأرياف، ووضعت مواصفات أوروبية لترخيص أي متجر وهذا يعني أنه يخص الطبقة الغنية فقط، بالنظر للبسطات والباعة المتجولين فكان الوضع خطيراً حيث أن عملهم غير مرخص قانوناً إلا إذا رغب أهالي الشارع بوجودهم ثم يكون لزاماً عليهم دفع ضريبة استخدام الرصيف، هذه السياسة كانت مناسبة جداً للحركة الصهيونية التي تريد بقاء الفقراء محصورين داخل الكيبوستات (القرى التعاونية للعمل العبري)، وعلى عمال المدن تناول طعامهم بمؤسسات الهستدروت التي لها قانون استثنائي. وأضاف ديفيد اسشور: قانون البيئة والحماية من التلوث في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، كان يخص الباعة المتجولين الفقراء ويعاقبهم بالتعزير والضرب أمام المارة، أمام مخاطر التلوث الصناعي وانبعاث الأغبرة والكيماويات من المصانع فلا يعاقب عليها القانون، بل إن عرائض الضواحي الجنوبية لتل أبيب للبلدية والجهات الحكومية كان يتم تجاهلها، وكذلك الأمر مع الكيوبستات الشمالية القريبة من مصنع الأسمنت في حيفا، رغم أن الجهات الطبية سجلت العديد من الأمراض البيئية لكن الفقراء صوتهم أخرس عند البريطانيين.
وفي الجانب العربي ذكر إسبير ميّر : أن سوق اللد الأسبوعي المعروف كسوق شعبي لبيع المنتوجات القروية من محاصيل وخضراوات وأيضاً أجبان وألبان ومخللات ومربيات ومشغولات مطرزة، تم منع هذا السوق في بداية الانتداب البريطاني لأنه مخالف لشروط الصحة العامة، وقامت البلدية بتخصيص جزء من بيادر المدينة لعمل سوق له سور وبداخله بسطات وكذلك مكتب للصحة العامة وتم إضافة تعريفة على من يريد عرض بضائعه خصوصاً المواشي والدواجن. كما تذكر مي صقيلي: أن حكومة الانتداب وافقت عام 1930 على توسيع حدود مدينة حيفا لتشمل التجمعات المجاورة مثل إسكان العمال الخاص بالهستدروت ومشروع شركة نفط العراق، كما تم منع الباعة المتجولين في الشوارع الرئيسية في الشوارع الكبيرة مثل شارع الملوك وساحة بلومر ومنطقة حدائق البهائيين. كما تمّ التغاضي عن مساكن العمال بمنطقة الرمل والأحياء الفقيرة في شرق المدينة التي كانت تحوي على أسواق شعبية مثل سوق السورية التي لا تلتزم بمعايير الصحة العامة.
أما بالنسبة للعمال الفلسطينيين فبدأ نضالهم ضد الصهاينة قبل الحرب العالمية الأولى فقد كتب أبوعلي الياسين : ومن الناحية الاقتصادية كان هناك عمال عرب يعملون في مزارع اليهود و لكن الوضع اختلف مع قدوم الموجة الثانية من الهجرة اليهودية 1904 التي كان معظم أفرادها من روسيا يحملون معهم أفكارا مختلفة تحمل في طياتها العنصرية والحقد على العرب، فقد رفع هؤلاء شعار" احتلال العمل " أو "تهويد العمل" ويقوم هذا الشعار على فكرة تنقية صفوف اليهود من العمال غير اليهود. وشرح قضية العنصرية ضد العمال واصف العبوشي فكتب : أما التطبيق العملي لهذه الأفكار العنصرية فكان طرد العمال العرب من المزارع والأراضي التي أصبحت بحوزة المستوطنين، كما شمل الطرد أيضا الحراس العرب الذين كانوا يعملون في حراسة المزارع اليهودية وكذلك عمال المصانع العرب، ومن ثم شملت هذه الحملة مقاطعة البضائع العربية، فمنذ البداية تم طرد الفلاحين الفلسطينيين من الأراضي التي استولى عليها اليهود حتى لو كانوا يعملون فيها حسب نظام الضمان أو التأجير وذلك بتشجيع من الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهود، بحيث كان العقد الذي يتم توقيعه بين الوكالة اليهودية والمالك الجديد للأرض يشمل شرطا ينص على التزام الأخير بعدم تشغيل عمال عرب في أرضه، بل تشغيل عمال يهود فقط سواء بالعمل اليومي أو التأجير، وكل من يخالف هذا الشرط كان يتم تغريمه بدفع 10جنيهات فلسطينية وإن خالف الشرط للمرة لثالثة يحق للصندوق القومي اليهودي استرجاع الأرض من المشتري ومنحها لآخر.
واستنتج المحلل الاقتصادي سعيد حميدة: فشل الفلسطينيون بخلق اتحاد عمال قادر على إنشاء مؤسسات إنتاجية بسبب الصراع العائلي بين طبقة النخبة، بينما نجح الهستدروت بتحييد الممولين لمشاريعهم، فقيادة الهستدروت هي من ترسم الخطط وتنفذ القرارات، بل إن الفلسطينيين لم يشكلوا أي شركات تساهمية عصرية، فجميع مؤسساتهم لها الطابع العائلي وأحياناً الفردي، وهذا النوع من الشركات لا يستطيع الصمود أثناء الأزمات السياسية، كما حدث في بداية إضراب عام 1936، حيث غادر فلسطين طوعاً أكثر من ثلث الشركات العائلية لتبحث عن أسواق أكثر استقراراً في القاهرة وعمان وبيروت، ثم دمشق وبغداد. وهذا ما يوضح ما قصده مصطفى العباسي: إن الهدف الأساسي من تأسيس جمعية العمال العرب في صفد عام 1934 جمع المعونات لأسر العمال بعد استفحال البطالة بين الطبقة العاملة وأن أغلب المنتمين للجمعية كانوا من العاطلين من العمل، علماً بأن جمعية العمال العربية الفلسطينية في حيفا (تأسست عام 1925) لا تقدم معونات للعاطلين من العمل، إلا أن الهستدروت يملك صندوق معونات للعاطلين عن العمل. كما أن الياسين ذكر: كانت دائما أجور العمال العرب أدنى من أجور العمال اليهود بنسبة 30 %، و في عام 1937 بلغت نسبة العمالة العبرية في المستوطنات اليهودية 73 % لذلك أدت هذه السياسة إلى رفع نسبة البطالة الفلسطينية، و يبدو أن عقوبات كانت تلحق بكل من يخالف تعليمات الصندوق القومي اليهودي وهذه العقوبات كانت تقضي بدفع المخالف غرامة مالية قيمتها 10 جنيهات فلسطينية.
وبعد إبعاد جورج منصور سكرتير جمعية العمال العرب في يافا عام 1937 بسبب نشاطه التحريضي ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية، قام بنشاطات عديدة في المدن البريطانية لشرح لماذا يرفض العمال العرب الكتاب الأبيض وتقارير اللجان الدولية، فذكر أن حكومة الانتداب لا تعترف بنقاباتنا وترفض التعامل معنا وتعتبر الهستدروت الناطق الرسمي باسم العمال، رغم أنه لا يوجد فلسطيني واحد ضمن أي لجنة قيادية بالهستدروت بل إن اليهود العرب يعانون كما نعاني من سوء المعاملة، وقد رفعنا عرائض عديدة للمؤسسات الحكومية لتقليل ساعات العمل والتي معدلها عشر ساعات يومياً، كما طالبنا بتوحيد معاش العمال، حيث أنهم يدفعون للعامل الصهيوني ضعف ما يدفعون لنا. نحن بلد صغير وموارده محدودة، ولم نصل لمرحلة الصناعة بعد، وعدد العاملين في شركات القطاع الخاص قليل جداً، ولا يوجد في فلسطين شركة فلسطينية بها أكثر من عشرين عاملاً، وأغلب المناقصات والعطاءات الحكومية تشترط على العامل إجادة لغة أوروبية واحدة، وهذا صعب جداً في الطبقة العاملة في فلسطين حيث تنتشر الأمية، والحكومة تعلم ذلك لكنها تقصد أن الوظائف للمهاجرين الصهيونيين وليست لنا. هناك ثلاث شركات يهودية عملاقة تسيطر على كافة الامتيازات (شركة الكهرباء الفلسطينية وشركة البوتاس الصهيونية وشركة الملح الفلسطينية) الحكومية وهي ما نسميه القطاع الخاص.
ويروي القائد الرمز الأخ سليم الزعنون: أخذني والدي في جولة إلى مدن فلسطين، كان ذلك عام 1945، ولاحظت أنه يجتمع مع زملائه وكلاء شركة سنجر العرب ليقول لهم: علينا ألاَّ نخضع لمحاولات إدارة الشركة اليهودية في ضمنّا إلى الهستدروت، فنحن عرب ويجب أن يكون لنا نقابة عربية. اصطدم وزملاؤه مع الادارة في تل أبيب، الأمر الذي دفع والدي إلى الاستقالة من شركة سنجر، وأنشأوا شركة ماكينات الخياطة العربية، وأرسلوا زميلاً لهم وهو سمعان عكره من القدس إلى إيطاليا، واستوردوا ماكينات خياطة من ماركة نيتشي، وكتبوا عليها بالعربية شركة ماكينات الخياطة العربية واستطاعوا أن يكسروا شوكة سنجر رغم عراقتها وجبروتها.
حسين اللوباني يتذكر الأكل الفلاحي بقصيدة ساق الله: (سقى الله يا إمي عا رغيف كماج والخبز السخن طالع من الطابون* ع قره وقرصعنه ما عليها سياج عا صحن دقة وورق زعتر من الطربون * ع فقوسة بأرض السهل يا فراج شمام بطيخ من مزارات يا دامون * أفغش وشقح واثق بلا إحراج أحمر عسل آكل ثمي ولعيون). وهي بالتأكيد لها دلالات عميقة في ذكر الموروث الحي من التراث الفلسطيني، فهذه المأكولات معروفة عند الفلسطينيين بالوطن والشتات. إلا أن أفكار قصيدة ساق الله عامة، ولا تجيب على سؤال سول سلابي ما هو الشيء الذي لا يستطيع أن يستغني عنه العامل الفلسطيني بعد الخبز، أي وجود الخبز ضروري لكنه لا يكفي. وقد استعنت بمجموعة من الأصدقاء للإجابة على هذا السؤال منهم الدكتور زياد أبوالعنين في صيدا والمهندس إياد أبو سالم في خان يونس والصيدلانية سوسن سليمان في نابلس والأستاذ كفاح قديح في غزة والآنسة ياسيل أبو الهوى في رام الله والأستاذ ميخائيل توما في حيفا والأستاذ عماد الحلو في عمان. كانت إجابتهم متطابقة نوعاً ما فهي تحدد أن الإفطار عادة خال من اللحوم لكنه يحوي خبزاً وزيتاً مع شيء آخر مثل الزعتر أو اللبنة أو الجبنة أو البيض المسلوق، كما وجبة الغذاء تحوي على خبز وزيت مع حمص أو فلافل أو بيض أو بطاطا أو تونا أو طبيخ لحم أما العشاء فهو الوجبة الرئيسية حيث يعود العامل إلى بيته ويكون أكله بالعادة طبيخ يحوي على يخنة أو عدس أو خضراوات ويكون مصحوباً باللحم الأبيض أو الأحمر أو مجرد مرقة لحم مع خبز وزيت.
إذن لابد من وجود زيت الزيتون والخبز حتى يشعر العامل الفلسطيني بالشبع، فدسم زيت الزيتون أساسي للشعور في الشبع عند الفلسطيني، ومجرد إعادة القراءة لكل الحروب والنكسات التي مرّ فيها النضال الفلسطيني إلا أن أكل الفقراء في فلسطين وتحديداً الطبقة العاملة في المدن والقرى هي الخبز وزيت الزيتون. وفي نظرة لتاريخنا العتيق في زمن العرب الكنعانيين فهمنا أن حماية أكل الفقراء هي مسؤولية من يحكم البلاد والعباد، متجسدة بالإله بعل، الذي تحدى إله الموت الذي يرمز للحرب والفقر والموت، تحدي المتكبر يريد أن يفرض شروطه على الموت، لكن إله الموت بدأ في قتل الحياة في أرض كنعان فقتل الحيوانات والأشجار، وكان الإله بعل متعجرفاً مقتنعاً أنه سينتصر، إلا أن الإله موت قتل شجر زيتون وسنابل قمح، فركع الإله بعل معلناً هزيمته، وطلب من أتباعه أن تهاب الإله موت وتصلي له حتى تعود الحنطة لسنابلها ويقطر الزيت من الزيتون. رسم الأسطورة موجود بمدينة أوغاريت السورية وهذا نصها: ( عل: أنا وحدي من سيحكم فوق جميع الآلهة * أنا وحدي من سيأمر الناس والآلهة * ويسيطر على كل من في الأرض. موت: ليدخل بعل إلى أعماقه هابطاً عبر فمه * فتجف أشجار الزيتون ومنتجات الأرض وثمار الشجر. بعل: اذهبا وقولا للإله موت * تحية لك أيها الإله موت * عبدك أنا سأكون * عبد لك للأبد).





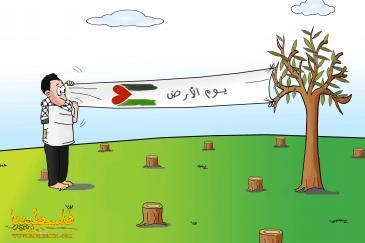





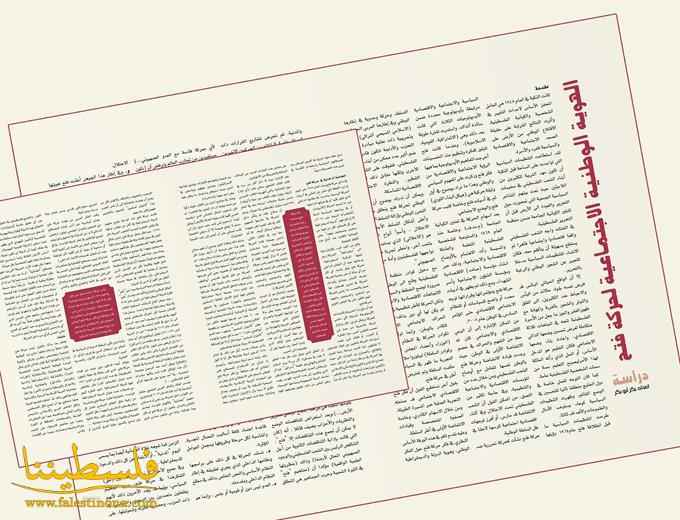







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها