على غير العادة، دوّن الصديق حيدر عوض الله صفحة من سجل حياته في رواية بعنوان "السفرجلة"، التي صدرت الطبعة الأولى منها عام 2016، عن دار الأهالي الأردنية، توقف فيها الروائي عند اربع محطات اساسية من تجربته الشخصية، مرحلة الطفولة وطلاق والدته من والده في مخيم النصيرات في قطاع غزة، ثم مرحلة الفتوة، التي قضاها في مخيم اليرموك ولبنان، ثم مرحلة الدراسة الجامعية في بلغاريا، واخيرا المحطة التونسية، التي واكب فيها جزءا من مسيرة الثورة، دون ان يغوص في تفاصيلها، بقدر اقترابها او بعدها من تجربته الخاصة، وموقعه في العمل داخل إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
بدأ عوض الله روايته بمقولة عاكسة اختياره عنوان الرواية، التي جاء فيها "الحياة أشد فجورا من خيالاتها.. السفرجلة حياة، كل قضمة منها بغصة"، مع اني كنت اعتقد، ان الرواية حملت في ثناياها مجموعة عناوين بارزة تعكس تجربته، مثلا اللقب، الذي كانوا يلقبونه به، وهو "أبو حشكو"، اي الفضولي، الذي يدس أنفه في كل شيء، أو "الجوع"، لا سيما وان تجربة المخيمات والجوع، بالإضافة للجوع الجنسي، التي لازمته في تجربته، كان يمكن ان تجمع اكثر من عنوان من حياته تحت يافطة العنوان. مع ذلك فإن اختيار عنوان "السفرجلة" لروايته، وما لازمها من ربط بين كل مرحلة، أو "قضمة"، كما ورد في مقولته، توجد غصة، وألم ومعاناة، فيه منطق، ويستجيب لدراسته الجامعية "الفلسفة"، ونبوغه فيها، حيث شاء إدخال البعد الفلسفي في العنوان.
تجربة وجيه الطفولية في مخيم النصيرات، وفق ما أعتقد، انها تحاكي تجربة ابناء المخيمات الفلسطينية عموما في داخل الوطن والشتات، مع استثناء في الخصوصية الخاصة لكل إنسان. ولكن لا تختلف شقاوة وجيه الطفولية مع المدرسة وكرهها، والهرب منها، وذبح الحرادين واستخدام دمها لغسل اليدين بها، لمنحها قوة تحمل عصي الأساتذة، والبيارة، وسرقة البرتقال، والتنقل بين حب وآخر لبنات الجيران، ولعبة العريس والعروس، ونزعاته الطفولية البريئة، وحتى الطلاق بين والديه، لم تكن استثنائية. ولكنها حملت نكهة حيدر عوض الله، وعلاقاته مع جده لأمه وبخله، والضغط على والدته للطلاق من ابيه، لأنه تزوج بأخرى وسافر بعد حرب حزيران 1976، والعلاقة مع اخواله، الذين تباينت العلاقة معهم ارتباطا بعلاقتهم معه، والأهم علاقته مع شقيقتيه "نجاة" و"منى"، اللتين عانتا ما عانتاه، وإن كانت اخته الصغرى "نجاة" محل رعاية جدتها لامها، ثم علاقته مع ابو عنتر، زوج خالته، الذي كان بمثابة "البوليس الحربي" ليد جده، الذي كان يطارده احيانا لمجرد رؤيته. وهو ما يعكس الضيق الشديد، الذي عاناه، ووقع تحت سيفه.
جميع اللوحات، التي ساقها نجيب (حيدر)، هي لوحات حقيقية، ومع ذلك حملت صورة الواقع على بشاعته، ومرارته، حيث سلط الضوء على معاناة سكان المخيمات، وبيوت الزينكو، والطعمة (مطعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين)، وزيت السمك والحليب في المدرسة، والشوارع الآسنة، والمناعة، التي يكتسبها ابن المخيم بحكم معايشته لكل انواع الثلوث البيئي. وهنا الصورة ذاتها في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، التي ربط فيها نجيب المخيم بالثورة بشكل طبيعي دون افتعال، من خلال ربطه بين وجود والده في معترك الكفاح السياسي، وتحمله مسؤولية النضال في الحزب الشيوعي الفلسطيني بمراحل تطوره المختلفة. أضف إلى ما قام به الفتى اليافع نجيب عندما التحق في البداية بجبهة النضال، ثم شارك في الدفاع عن الثورة اثناء الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 في صفوف الجبهة الديمقراطية، وما قام به من فعل بطولي بتدمير ثلاث دبابات في صوفر، ثم عودته لاحضان الحزب حيث التربة والبيئة الخصبة له من خلال انتماء والده وخالته (زوجة ابيه) والإطار الصديق لعائلته.
وحتى عندما أوفد للدراسة في اكاديمية العلوم الاجتماعية في صوفيا عاصمة بلغاريا، كان هناك مبعوثا من الحزب، وخاض غمار النقاش والحوار السياسي مع الأعضاء والأشقاء من فصائل العمل الوطني والقومي والأممي دفاعا عن قضيته الوطنية، التي لازمها موضوع الدراسة للفلسفة، وكذلك لم يغب عن حيدر ملاحقته للنساء في كل زاوية، إلى ان توقف عند حبيبته، التي اختارها زوجة له. واعاد ترتيب اموره الاجتماعية والسياسية والحزبية. وبقدر ما امتع القارئ، بقدر ما آلمه، وهو يتلو علينا تعقيدات الفوز بخطيبته وزوجته نتاج الواقع والموروث الاجتماعي. وكيف انتصر على العقبات والعراقيل الاجتماعية، وفرض نفسه على أنسبائه بشكل درامي، فيه الكثير من الشجاعة والفروسية، لأنه اراد الاحتفاظ بأم جنينه، التي تزوجها بشكل مدني في بلغاريا بداية الأمر، ودون علم الأهل، باستثناء شقيقها، الذي كان يدرس في بلغاريا، وعندما حانت لحظة الحقيقة، كان عليه إشهار زواجه من زوجته بين الأهل والأقارب، إلى أن تمكن بعد كفاح من عقد قرانه عليها بشكل دراماتيكي بالتواطؤ مع اخوها ايضا، صديقه ونصيره.
جال نجيب طويلا في صراعاته داخل الأسرة، ومع زملاء العمل والدراسة والحزب، كان شفافا جدا، حتى اني اعتقد انه بالغ نسبيا في سرد تجربته الشخصية، التي حملت معاناة الفلسطيني الخاص والعام، ونقلت صورة الكفاح، ومحطات النضال المختلفة، فربط بين السياسي والاجتماعي والتربوي والثقافي مع البعد الاقتصادي والمالي، ومركبات التعقيد، التي يعيشها الفلسطيني عموما، وابن محافظات غزة خصوصا، فمن خلال ما تم مع زوجته حاملة جنسية البلد، التي ولدت وترعرت فيه، ومعها مولودها الطفل، الذي لم يتجاوز عمره الشهور المنسوب لوالد من غزة، ارغمتها الجهات الأمنية في المطار على البقاء ثلاثة ايام دون السماح لها بالدخول لأهلها، وخيروها بين الدخول وحدها، وبين العودة من حيث اتت، فاضطرت للعودة إلى تونس مع مولودها.
رواية السفرجلة، رغم خصوصيتها، غير انها كانت لوحة إضافية من مشاهد البؤس والألم والمعاناة الفلسطينية العامة، والبحث عن الأمل. وكما ذكرت في البداية، كلما قضم من السفرجلة قضمة، كان يواجه غصة جديدة أكثر إيلاما وتعقيدا. وكانت الرواية مشوقة ومتعة في استقطاب القارئ لمواصلة الركض مع حفريات الروائي في تجربته الاجتماعية والسياسية والحزبية، حتى توقف شهريار الملك حيدر عند وصوله جسر الملك حسين (اللنبي) في طريق العودة للوطن عام 1994، عن الكلام المباح تاركا تجربته الجديدة لغيث روائي جديد.
لاحظت غياب بعض النقاط الفنية في النص الروائي، حيث كان حيدر ينتقل من نقطة إلى أخرى احيانا داخل حدود كل مرحلة دون فصل نسبي، كأن يضعها تحت ارقام، او يعطيها عناوين ثانوية. كما اني كنت افترض ان يترك كتابة ذكرياته لمرحلة اوسع، واعمق. لكني شعرت ان حيدر كأنه يخشى الا يتمكن من كتابتها لاحقا، فاسرع ببثنا لواعجه وهمومه، همومنا، وترك لنا الحكم على مرحلة محددة من حياته
انفلاق السفرجلة
16-02-2019
مشاهدة: 304
عمر حلمي الغول









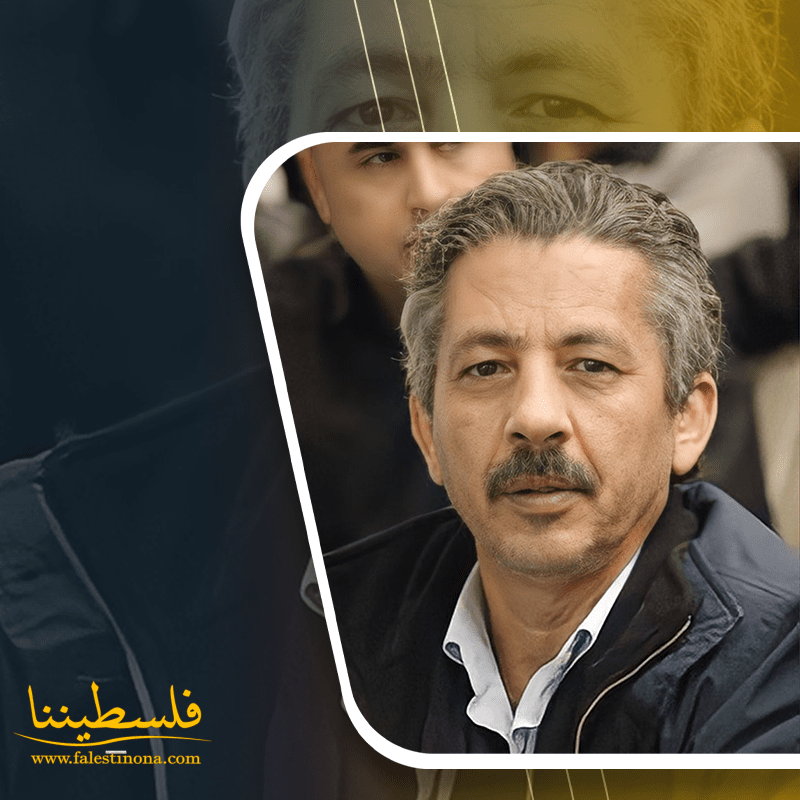



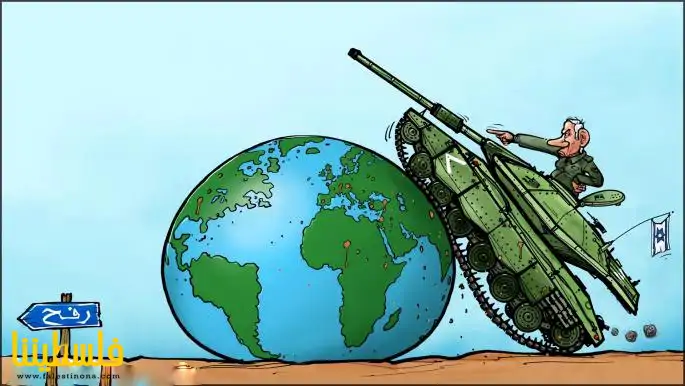



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها