تموز هو شهر الثورات والحوادث الكبرى في التاريخ العالمي، وأهم الانعطافات الجذرية في مسيرة البشرية وقعت في هذا الشهر بالتحديد. فالاستقلال الأميركي أُعلن في 4/7/1776، والثورة الفرنسية التي غيّرت العالم كله اندلعت في 14/7/1789، وتمكن "الضباط الأحرار" في تركيا من إرغام السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة الدستور في الدولة العثمانية في 23/7/1908. وفي بلادنا العربية نجحت الثورة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر في إنهاء الملكية والاستيلاء على السلطة في 23 تموز 1952، وفي 14 تموز 1958 انتهى العهد الملكي في العراق بمجزرة قصر الرحاب المروِّعة. وقبل ذلك وقعت معكرة ميسلون الخالدة في 24/7/1920، وأُعدم أنطون سعادة في 8/7/1949، وأَمَّم جمال عبد الناصر قناة السويس في 26/7/1956، ثم أعلن إيزنهاور مشروعه لملء الفراغ في الشرق الأوسط في 5/7/1957، وفي ما بعد قبلت إيران وقف الحرب مع العراق بلا شروط في 12/7/1988.
أما في فلسطين فالوقائع التموزية كثيرة جداً، ففي 14/7/1918 وضع حاييم وايزمن حجر الأساس للجامعة العبرية في القدس، وفي 7/7/1937 أوصت اللجنة الملكية البريطانية بتقسيم فلسطين، وفي 1/7/1948 غادر آخر جندي بريطاني ميناء حيفا وتُركت فلسطين للعصابات الصهيونية والهاغاناه. وفي 13/7/1948 استشهد الشاعر عبد الرحيم محمود في معركة الشجرة، وفي 20/7/1951 اغتال الفلسطيني مصطفى عشو الملك عبد الله في القدس. وسجَّل التاريخ المعاصر للقضية الفلسطينية أن أول عملية خطف طائرة إسرائيلية نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 15/7/1968. وصدرت مجلة "الهدف" التي تولى غسان كنفاني رئاسة تحريرها في 26/7/1969، واستشهد أبو علي إياد في أحراج عجلون في 4/7/1971، واغتيل غسان كنفاني في 8/7/1972، وتوفي زعيم فلسطين طوال حقبة ما قبل النكبة، أي الحاج أمين الحسيني، في بيروت في 4/7/1974.
القيامة بعد الانتظار
في 12/7/1994، وبعد كفاح مسلح استمر نحو ثلاثين سنة عاد ياسر عرفات نهائياً إلى وطنه، ليبدأ رحلة كفاح جديدة في سبيل الحرية والاستقلال. وعلى هذا الدرب استشهد أبو عمار وزُرع في تراب وطنه كبذرة حنطة.
وستتحول هذه البذرة بالتأكيد حصاداً وفيراً. فتموز، في الميثولوجيا القديمة، رمز للقيامة أو الانبعاث بعد الكمون والانتظار.
ولعل قضية فلسطين اليوم أُرغمت على الدخول إلى محطة الانتظار، فالجميع ينتظر ما ستسفر عنه الحرائق العربية المندلعة في كل مكان، والتي من المحال أن يتوقع المراقب إلى أين تسير الأمور بعدما دبت الفوضى وعمَّ الموت جميع أرجاء الأمة العربية. فمصر، على سبيل المثال، ولجت إلى مرحلة مريرة من الاضطراب السياسي والأمني، وها هي سورية تلتهب بنيرانها التي لن تتوقف، على ما يبدو، قبل أن يتحول تاريخها العظيم إلى رماد. وفي العراق موت جهنمي ربما يُبدد كل نماء ومدنية في بلد شهد ظهور أقدم مدنية وأقدم حضارة وأقدم حرف وأقدم ملحمة في التاريخ الإنساني. أما اليمن، فنداء الحرب والقتال يجد مَن يلبيه فوراً. وفي ليبيا يجري تحطيم هذه البلاد حتى لا تقوم لها قائمة في أي يوم من الأيام. وها هو الصراع على النفط وعلى ممراته وفوائضه يبيد شعوب هذه المنطقة بأيدي شعوبها. وها هو الإرهاب الدموي الأسود يسربل كل شيء في بلادنا، ويغمر بالخوف والموت كل حي ما عدا إسرائيل.
لم يستطع الشعب الفلسطيني تحقيق الاستقلال الوطني إبان الحرب الباردة على الرغم من التضحيات الجبارة، لكنه حقّق ثورة كبرى نقلت الفلسطينيين من لاجئين إلى شعب يتطلع إلى الحرية ويموت في سبيلها.
وهذه الثورة تمكنت من إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال العالم. وعندما تنتزع أي قضية مكانة لها على جدول أعمال العالم، فسوف تحتل في يوم من الأيام مكانها على جغرافية هذا العالم. غير أن لهذا الأمر شروطاً ليست يسيرة، ولعلنا لا نجازف في الاستنتاج إذا قلنا إن شروط الانتصار غير متوافرة اليوم في معمعان هذه الأهوال العربية التي لا تنتهي، ومن الصعب تحقيق إنجاز جذري للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة العصيبة. وربما كان الانتظار الايجابي أحد خيارات السياسات الفلسطينية في هذه الحقبة المضطربة. والانتظار الايجابي يختلف تماماً عن الانتظار السلبي، فالانتظار السلبي كمن يقف في محطة القطار ملوحاً بالمناديل، بينما الانتظار الايجابي كمن يجهز الحقائب كي يصعد إلى القطار. فهل نكون من حَمَلة المناديل أم من حملة الحقائب؟
الانتظار الإيجابي يجب، بالضرورة، أن يرافقه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم، والنضال بجميع الوسائل المتاحة للإبقاء على جذوة التحرر الوطني متقدة، والإصرار على ربط اللاجئين بوطنهم الأصلي، واستعمال جميع الأوراق السياسية المتاحة في سبيل هذه الغايات كالمقاطعة ومحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ومنابرها الكثيرة، وقبل ذلك كله وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده المختلفة.
نزع الشرعية
لعل كوة الضوء المحفِّزة في غياهب هذا الظلام العميم هو تطور المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية ضد إسرائيل بصورة منعشة. فالمقاطعة الأكاديمية، على سبيل المثال، بدأت آثارها تظهر بقوة. فالمجلات العلمية في أوروبا، وبقدر أقل في الولايات المتحدة الأميركية، صارت ترفض نشر بحوث مُحكَمة للباحثين الإسرائيليين.
وعدد من المحاضرين الأوروبيين يرفض المجيء إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمرات العلمية، ولا يُدعى كثير من الأكاديميين الإسرائيليين إلى المؤتمرات العلمية الدولية. ولا ريب في أن المقاطعة العالمية للبضائع التي تنتجها المستعمرات الإسرائيلية ومعها المقاطعة الأكاديمية لا تكفي وحدها لإرغام إسرائيل على الخضوع للنضال الفلسطيني، بل إن الأكثر أهمية في هذا الميدان هو أن تتطور المقاطعة إلى مقاطعة إسرائيل نفسها كدولة احتلال ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وتعيق، بالقوة القهرية، حل الدولتين. ولا شك أيضاً في أن الخطر الأكبر على إسرائيل لا يكمن في المقاطعة الاقتصادية والعلمية فحسب، بل في افتضاح المزاعم الإسرائيلية في شأن ديمقراطيتها وأخلاقيتها، الأمر الذي يعرّي ادعاءاتها التي عاشت طويلاً خلافاً للحقائق، والتي استطاعت من خلالها أن تحوز التعاطف الدولي ولو إلى حين. فالمقصود، في نهاية المطاف هو نزع الشرعية عن دولة إسرائيل في النطاق العالمي وفي شتى الحقول والمجالات.
في سياق موازٍ كان من المفرح أن تتقدم الحكومة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في 25/6/2015 بثلاثة ملفات عن الجرائم الإسرائيلية (الاستيطان والأسرى وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة في حزيران 2014). واستندت الحكومة الفلسطينية في دعواها على تقرير المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في شأن العدوان على غزة الصادر في 22/6/2015. صحيح أن تقرير المجلس العالمي لحقوق الإنسان يقيم نوعاً من التعادل بين إسرائيل وحماس في بعض فقراته، إلا أن التعادل، من وجهة نظر إسرائيل، يعني خسارة صافية لأنه يميط اللثام عن جرائم إسرائيل، ويُسخِّف خداعها في ادعاء التفوق الحضاري والأخلاقي. وفي أي حال، ومهما يكن قرار محكمة الجنايات الدولية، وحتى لو لم تتوصل هذه المحكمة إلى قرار حاسم، فإن الصدى السياسي والإعلامي والدبلوماسي، ستتساقط ثماره حتماً لمصلحة فلسطين وقضيتها وشعبها، وفي الإطار نفسه جاء توقيع الاتفاق التاريخي مع الفاتيكان في 26/6/2015 ليرسخ اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين في حدود العام 1967، ويكرس مسؤولية الدولة الفلسطينية عن المؤسسات الكاثوليكية الموجودة في نطاق هذه الحدود.
إن رحلة القطاف قد بدأت بعد مسيرة طويلة من العذاب والاستشهاد والنفي، والكفاح السياسي والعسكري، والنضال المتعدد الوجوه. وأكثر ما نخشاه ألا يتمكن الفلسطينيون من التقاط الثمار التي أينعت ونضجت في خضم الانقسام الوطني الذي لا ينتهي.












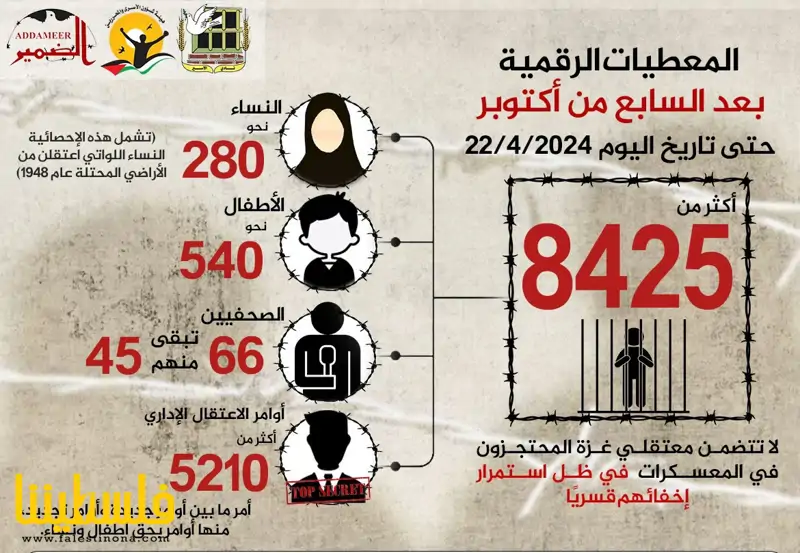


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها