التطرف هو الجرثومة الأكثر عنادًا وخطورة على سلامة البنى الإنسانية في المجتمعات. وهو إذ يسدِّد على مكامن المناعة الوطنية والإجتماعية لأي بلد كان فمن معيار شمولي لا يعير وزنًا للعلاقات الإنسانية المتأصلة بين فئات التنوّع الثقافي التي تشكل الخارطة الكيانية- التاريخية لمجمل حاملي هويَّة البلد المستهدف. وهو أيضًا عدو أصيل لفكرة الهويَّة الوطنية، نظرًا لشمولية مشروعه وعدم تورّعه عن استعمال فأس القطيعة مع التاريخ والإنسانية وما يعني ذلك من أبعاد وصلات وتراكمات أصيلة وعصيَّة على الهزيمة.
المسألة لا تتعلق أبدًا بتحريم صناعة ونحت الأصنام بقدر ما تتعلَّق بعراقة وجودة المسار الإنساني منذ العصر الحجري وحتى عصر الطغيان الإلكتروني.
والمفارقة التي لا تحتاج إلى كبير عناء، هي تأكيد نظافة الكف والضمير الفلسطيني من تلك اللوثة العجيبة التي انتشرت كالنار في هشيم الواقعَين العربي والاسلامي.
النظافة الفلسطينية من هذا اللوث تمتدُّ عميقًا وبعيدًا في الزمن والتاريخ على السواء. ففي فلسطين عاشت الأعراق والديانات والمذاهب جنبًا إلى جنب لا يعكّر نعيبٌ هنا شواذّ هناك من فرد أو جماعةٍ ظلّوا سبُل الانسانية والرفعة الأخلاقية والتسامح.
ففي التوصيف الأولي لنجاح التطرف في التغلغل إلى الكثير من المجتمعات واندماج آلاف الشباب في آلياتها الإجرامية، نحيل سببه الى إخفاق الدولة الوطنية في إيصال الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية إلى مواطنيها، واستطرادًا نجاح الإستبداد في سحل الشخصية- المواطن الذي يفترض أن يحقق حلمه في الحياة على قاعدة الحد الأدنى من شروطها السليمة القائمة على الخدمات والطمأنينة ومراكمة أسباب التطور من باب سد ثغرات الفقر والتجهيل.
المسألة الثانية تكمن في استنفاذ بعض النظم أدوارها ضمن دائرة النفوذ الأميركي في حراسة المصالح الأميركية وتكريس الاستقرار الداخلي. أضف إلى ذلك أن وجهة نظر العديد من منظري الواقع الراهن من الغربيين يؤكدون أن ما يحصل حاليًا لا يتصل بقبول أو رفض هذا النظام أو ذاك لشروط التسوية الداخلية التي تعفي البلد من كلفة الدمار والإندثار، لأنه لو حاول ذلك لشنت عليه الحرب تحت عناوين وأسباب أخرى. أضف إلى ذلك أن الخطة المحكمة التي تتم رعايتها من قبل وكالة الإستخبارات المركزية الإميركية وبالتفاصيل المملة تقوم على إطالة أمد الحروب قدر الإمكان وترك القوى المتناحرة تمعن قتلا وإبادة لأبناء الوطن ذاته بشكل لا يسمح فيه لهذه القوة أو ذاك الطرف أن ينتصر. مما يعني أن إعادة وصل العناصر الإنسانية التي كانت تتشكّل منها الدولة قد باتت أمرًا مستحيلًا. مما يعني أيضًا أن لا دول حاليًا تقوم على أنقاض الدولة الأم ولا دولة واحدة مستقبلاً يمكن التبشير بها كنتاج تسوية تاريخية بين أبناء الوطن الواحد.
عندما كانت إسرائيل تسوِّق خلال الإنتفاضة الثانية أن أسلوبها في التعاطي مع أبناء الشعب الفلسطيني يتناسب والطبيعة الشرق اوسطية في إدارة صراعاتها فيما بينها، وبالتالي فإن لا خرق اخلاقي تنفذه إسرائيل ما دامت تتوافق ومعايير المنطقة.
لكننا حين نمعن النظر في مسألة تشدُّد نتنياهو على ضرورة إعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية، ونحاول قراءة الواقع العربي الحالي، فإننا نجد انسجامًا وتماهيًا عميقين بين مشروع نتنياهو تجاه إسرائيل ومشاريع الطوائف والمذاهب وقوى الظلام الممتدة على مساحات واسعة من أراضي بلداننا العربية.
وعندما نشهد ذلك التمادي الصهيوني في رفض القبول بقيام الدولة الفلسطينية- ولو كانت مسخًا- مترافقًا مع مصادرة البنية التحتية من الأراضي المفترض أن تقوم فوقها تلك الدولة، فإننا نكتشف وبعدسة المتضرر من فداحة وخطورة الواقع الحالي مدى إسهام إسرائيل تخطيطًا وإشرافًا ودعمًا وتدخلا مباشرًا في إدارة ما يجري من حروب. وما التدخلات المكشوفة هنا وهناك على الساحة السورية سوى نماذج مظللة لحقيقة ومدى استراتيجية التدخل الإسرائيلي- بالتضامن والتكافل المباشر مع الإدارة الأميركية.
إن تدمير الدولة وتغييب فكرة وجودها يبدو أنه مشروع متناغم بين قوى الظلام وإسرائيل- اميركا. لأن معادلة الجغرافيا- الغابة هي الملعب المثالي لأمراء الظلام وتحقق مثالي لفكرة إسرائيل الكبرى على حساب الحق الفلسطيني. وحين نسأل عن البنية التحتية التي بمقدورها أو تكون عاملا مساعدًا لإحقاق الحق الفلسطيني في الجوار والإقليم بكامله فإننا نكتشف أنه يرزح تحت غيبوبة لا شفاء له منها.
إن إسقاط صفة المثالية على الشعب الفلسطيني هو ظلم له وليس مديحًا. لأن في بنيته الداخلية كلَّ عوامل الغضب والمرارة وانعدام السبل واليأس. وبذات الوقت يدفع ثمنًا باهظًا لحروب لا تعنيه من قريب أو بعيد في سوريا والعراق وليبيا وغيرها.
ما يحصل في المنطقة مضرٌّ بشكل حاد بالفلسطيني ومصيره وقضيته، لكنه وسط تلك الدوّامة، يحتاج إلى الحد الأقصى من المساعدة والرعاية والتضامن الذي يشعره بإنسانيته التي فقد الكثير من حيثيّاتها من وجهة نظر الآخر.
يحتاج الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى إلى التخفيف من معاناته وإلى فتح نوافذ الأمل لديه كي يستطيع عبور هذه المرحلة بسلام، وبشكل لا يقع فيه في محظور والتطرف والظلامية.
إن انحرافَ أي فلسطيني باتجاه قوى التطرف والظلاميَّة هو استهداف مباشر للشعب الفلسطيني كوحدة أخلاقية- قيميَّة وتشويه لتاريخه المليء بالتضحية والألم والصبر القائم على قضيَّة لا تشوب عدالتها شائبة، ولأنها كذلك كانت ولم تزل تشكّل عامل استقطاب واسع لدى القوى المؤمنة بالحرِّية والعدالة الإنسانية.
الجنوح باتجاه التطرف والظلامية يُعدم تاريخًا من النضال الوطني المشرّف الذي خاضه الفلسطينيون ومعهم من الأنصار المنتمين لقضيَّتهم حيث أدّوا دورهم ولم يزلوا يؤدّون أقساط الإنتماء والعطاء.
لا يجوز أبدًا تقزيم قضيّة بحجم قضية فلسطين إلى مستوى مذهب أو طائفة أو فئة، لأنها المعين الذي يتسع لكل ذلك التنوّع الفاضح لعنصريّة وعدوانية الكيان الغاصب، ويقدّم النموذج الحضاري- الإنساني المتساوق مع فكرة الحياة والأمل والإستمرار.
قبل النكبة عام 1948 ذهب إلى المطرانيّة الكاثوليكية وفدًا من 5 أشخاص للمطالبة ببقاء خوري القرية – طرعان- في الإشراف على رعيته. وعندما تم طرح المطلب على سعادة المطران اكتشف أن بين أعضاء الوفد مسلمين اثنين. وعندما سألهم عن السبب التحاقهم بالوفد أجابوه بكل وضوح: هو خوري طرعان وليس خوري المسيحيين.
بعد النكبة تجوّل كهلٌ فلسطيني من مسيحيي البصَّة على عدد من مخيمات اللجوء في لبنان بحثًا عن عريسين لابنتيه الشابتين، شرط أن يتزوَّجهما شابان من القرية نفسها.. لا يهمّه ما دينهما...
أما حين نقرأ تاريخ العلاقة بين الجليل وجبل عامل فإن عدد الزوجات من كلا الهويَّتين لا يحصى نظرًا لجذريَّة العلاقة بين شمال فلسطين وجنوب لبنان، مما يدلُ على انفتاح الفلسطيني على الآخر بصرف النظر عن هويَّته ومذهبه.
إن ما ذكر لا يعدو كونه عيِّنة لا تذكر مقارنة مع تاريخ وأصالة تجربة هذا الشعب العظيم. بكل الإجلال والإحترام نقف أمام تجربة كهذه وكلنا أمل بأن تبقى تلك التجربة
بوصلة الأجيال الفلسطينية وغير الفلسطينية في معادلة الحرّية والحياة.
إن أنسداد الآفاق تجاه كل مجتمعات المنطقة يضع الشعب الفلسطيني في مقدمة من يستهدفهم خيار التمزيق والتهميش وبالتالي التفتيت الذي يقضي على أي أمل ببناء الدولة وإتمام مقوّمات حياتها وفي طليعتها حق العودة بالمنطق الذي يرضي اللاجئين ويعيد اليهم اعتبارهم التاريخي كبشر عانوا ما لم يعانه أي شعب آخر في العصر الحديث.
كان الفلسطيني ولم يزل عصيَّا على المشاريع العابرة والمدمرة للذات قبل الآخر... قدرُه أن يبقى مدافعًا عو هويَّته التي تتجاوز التعريف الشخصي والتاكيد الوجودي، لأن مسلَّماته التاريخية والحضاية التعدّدية والمختلفة الأوجه الجميلة في العيش الواحد والتعايش الواحد أكثر جذريَّة والتصاقًا بالواقع وذات قابلية ومصداقية للبقاء.
كأننا ندقُ ناقوس الحذر من وصول بعض الملوّثات والسموم القاتلة إلى الجزء الحصين من الذاكرة الفلسطينية النظيفة... وإلى جغرافيا انتشار هذا الشعب المظلوم والمكافح... بلا حدود. لكننا وبكل طلاقة واثقون من صلابة عود هذا الشعب المعطاء ومن قدرته على تطويق وعزل أية حالة قد تحاول الإنفصال عن مسار التجربة الفلسطينية المميزة والمشرِّفة.
تجربة الشعب وثورته: تصلح ملهمة دائمة للأجيال الفلسطينية
02-07-2015
مشاهدة: 1140
محمد سرور












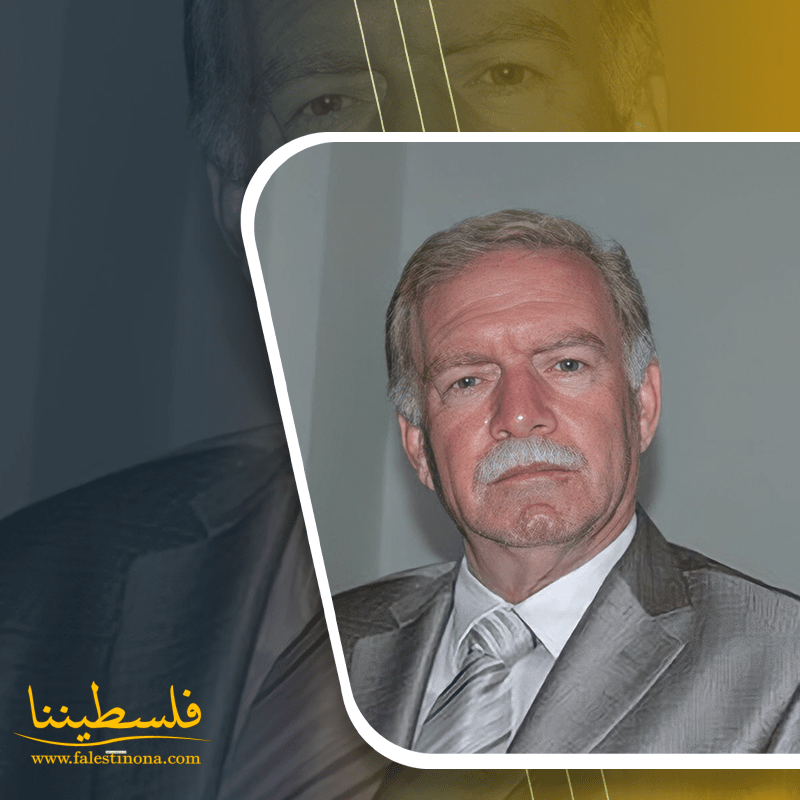




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها