لروحك السلام والفردوس. لا نعلم كم عدد الذين أطلقوا الرصاص عليك وقتلوك. سؤالك الأخير لهم، وهو الذي اضطررت لأن تكتبه برصاصات، طالت شريراً يعيث في أرضنا فساداً؛ لن يستطيعوا الإجابة عنه. أنت من رمى الإجابة ثم رحل: هل تظنون أنكم فوق المساءلة وفوق القصاص، وأنكم ستظلون أبد الدهر آمنين، واهمين اننا شعب ميت، فإن تنفّس، يكون كل شهيق وكل زفير، بتصريح منكم؟
في وجبة الطعام الأخيرة، التي كنت قائماً عليها في مطعم عملك؛ سجلت يا معتز، تأكيدك على انحياز الفلسطيني للحياة. لم يكن السُم، ولا القتل العشوائي، ولا الكراهية الشاملة، هي وسائل دفاعك عن القدس وعن الأرض، وعن حق الفلسطينيين في العبادة، وفي الطرق المفتوحة الى صحن الأقصى. كان هدفك أحد رؤوس الأفاعي، التي تنفث السُم وتلوث البيئة، وتفاقم الضغائن، وتجعل الجريمة والتعدي وامتهان كرامات الناس، وترويع الأطفال، وانتهاك حُرمات البيوت؛ وسائل للتطهر من "ذنوب" الورع الديني، الذي يُملي على كل المؤمنين، كف الأيدي عن الأذى والقتل والسرقة، وامتهان الإنسان وحرق بيته وأشجاره وتحطيم قبره.
لست قاتلاً يا معتز. فالقتلة هم الذين اغتالوك. لم يكن سليمان الحلبي قاتلاً. فالقتلة هم الذين أعدوا له ميتة فظيعة، في السنة الأولى من القرن التاسع عشر. دعني يا معتز، أروي لك الحكاية، التي ينبغي أن تسمعها قبل نومك الأخير، لأقول لك في ختامها، إنك، بمقاصدك المنزّهة عن حسبة الحياة؛ أعلى قامة من سليمان، على الرغم من علو شأنه في تاريخ كفاح الأمة:
يروي المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي، الذي عاصر الحملة الفرنسية على مصر، ما فهمنا منه، إن سليمان، وهو في حلب، علم باستباحة الفرنسيين لأرض مصر، وجاءته أنباء انتهاك حرمات شعبها. كان أبوه "محمد أمين وَنَس" رجلاً تقياً، يبيع في دكانه السمن والعسل وزيت الزيتون. أثقلت عليه الضرائب العثمانية وتعثر في سدادها، فسجنته السلطات. ارتحل ابنه الفتى سليمان، ذو الــ 24 ربيعاً الى القدس، وحط الرحال في موضع قريب من سكنى أهلك يا معتز. وكان الوزير العثماني الذي هزمه الفرنسيون، قد دق أوتاد خيمته في غزة التي بدأت منها الحكاية. كأنما هزيمة الوزير العثماني، اقتضت تغييراً في الأسماء وتبديلاً للخيول. وكأنما أيضاً، التقت مقاصد الإنسان ممثلاً لأمته، مع مقاصد السلطة في صراع وجودها. أرسل الوزير أحد "الأغوات" لكي يتولى المسؤولية في القدس "متسلماً" لها كما يسمى في ذلك الوقت، وأوصاه أن يرسل شاباً جسوراً، لقطع رأس القائد العسكري الفرنسي "جان باتيست كليبر". وبمحض المصادفة، ذهب الفتى الشجاع، للسلام على "أحمد أغا". ومن خلال الحديث علم الأخير أن والد سليمان، مسجون بسبب ديون، فوجد الأمر حافزاً إضافياً، يُقَدَم لسليمان لكي يقوم بمهمة الاقتصاص من "كليبر" فيُعفى والد سليمان من ديونه، ويعود الى دكانه، ففاتح "الأغا" سليمان في الأمر. هكذا بدأت رحلة الشاب، الذي توجه الى غزة. هناك، يقول الجبرتي إن سليمان، التحق بقافلة بضائع شامية متجهة الى مصر، تحمل صابوناً وتبغاً. وصل الى القاهرة ولجأ الى الرواق الشامي في الأزهر. ولكونه شاباً صغير السن، لم يتكتم على مقصده في حضرة المشايخ. بعضهم نصحه بالتريث أو العدول، وبعضهم شجعه. وجميع هؤلاء شنقوا بعدئذٍ، أمام عينيه وقبل إعدامه بفظاعة، بجريرة العلم بالأمر وعدم الإبلاغ.
كان "كليبر" يظن انه آمن. أقام في دار منيفة، في موضع بيع الكتب القديمة الآن، أي "الأزبكية" في ميدان العتبة. انسل سليمان من بين الأشجار، وتقدم الى الجنرال الجالس في بستان الدار، في هيئة شحاذ. شدّ "كليبر" من يده بقوة وطرحه أرضاً، وأعطاه أربع طعنات نجلاء اجهزت عليه، ثم أتبعها بطعنة لكبير المهندسين الذي معه، لم تُجهز عليه.
كان الحدث شرارة أشعلت ثورة، وعلامة فارقة في تاريخ أمة. ففي حزيران 1800 وقع الاقتصاص من الغازي، وفي تموز من العام التالي، رحل الفرنسيون يجرّون أذيال الخزي.
بدأ إعدام سليمان، بعد أن شاهد تطاير رؤوس المشايخ القاعدين في الأزهر. تولى الجنرال "بارتيملي" حرق يد سليمان، التي طَعَنت، وهذه الرتبة التي أحرقت، هي التي تليق بيد الشاب. ثم أرسلوه مدمى، الى حي "القلعة" حيث الحارة الأكثر فقراً الآن "تل العقارب" لكي يتخوزق ويموت مشهوداً وشاهداً وهو يقرأ القرآن.
في "متحف الإنسان" في باريس، يحتفظ الفرنسيون حتى الآن، بخنجر سليمان ورفاته. أما معتز، فقد احتضن تراب القدس، بعد موت يضاهي الحياة. فنم قرير العين يا معتز، وسلام عليك.
يا معتز: بقلم عدلي صادق
01-11-2014
مشاهدة: 698
عدلي صادق










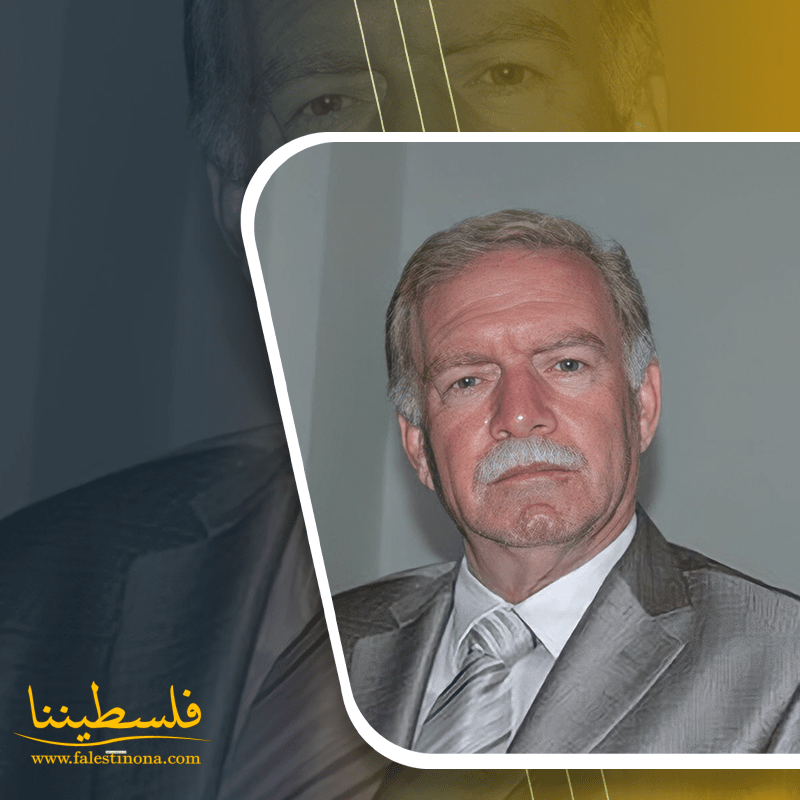
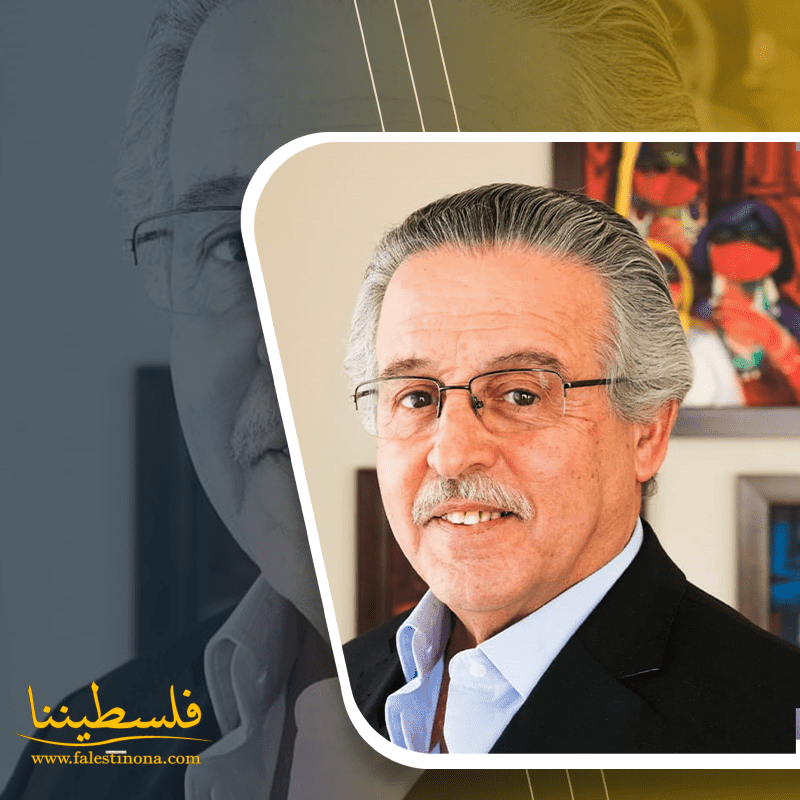




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها