ألقاب وصفات ما أنزل الله بها من سلطان يطلقها البعض على أنفسهم وتراهم وكأنهم في نشوة السكارى، يتلذذون بسماعها من منافقين ومصفقين، حتى أن الأبطال المعروفين في كتب ثقافة الشعوب من علماء ومفكرين وبناة الأهرامات ناطحات السحاب والسائرين على القمر مثلاً لا يحظون بعشرها، لكن إذا ركزنا الضوء عليه لاكتشفنا ضعف حيلته، وقشرية انجازاته التي لا تتجاوز قدرته الكلامية التعبوية ومهارته في استخدام سلاح المصطلحات الوطنية رشًا ودراكًا وقنصًا، لكسب الاعجاب، وتجميع حشود بالعشرات او بالمئات أو حتى بالآلاف لا يهم، فالأهم عند (هذا) أنهم مأخوذون بشخصه أو بخطاباته المنبرية العنترية العصماء، وبكلامه القادح للشرر، يسلمون بكل كلمة، يصفقون ويهتفون، ثم يذهبون الى المقاهي وجلسات النميمة، وهكذا تدور دواليب حيواتهم مطمئنين إلى مكانة (الهذا) واستطاعته إزالة أي حاجز قد يعرقل مسارها، وبذلك اعفاهم وأعفوا أنفسهم من الإجابة عن أهم سؤال في حياة الانسان، لا تصح ولا تستقيم مواطنة الفرد والانسجام التام في مجتمع (الشعب) إلا بمعرفة وإدراك التطبيقات العملية اللازمة لتجسيدها وبيانها كمنارة، وفي الحد الأدنى كشمعة، فالمرء إما أن يكون نقطة مضيئة– بغض النظر عن حجمها– أو يكون جسمًا مظلمًا، وهذا مكانه في باطن الأرض الى جانب آبار النفط يستخرج للإحراق وللاستخدام كوقود فقط، وهنا بيت القصيد.
ينطبق ما كتبناه على شريحة مستفيدة مستنفعة متكسبة، هم (أشخاص) غير محصورين ولا معدودين، جاثمون على رؤوس تشكيلات متنوعة، تتمدد نسخهم كالنباتات الطفيلية، في أبشع صورة استغلال لبيئة وظروف الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي الذي بات مناخًا ملائمًا جدا لنمو هذه الشرائح على حساب البنية الأساسية للفرد المواطن الانسان.
ما زال هؤلاء يتعاملون مع الفرد في مجتمع الشعب من منظور العدد، وكثقل في ميزان الحسابات السياسية، وعدد إضافي في رقم الولاءات الشخصية والعائلية والعشائرية، ولم يثبت أنهم عملوا يومًا على تجسيد المعنى الحقيقي للثورة الفلسطينية، ومبادئ وأدبيات وأهداف حركة التحرر الوطنية، فهم عن سابق قصد وترصد اهملوا التغيير الجذري في مفاهيم وسلوكيات والسائد المتخلف الدخيل على ثقافة المجتمع، أو أنهم فشلوا إذا افترضنا حُسن النية، فكرسوا وقتهم لإبراز ذواتهم على حساب تنمية المجتمع وتطويره، أو تقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ تساعد الأجيال على التحرر من عبء المفاهيم والثقافة المدسوسة السائدة، فراح كل واحد منهم يحشد باتجاه عصبيته الخاصة التي قد تكون سياسية تنظيمية، فصائلية عشائرية، اجتماعية، حتى بعض اصحاب رؤوس المال، وأرباب والاقتصاد ذهبوا بهذا المنحى، وكل ذلك على حساب بنية الفرد (المواطن) العقلية العلمية والتعليمية المنهجية، والثقافية والتربوية، وكذلك الصحية وتأمين الحدود المعقولة من المتطلبات المادية ضمن إطار حالة اقتصادية تفي بضمان ديمومة حركة الناس في البلد بالحد المعقول من التفاؤل والأمل.
يجب الاقرار أن الفشل اقترن باسم (هذا وذاك) الذي أصبح في حالة الجمع بأسماء (هؤلاء وذلكم)، رغم علمهم أن حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، كانت لتحرير الإنسان أولاً لأنه العامل الأساس لتحرير الأرض والضمان لبناء المستقبل، وعليهم أن يعلموا أن منهجنا قام على العمل بخطين متوازيين: الكفاح والنضال الثوري، بالتوازي مع النضال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والعلمي المعرفي، على أمل رفع ركائز الدولة على قواعد التجارب الذاتية او التي اكتسبناها بحكم الشتات أو من بلاد المهجر، لكن فيروس الأنا الذي بدا لنا (كمستوطن) نما وترعرع في ظل الشعارات واليافطات الوطنية، صار الآن بمثابة حالة خطيرة موازية تهدد النظام والقانون، وتدك كل ما تم تحقيقه في مشروع بناء الانسان المعاصر القادر على الموائمة بين الصمود والنضال ضد الاحتلال والبناء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي والمعرفي والسياسي القائم جميعه على ايمان الفرد بمبدأ المواطنة، لكن (هؤلاء وذلكم) قد فشلوا في إيصال المواطن إلى الحدود المطلوبة لتثبيت قناعاته على قاعدة الانتماء الوطني.
ما نشهده من صراعات سياسية واجتماعية فردية وجمعية، وانفلات مدفوع الأجر، وغلبة الأنا على مصلحة (المجتمع)، وتراجع منسوب العقلانية في النظر للأمور وحل المشاكل، وغيبوبة المنطق غرفة الموت السريري، والبحث عن الخلاص الفردي حتى لو غرقت سفينة الوطن، كل هذا انعكاس طبيعي لفشل ذاتي أضخم وأشد فتكًا من عامل الاحتلال الذي يسعى مع (هذا وهؤلاء وذلكم) إلى إعدام أي فرصة نجاح في حياة الفلسطيني.
الاعتراف بالفشل لا يكفي، بل يجب إتباعه بقرارات محاسبة تبدأ من وضع كل واحد منا نفسه في غرفة تحقيق، وصولاً إلى بحث وتحقيق عقلاني علمي، فالزمن يعطي فرصة للراغبين بالنجاح في مراجعة نظرياتهم وأدواتهم ووسائلهم، لكنه لا يمنح الفاشلين مهلاً بلا حدود.









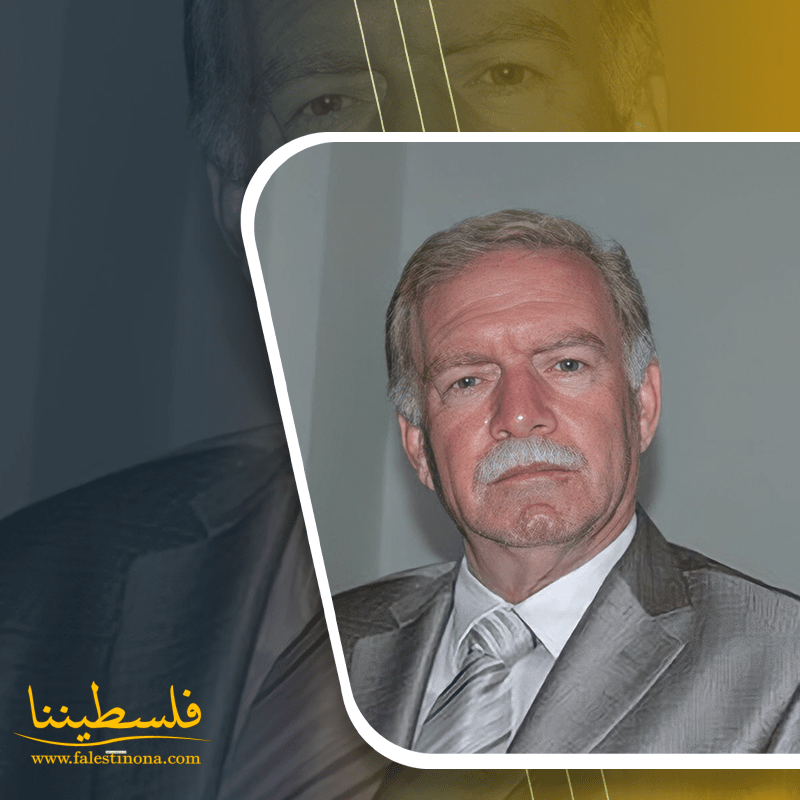
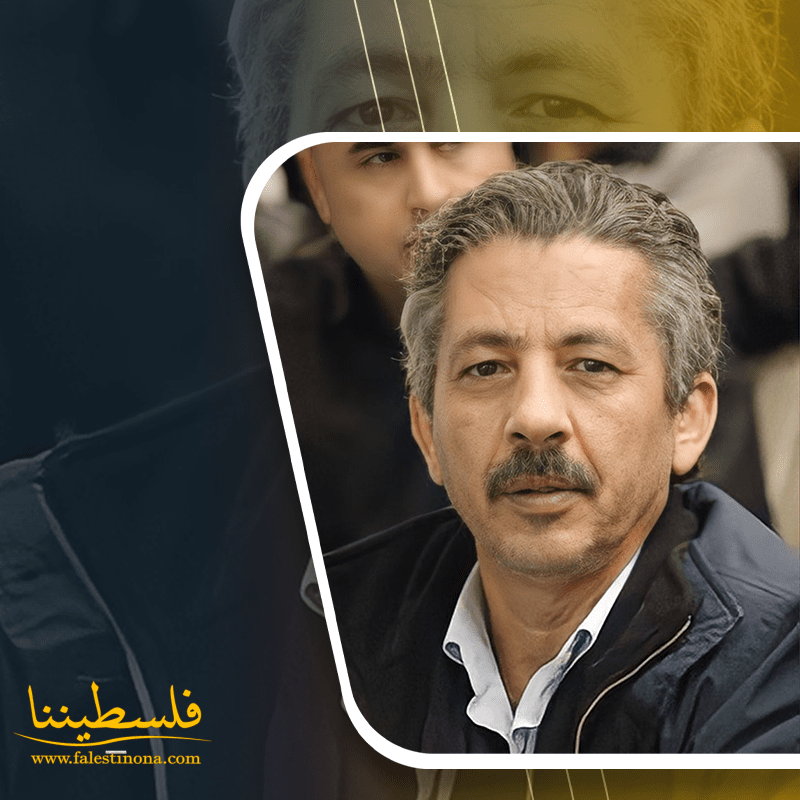






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها