كنا نستيقظ في كل صباح كالمعتاد؛ رائحة خبز الطابون تَلفُ أرجاء المنزل، نستعيد نشاطنا ونعشق صباحنا بتلك الرائحة، نتناول وجبة الإفطار التي تعُدها أنامل الأمهات، ونشرب الشاي، ومن ثم الانطلاق إلى العمل، إما مزارعاً بأرضك للحصاد أو صياداً في بحر يافا الجميل، ففي صبيحة يوم من الأيام استفقنا وأهالي القُرى على صوت آليات جائرة يستقلها جنودٌ بيضٌ يصرخون بلغات غير معروفة بجعبتهم الكثير من القذائف، وأسلحةٍ وعتاد، بينما نحن لا نملك سوى أدوات بسيطة وعدة الفلاحة، صياح وعويل بدأ هنا وهناك وجندي غاصب يتوغل في كل مكان.. مشاهد عجزت أن تمحوها الأيام من ذاكرة من عايشوها: "لما طلعنا يا بنتي قلنا أسبوعين وبنرجع، والجاجات عقّبنالهن حَب وتبن ومي عشان لا يعطشن ولا يجوعن وسكرنا باب هالدار بالمفتاح وحطيناه بجيوبنا ومشينا ومن وقتها ظلينا متأملين نرجع، بس للأسف صدّى مفتاح هالدار ولسا مارجعنا". هكذا بدأ الحاج الثمانينيّ أبو أحمد حديثه وهو أحد المهجّرين قسراً، يجلس أمام منزله بأحد أزقة مخيمات اللجوء والحزن يملأ عينيه ومرارة الألم تعتصر قلبه، يستذكر بعضاً من التفاصيل بوجع حنينه إلى الماضي قائلا: "كانت في دارنا مغارة والباب تاعها بدخلة الدار، كنت والله لو يعطوني أملك كل فلسطين مقابل هالمغارة ماببدلهمش فيها.. ولا شجرة التين واللّوز إلي كانت تحمينا بفيّها وقت ما نرجع من الحصاد، أرضك وتعبك بياخذها اليهود قدام عينيك وانت مش قادر تعمل اشي". فهنا لا يتوقف شريط الذكريات عن اعتصار آلامنا وجراحنا، فحال أبو أحمد كما الآلاف الذين هُجروا من بيوتِهم يحمِلون قصصاً وحكايا تذكرنا بحجم مأساتنا كفلسطينيين، والتي يصعب علينا وصفها بالصورة الصريحة بكامل المشاعر سوى من عايش أحداثها ومن حلت عليهم لعنة الرحيل، مشوا راحلين، وعيونهم باكية لكن مقسِمين أنهم عائدون. وفي الحقيقة لم تكن سوى بداية لرحلة طويلة من التشرد والشقاء، فتلك مسنة تجاوزت التسعين من عمرها كانت تعيش في عكا شاهدة على التهجير حظيت بذاكرة عامرة بالتفاصيل تحكي عما جرى في المدن المجاورة ومنها حيفا، تطرقت إلى والدتها وأخوالها المناضلين، ووالدها الذي أوكلت إليه مهمة إعالة العائلة، وعمل هاتفيًا في سكة الحديد عكا-حيفا وخوفًا مِن تسارع الأحداث والمُستقبل المُبهم، وهكذا بدأ الرحيل إلى لبنان بالزوارق بفعل مؤامرة كبرى لتهجير أكبر عدد من العرب، ثم تقول: بعد سقوط حيفا في 22 نيسان عام 1948 والصدمة الكبيرة التي خلفت وراءها مشاهد مُفجعة، هربت معظم العائلات الفلسطينية بملابس نومها، وأمهات نسين أبناءهن في البيت وغادرن المكان، وأخريات استبدلن أبناءهن الرُضّع بمخدةٍ على السرير، واستيقظن على ويلاتٍ أكبر مِن حجم استيعابهن"، ناهيك عن المأسي الأخرى الكبيرة.
وفي مشهد آخر متصل بمرارة أحداث النكبة تسمع تلك المرأة أصوات انفجارات تهز أرجاء المكان تترجل مسرعةً نحو منزلها لتجد زوجها وأبناءها يسبحون في بركة دماء، وصوت رضيعيها يعلو، فاحتضنتهما بلهف وغادرت مذعورة المكان إلى منزل أهلها لتجد المشهد ذاته، فلم تجد المرأة المكلومة أمامها سوى حمار عليه "خُرج" لتضع فيه رضيعيها، وتسير مشياً على الأقدام، حتى وصلت لشرق الشجاعية وقد حل الظلام وسقطت في نعاس عميق من شدة التعب، وحين استفاقت صُعقت بضياع الحمار ومعه رضيعيها.
ليست قصة من وحي الخيال بل قصة حقيقية وقعت بمذابح النكبة، والذي استخدم خلالها الاحتلال جميع أنواع الأسلحة والأساليب المحرمة دولياً بهدف تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها، فمعظم المهجّرين إما استشعروا قرب اليهود القتلة منهم فاضطروا إلى مغادرة قراهُم والهروب من مذابح مرعبة تنتظرهُم، أو أن يشهدوا العذاب بأعينهم، وما زالت آثار العذاب متأصلةً داخل نفوسهم، فمشاهد الموت إبّان التهجير أسوأ من ألف فيلم رعب.
كانت مفترقات فلسطين آنذاك ممتلئة بالمهاجرين، وصراخ جنود يهود ينادون على المحظوظين الذين لم تطلهم يد القتل يخبرونهم بالتزام الطريق وإلا القتل مصيرهم، فعلى الطريق وبزحمة هذه الأحداث كانت سبباً في تشتت العائلات وتفرقهم, ونقطة ضياع الأشقّاء عن بعضهم البعض.
إنها النكبة "الذكرى اللعينة" التي حجزت مكاناً ثابتاً في ذاكرة من عايشها، حاملةً تفاصيل دقيقة لشعبٍ كان يملكُ كُل شيءٍ، وفي لمحةِ بصر أضاعَ كُلَ شيء، أبناءه، بيته، وأرضه الذي ابتعد عنها آلاف الأميال، لكن في رئتيه وقلبه لا تزالُ تسكُنّ أينما سَكَن.
1948هذا التاريخ الذي صار جرحًا في خاصرة الأمة وما زال ينزف، بلاد لم تضِع وإنما ضاع أهلها وتشتتوا ليحلوا ضيوفاً على بلاد قد استقبلتهم واعتبرتهم جزءاً من نسيجها الداخلي، نساء وشيوخ وأطفال تركوا قراهم وممتلكاتهم يحملون في جيوبهم مفاتيح أبوابهم الموصدة باعتقادهم، على أمل العودة القريبة .
فالنكبة، ذلك اليوم الذي هُجر فيه أصحاب البلاد واغُتصبت الأرض على مرأى ومسمع من العالم، وفي ذكراها هُجر أكثر من 750 ألف فلسطيني بِشكل قسريّ من بيوتهم وأراضيهم فذروة الأحداث كانت في أيار/ مايو عام 1948 حيث كانت البداية الأليمة خلال الحملة الفرنسية على عالمنا العربي، نابليون الذي نشر بيانا يدعو فيه لإقامة وطن لليهود على أرض فلسطين، ومع وصول الاستعمار البريطاني إلى فلسطين عادت تلك الخطة ودخلت حيز التنفيذ من خلال تنظيم الهجرات اليهودية إلى فلسطين ووعد بلفور الكارثي، لكن الشعب الفلسطيني لم يقف صامتاً وتجسد ذلك بغضبٍ شعبي في ثورة عام 1936 التي قابلها الاحتلال البريطاني بأشد أنواع القمع، وهنا نستذكر التخطيط للتطهير العرقي والتهجير وكيف قامت بريطانيا بِتسليم ملف فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة التي بدورها أعلنت تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وبعد الرفض الفلسطيني للخطة قامت الحرب المعروفة بالثمانية والأربعين، وفي يوم انتهاء الانتداب البريطاني جاء بن غوريون ليعلن قيام ما يسمى بدولة اسرائيل، لتعترف الولايات المتحدة خلال دقائق فقط بالكيان الجديد، وانتهت الحرب بتوقيع الهدنة وبعد يوم واحد فقط انضمت اسرائيل إلى الأمم المتحدة ولم يتبقَ لأصحاب البلاد الأصليين إلا ما يعرف الآن بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ورغم سوء الذكريات المؤلمة إلا أن الفخر باستمرار المقاومة ضد الاحتلال ما هو إلا أكبر دليل على عدم قدرته على مسح ذكريات النكبة من ذاكرة الفلسطينيين بل هي الشرارة التي تشعل فيهم روح المقاومة من جديد، فهموم شعبنا وجراحه لم تندمل من ذكرى بيت هجروا منه، وشهداء سقطوا خلال أيام النكبة، إلى انتهاكات جائرة من العدو الغاشم وحسرات وجروح عميقة ما زالت تنزف جرحاً وألماً، فأمهات يبكين شهداء وينتظرن آلاف الأسرى في السجون.
ها نحن نسير ونمضي ويبقى الوطن ونحيا على أمل العودة ولا شيء يعبر عما يختلج صدرونا وحلمنا بالعودة سوى قول الشاعر سامي غانم:
هل يا ترى نحظى من بعد نكبتنا بدولة فيها نحيا ونتصل؟ فالليل طال بنا، لم يأتنا فجر ٌولا يجيءُ لنا عيد ٌونحتفل.. فهل يزول بنا كابوسُ نحياه؟ نقيم دولتَنا، ويزول محتل، نقيمه عرساً من بعد نكبتنا.
عروبة النجار




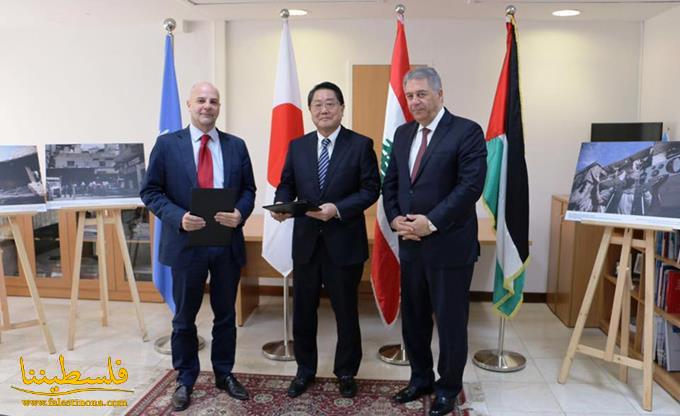




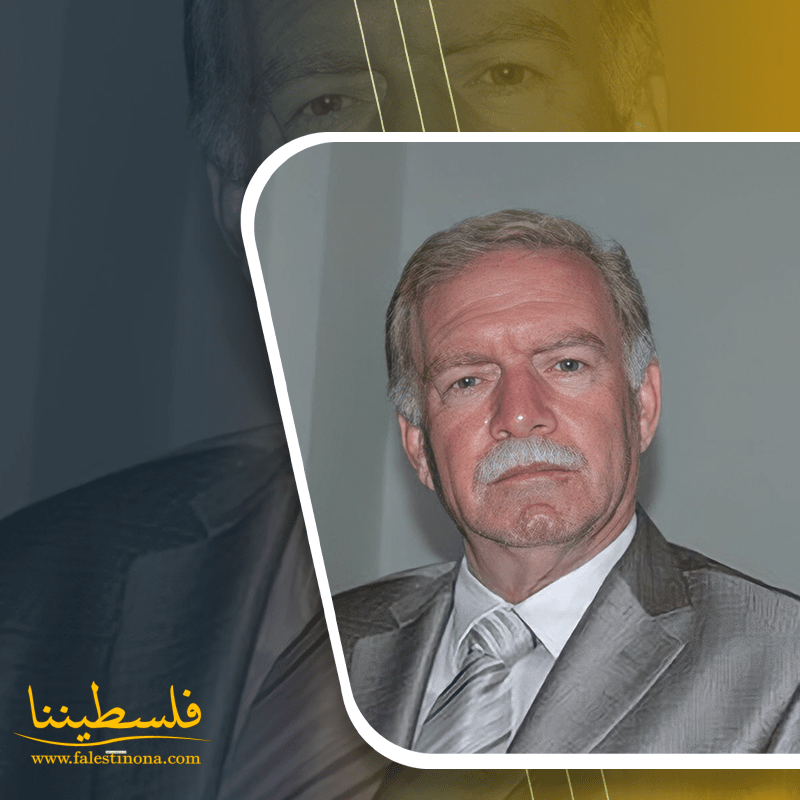






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها