أن تحكي سيرة مخيم، فكأنك تحكي سيرة مدينة أو وطن. لم أُمنح شرف العيش في المخيم، لكني انخرطت في تفاصيل حياته، من خلال علاقتي بطلابي، حين عملت مدرّسة في مدارس الأونروا، ومن خلال أنشطة، تنتمي لحب فلسطين. بداية معرفتي بالمخيم، كانت حين فقدت مقعدي في مدرسة اتحاد الكنائس الإنجيلية، بسبب تأخرنا في العودة من سفرة صيفية. مدير المدرسة، المربي العكاوي "أبو فريد الجراح". قال لأمي أرسليها إلى مدرسة للأونروا، ونحجز لها مقعدًا في العام الدراسي المقبل.
بكيت لفراق مدرستي، وللبون الشاسع بين المدرستين. بعد موجة بكاء، جاء أخي الأكبر، ليقرص أذني برفق ويصطحبني عبر ممرات بين بساتين برتقال وصبار، وطرقات كانت ضيقة. وجدت الطفلة ابنة السابعة، التي كنتها، تقف أمام تلال رملية حمراء، وخيام كاكية اللون تتموضع وتتبعثر على تلك المساحة الرملية. أطفال يلهون، يصعدون التلال ويتدحرجون مع صيحات فرح ومرح. وكبار، منهمكون بتثبيت الخيام، وأشياء أخرى. ونسوة يحملن جرار ماء. تنظر الطفلة إلى مشهد بانورامي، وتستمع إلى شروح أخيها.. وكان درسها الأول في تاريخ وجغرافية، مكانها المضيّع.
لاحقًا وبعد انخراطي في أنشطة سياسية مع أخي، أدركت كيف صارت المخيمات، استعاضة عن الوطن، وكيف تجمع أبناء كل قرية في مكان واحد من المخيم. حي الكابري، وحي الصفصاف وشعب والكويكات.. والأشهر كان حيّ جورة التراشحة. ربما لوقوعها في أرض منخفضة، وكانت تعتبر أرقى أحياء المخيم، وأهلها يعتبرون ترشيحة مدينة وليست قرية.. صديقة لي كانت تمازحني: عكا تابعة لقضاء ترشيحة. اشتهرت نساء ترشيحة بأنهنّ اكثر أناقة من سائر نساء المخيم، بمقاييس ذلك الزمن. وتميزن بارتداء الذهب على أنواعه، بالأيدي يخشخش الذهب فيها عند أقل حركة، وكلما ثقلت الحركة والخشخشة، تكون دليل كثرتها. وعلى صدورهن، تدلّت العديد من السلاسل الذهبية. استعادت القرى الفلسطينية حضورها، وبناء مجتمعها وثقافتها، رغم استبدال ظلال البيارة بظلال الخيم الكاكية، لكنهم حملوا معهم أيضًا، التقسيم الاجتماعي "فلاح/ مدني".
قبل سنوات قليلة، تلقيتُ طلبَ صداقة من صاحب اسم مركّب بطريقة، لم أفهمها، "كاو كاني". أرفق الطلب برسالة على الخاص، قال إنَّنا كنا في صف واحد في الثاني الابتدائي، عند الأستاذ "خير شبل"، الذي كان يدلّلني. تحادثنا، أثنيت على ذاكرته، وأني لا اذكر ملامحه، فقد كنا في سن السابعة. وأخبرني أنّ سبب تذكره لي، "ليس مرده شباب الذاكرة، بل لأنّك كنت الوحيدة من أهل الدور"، أي خارج المخيم، و"كنا ننتظرك لنتفرّج عليك".. عدتُ والتقيتُ الصديق الكويكاتي في مخيم برج البراجنة.
تمتّع سكان الدور، بامتياز مؤقت. و"برستيج" اجتماعي، ما لبث أن تلاشى مع انتقال "م.ت.ف" إلى بيروت. حيث شهد المخيم انفتاحًا واسعًا على البيئة اللبنانية. واستقطب العديد من أحرار العالم. وغيّر اسمه من مخيم إلى معسكر، واللاجئين تحولوا إلى فدائيين. فانتعشت الحياة الاجتماعية، وتبدّلت من حالات اليأس والمطاردات الأمنية، وحلّ مركز الكفاح المسلح، مكان مركز الدرك. واحتل المخيم مكانة، تمثّل الطبقة الأبرز في المجتمع الفلسطيني.
انتشرت مكاتب الفصائل الفلسطينية، التي بدأت تتكاثر بالانقسام. وتهافت الناس على الانضمام لتلك الفصائل، كل بحسب خلفيته التاريخية أو مصالحه الآنية. وصار الانتماء للمخيّم مفخرة ووسام شرف. وواجه " أهل الدور"، تمييزًا صارخًا، تمثّل في مواقف لا تخلو من المزايدات الوطنية، واحتكار وجع اللجوء، دعمتها مصطلحات سادت حينها، مثل البرجوازية الحقيرة وغيرها. على الرغم من أن المطاردات الأمنية والاعتقالات، تطال الفلسطيني بلا تمييز بين أهل مخيم وأهل دور! لكن التركيز على معاناة سكان المخيمات، وما آلت إليه أوضاع اللاجئين، صنّف المخيم كرمز لعذابات المنفى، وعنوان كبير للثورية والوطنية. ولعل أبرز من بلور تلك الهوية للمخيمات، كانت لكتاب من خارج المخيمات، من غسان كنفاني وسميرة عزام..
شهدنا بعد حين، كيف "تبرجز"، العديد من المزايدين، على حساب فصائلهم. أي صاروا بورجوازيين، وانسلخوا عن طبقة الكادحين. وواجه "أهل الدور"، العديد من المشاكل لاختراق بيئة المخيم، وصلت إلى حد الرشق بالحجارة والتنمير. وتكرس المخيم وحده، كأيقونة للنضال والوطنية، وهذا ما ساهم في تهميش دور النضال الفلسطيني خارج إطار المخيم والفقر، الذي تلاقى وتماهى مع سياسة مصادرة إبداعات الشعب الفلسطيني، وحصره النضال في بؤرة الفقر.
ما زلنا حتى الآن حين يعرّف الفلسطيني نفسه "فلسطيني من لبنان"، يُسأل من أي مخيم أنت؟ موضوعي لهذه التغريدة، جاء بعد نقاش مع صديقة قديمة، لا تزال تحمل المفهوم الخاطئ: لتكون فلسطينيًّا وطنيًّا، يعني أن تكون خلفيتك من المخيّم !
قال لي صحفي عراقي ذات مرة، بعد قراءته لروايتي "أجفان عكا"، أبدعت في وصف تفاصيل حياة المخيم، رغم أنك لم تسكنيه، لكني أقول لك "حلّوا عن سما المخيم، واتركوا لأهله الكتابة عنه، أليس لك بيئة فلسطينية تخصك لتكتبي عنها!".










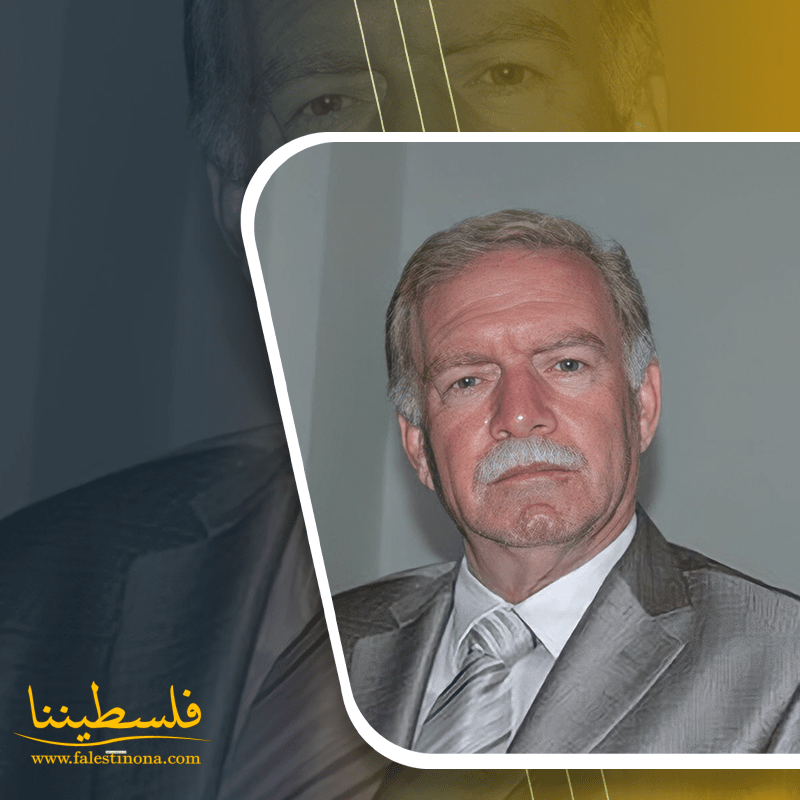
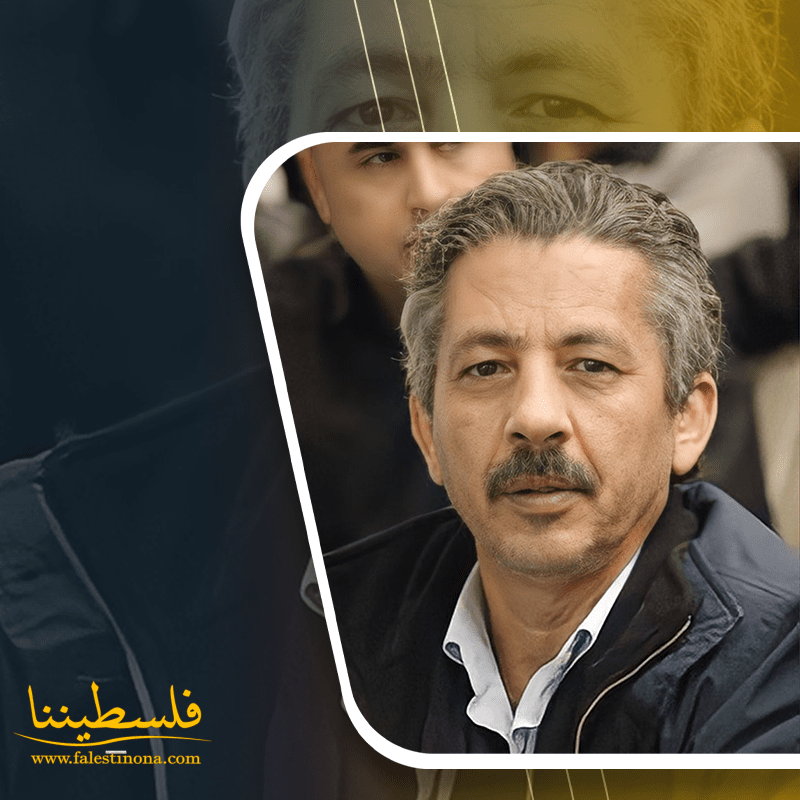
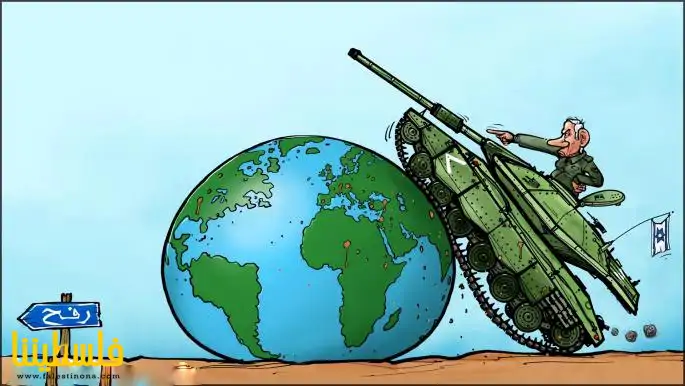



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها