تم خلق والتأصيل للعملية الديمقراطية في المجتمع البرجوازي منذ باكورة أيامه الأولى، لا بل كانت الديمقراطية علامة فارقة في وجوده، وهي إحدى سماته الأساسية، وعلى تماس مع نشوء وولادة النظام البرجوازي وقبل مرحلة المانيفاكتورة (البرجوازية البدائية). ولم يكن إنتاجها وترسخها في الواقع في عصر النهضة نهايات القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر استجابة من النظام الجديد لحاجات الجماهير الشعبية والمجتمع، إنما يكمن السبب الأساس في وجودها وملازمتها له لمصلحة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة والصاعدة على أنقاض التشكلية الإقطاعية. لكن هذه الديمقراطية، التي فتحت الأبواب واسعا أمام حرية العمل، وبيع وشراء قوة العمل حيثما يريد العامل، وحرية الرأي والرأي الآخر والتعبير والتنظيم والانتخاب ومظاهرها وتجلياتها المختلفة بقيت أداة ووسيلة سحرية في يد النظام البرجوازي منذ كان يحبو في رحم المرحلة الإقطاعية حتى صعوده على سدة المجتمعات البشرية. وكلما تطورت المجتمعات الرأسمالية، طورت معها العملية الديمقراطية، وأبقتها سلاحا بيدها. حتى أن الديمقراطية باتت حبل المشنقة الملفوف على رقبة المجتمعات المتخلفة (العالم الثالثية)، التي تعاني من عوامل التخلف الفكري السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لأن أيديولوجيي النظام الرأسمالي ومنظريه ومؤسساته الأمنية رأوا فيها شعارا وأداة لإخضاع تلك الأنظمة لمشيئتها السياسية والاقتصادية في مرحلة العولمة المتوحشة مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي لا تعني ما تقوله، حين ترفع شعار "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"، بل تستخدمها كذريعة لسخط وتدجين الأنظمة المغلوبة على أمرها لمشيئتها ومخططاتها النهبيوية، وبما يؤمن لها الربح الاحتكاري من ثروات وخيرات تلك البلدان الضعيفة والفقيرة، وغير القادرة على استثمار خيرات بلدانها.
ورغم ذلك، لا يمكن إنكار أهمية العملية الديمقراطية في حياة الشعوب وتطورها. لأنها فتحت العقل على مصاريعه ليفكر ويبحث فيما يخدم الجماعات والشعوب والبشرية عموما، وسمحت ولو وفق أجندة النظم البرجوازية للتلاقح الفكري والسياسي والثقافي والمعرفي عموما، وأغنت تجارب الشعوب، وأتاحت للرأسماليين بتجديد وإعادة إنتاج النظام البرجوازي نفسه في كل حقبة من حقب التطور، أو بعد كل أزمة بنيوية واجهها النظام. وبالتالي التشوه والتناقض الداخلي للعملية الاجتماعية، وما حملته الديمقراطية من أخطار على نفسها، وعلى الشعوب، لم ينتقص من دورها في إعطاء فسحة من الحرية الفكرية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية إلخ، وسمحت للمواطنين من تفريغ طاقة السخط والغليان في الأنشطة والعمليات الاجتماعية والثقافية، التي كفلها النظام البرجوازي للمجتمع. وعطفا على ذلك يمكن اعتبار النظام البرجوازي الديمقراطي "أفضل الأنظمة السيئة" حسب توصيف المفكر الفرنسي دو توكفيل.
في السياق حاولت الحركة الشيوعية وأنظمتها الاشتراكية إنتاج "ديمقراطيتها" الخاصة بها، واعتبر لينين، أن "الديمقراطية الاشتراكية" هي الأغنى والأكثر سعة، والمعبرة عن الديمقراطية الحقيقية، بعكس الديمقراطية البرجوازية القاصرة والمفبركة والمملوءة بالمساحيق. وعليه فإن الديمقراطية الاشتراكية وفق منظري الحركة الشيوعية، هي المؤهلة لخلق الشروط الاجتماعية والسياسية والثقافية والتنظيمية لتطور المجتمعات البشرية. لكن وقائع ومعطيات المجتمع الدولاني الاشتراكي وتجاربه في أكثر من بلد ومجموعة دول، أكد فشله الذريع، وكشف عن عقم وارتداد فظيع إلى أكثر النظم الاجتماعية استبدادا. وأخضعت الأحزاب الشيوعية المجتمعات الاشتراكية لحالة انغلاق غير مسبوقة تحت يافطة "ديكتاتورية البروليتاريا"، (المرحلة الانتقالية بين الاشتراكية والشيوعية)، التي قضت عمليا ونظريا على أي أفق لبناء صرح أي شكل من أشكال الديمقراطية، وكانت أحد أهم عوامل والهدم وانهيار الغالبية الساحقة من تلك الأنظمة. ومن بقي منها إما ما زال يعيش عملية قهر وقمع امتداداً للمرحلة التاريخية السابقة، أو حتى أسوأ منها، كون بعضها يخضع للنظم الوراثية الأكثر ظلامية، والأكثر استبدادية.
وإن كان هناك من ملمح إيجابي شهدته الأنظمة الشيوعية في مرحلة ما بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، فإن العين تتجه نحو النظام الصيني، الذي زاوج بين روح النظام الشيوعي وبين الخصخصة الرأسمالية، ما عاظم من قدرة ومكانة الصين الشعبية في الاقتصاد العالمي، حتى باتت ثاني اقتصاد في العالم، إن لم تكن الأولى اقتصاديا. ولكن لمحاكمة التجربة الصينية يتطلب الأمر دراستها دراسة عميقة، ومن داخل الصين قبل إعطاء التقييم النهائي. لا سيما ان الصين تفتقد لحرية إنشاء وتأسيس الأحزاب، ولا تسمح بحرية الفكر والتعبير السياسي، وهناك قيود شتى تطوق المجتمع الصيني تحول دون ترسخ جذور الديمقراطية الحقة.





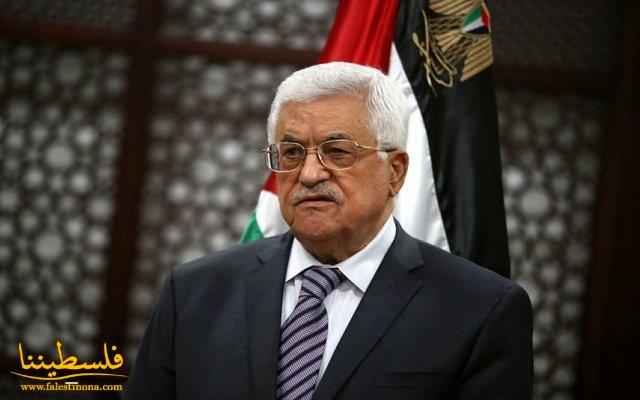



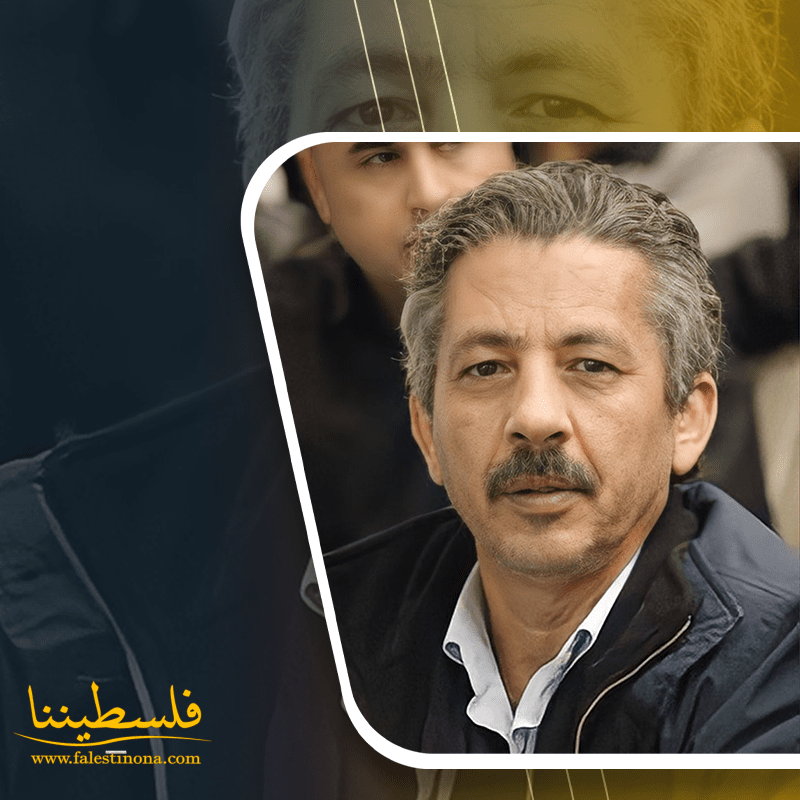
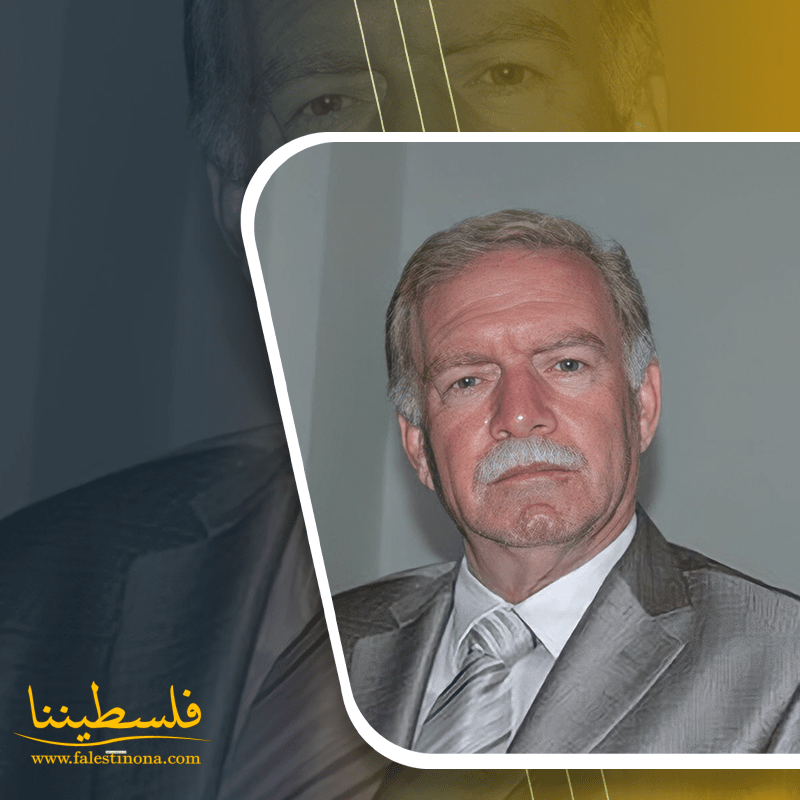





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها