خاص/ مفوضية الاعلام والثقافة-لبنان طريق الغد العربي معبدة بالأسئلة، البسيط منها والمركب. معبَّدة بالمحاذير وبالتناقضات، بآمال الكثيرين وتوجس الكثيرين أيضاً. فالأحزاب القومية، التي مارست السلطة، آتية من فيالق الجيوش والعسكر، تواجهت مع القوى الإسلامية في سياق ممارستها السلطة، واستطاعت إقصاءهم عن واجهة الحياة السياسية. أخوان مصر مثلاً، أبكروا في الاصطدام بثورة الضباط الأحرار التي استولت على الحكم في العام 1952. فيما سبق ومارسوا الاغتيال السياسي لرئيسي حكومة في 1945 والعام 1949. كما مارسوا العنف المسلح في مصر أيضاً. حماس في غزة جزء أصيل من حركة الأخوان، ويبدو أنها الوحدة التي مارست السلطة، ومن خلال شرعية برلمانية ملتبسة، جعلت منها عباءة لانقلاب دموي مشؤوم، مارست خلاله أبشع وأشنع ما يتصوره عقل، جرى في سياقه أكثر من اصطدام عنيف بأفراد وجماعات تشبعت من فكرها وثقافتها، دون أن تراعي الفارق بين ملكية حماس في السلطة ومسلكيتها خلال تجييشها لجماهيرها وهي خارجها. كذلك فإن من واجبنا التذكير بالخطاب الانفعالي بنبرته التكفيرية والتخوينية الذي دأبت عليه حماس طوال الفترة الماضية، والمصحوب بالقمع اللامتناهي ومحاولة إسقاط ثقافتها السياسية والدينية على مجتمع قطاع غزة وبواسطة الهراوة وما يسمى "القانون" أيضاً. الجديد الآن هو الحراك الشعبي العربي، الذي نجح في التغيير بموقعين، أحدهما في مصر المتصلة جغرافيا بقطاع غزة، والمتصلة سياسياً ووجدانيا بالقضية الفلسطينية، والمتصلة أيضاً ثقافياً بين قطبي الجماعة في كل من مصر والقطاع. على جهة العلاقات العربية، حصلت تغيرات وانزياحات عميقة على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، مما أسقط حماس في دائرة الخيارات الإجبارية. مثل أن تبقى مع جبهة الممانعة والمقاومة أو أن تذهب إلى حيث أفتى القرضاوي. حماس لا تستطيع الحياد، كونها جزءاً من مؤسسة ذات امتدادات قطرية، وتخضع لهرم قيادي متعدد الأصول والجذور. يجب أن لا ننسى صراع الأخوان في الأردن الذي اختتم بالفصل ما بين جناحي فلسطين والمملكة، والذي جرى بموجبه تحديد ما للأردن للأردن وما لفلسطين لفلسطين، بحجة خوف تيار الأردن من ذوبان هويته في القضية الفلسطينية بعد أن اتهم جهاراً بتعويم ثقافته السياسية. حركة حماس الآن، ورغم توقيعها ورقة إنهاء الانقسام، لم تزل تمسك العصا من الوسط، وتتأرجح بين خياري الوحدة وعدمها، متماشية مع سياق ما يحصل من حراك، وما يحصل من إعاقات لمشاريع التغيير، خاصة غير المتبلورة شعبياً بعد، مما يمنح حماس مساحة أوسع على المناورة وعدم التعجل في الخيارات. بمعنى آخر، عندما تحال مسألة الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يبقى الواقع على ما هو عليه من وجود لمرجعيتين. وعندما يتم الاختلاف- ولو تكتيكياً- على اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعندما توافق حماس على وجوب اختيار رئيس حكومة قادر على تنمية العلاقات الفلسطينية في المديين الإقليمي والدولي، وتوافق على منح فرضية مفاوضات السلام سنة أخرى، فإننا نجد ذلك الانسجام العميق بين سياق الوحدة الفلسطينية مع سياق الواقع العربي المتحرك. حماس الآن في صميم واقع مركب على تناقضين جوهريين، يرتبط الأول بالتقادم الفكري الذي بني على نموذج يشبه ثلاثينيات القرن الماضي، فيما التناقض الثاني يصطدم بعقبة التحديث ومقتضيات القرن الواحد والعشرين المشرَّع على تنوع الثقافات وتداخلها. وإذا كانت الجماعة ترى في ممارسة السلطات العربية الاضطهاد بحقها جواز عبور إلى خلافتها وسبباً كافياً ووحيداً لذلك، فإنها مخطئة جداً، خاصة حين نشهد الطلاق الواضح بين جماعة الإخوان وشباب الثورة في مصر، مرتدة إلى التحالف مع بقايا النظام السابق، كرافعة لها إلى الدخول في سلطة العهد المصري الجديد. ومع ذلك، فإن أزمة معبر رفح التي افتعلتها حماس مع المرجعيات المصرية، هي نتاج محاولة منها تكريس نفسها مرجعية وحيدة لشأن القطاع وللعلاقة المصرية معه، مستغلة حاجات الناس إلى التنقل وإلى الإمداد بالحاجات اليومية، مما يدل على خطأ في قراءة الواقع المصري الجديد الذي احتضن ميلاد ورقة إنهاء الانقسام وواكب ولم يزل آليات الحوار الفلسطيني حول تنفيذه، وعلى خطأ آخر مرتبط بخطاب ما بعد الثورة بالنسبة لموقع مصر الجديد في القضية الفلسطينية وبوتيرة العلاقات المصرية- الإسرائيلية، متناسبة حجم وسيادة وخصوصية مصر في هذه المرحلة الانتقالية والمتحركة، والدليل على ارتكابها الخطأ بحق العلاقات المصرية- الفلسطينية بقاء قيادة الأخوان في مصر بعيدة عن التجاذبات التي تبادلها المعنيون بأزمة المعبر، وبكون خطاب الأخوان المصريين الآن بدأ يختلف عن خطابهم ما قبل ثورة الشباب المصري. انطلاقاً مما سبق، هل تستطيع حماس التقدم بحزم في معالجة حيثيات المصالحة وترسيخها بالشكل الذي يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته؟ لا يبدو ذلك واضحاً حتى الآن، لأسباب بنيوية وسياسية. في البنيوي لا يبدو أنها قادرة حالياً للتماثل مع النموذج التركي. ولا يبدو أن النموذج المصري استقر على منظور محدد يصلح كنموذج تعمل حماس وفق موجباته. ولا يبدو أنها تستطيع بسط قبضتها المشدودة على أعناق أهل قطاع غزة تماهياً مع ما يجري في المحيط العربي، كون ذلك يصطدم حتماً بمنهجها الثقافي الداعي إلى إسقاط حالتها على المجتمع الغزي. ولا يبدو أنها أقلعت عن المساومة مع المجتمع الدولي من أجل شرعنة وجودها مقابل تنازلات على المستويين الفكري والسياسي. بالمقابل فإنه، باستثناء استحقاق أيلول، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن عجلة تكريس إنهاء الانقسام في الضفة، وبناءً على أدبيات وممارسات حركة فتح، تسير على نحو إيجابي حاسم. فالمسألة خالية من التكتيك، رغم الجاذب والاختلاف في المواقف حول النقاط ذات الصلة. وهي متسقة ومنسجمة مع خطاب ومواقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي سبقت توقيع الورقة المصرية بزمن بعيد. ومع أن شخص رئيس الحكومة الفلسطينية أخذ مساحة كبرى من الحوار بين فتح وحماس، سرد ذلك- ومن وجهة نظر حركة فتح- إلى ضرورة أن يمثل رئيس حكومة التوافق الوطني حالة تقاطع للمصلحة الوطنية، في الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، ويحظى بالميثاقية الشعبية الدولية، بحيث لا يشكل عبئاً على التواصل مع العالم ويسهم في مسألة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بدور إيجابي وفاعل. وإذا كان اعتراض حماس على شخص الدكتور سلام فياض الذي رغب الرئيس محمود عباس ببقائه، نظراً لاعتباره طرفا في معادلة الصراع بين حماس وفتح، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. لأن الدكتور فياض شخصية مستقلة، يرأس حكومة مستقلة، ولديه مشروع مستقل وخاص، ومتعارض أيضاً مع مشروع حركة فتح في مفصل التفاوض والنضال الوطني، حتى لو اعتبر أن مرجعيته السياسية تتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية. وبناء على ما سبق، فإن الرئيس محمود عباس، الذي وافق على استبدال الدكتور فياض بشخصية وطنية أخرى، كان ينطلق من فائدة وجود رئيس الحكومة على المصلحة العامة، قبل الفصائلية، ومن تمرسه المهني والدبلوماسي في المرحلة الراهنة. من هنا، يتضح الفارق بين ديناميتين فلسطينيتين. دينامية حماس التي لم تبرح الإصرار على استكمال مشروعها الأصلي، خوفاً على وحدتها الداخلية، وطمعاً بتبلور واقع عربي يمنحها المزيد من المكتسبات الفئوية. ودينامية فتح والمنظمة، اللتان يختصرهما الرئيس محمود عباس، غير الخائف من الحراك والنشاط الشعبي والجماهيري الفلسطيني، وغير المتردد في السير على طريق إنهاء الانقسام رغم السلبية الأميركية والصلف الصهيوني الذي يمثله ثنائي نتنياهو- ليبرمان. نحن الآن أمام شاشة فلسطينية محددة وواضحة المعالم والملامح، تعكس نموذجين من الطموحات والنوايا. نموذج حماس هنا لم يحسم خياره الوحدوي بعد، بانتظار ركود ترددات الواقع العربي، ونموذج الرئيس محمود عباس، الذي يماهي بين التمنيات والرغبات الشعبية والأولويات السياسية والإستراتيجية لمنظمة التحرير وحركة فتح- أي أنه يتصرف على أساس أن مصلحة الشعب أكبر من الأطر الحزبية والفصائلية. | |
خاص/ مفوضية الاعلام والثقافة-لبنان طريق الغد العربي معبدة بالأسئلة، البسيط منها والمركب. معبَّدة بالمحاذير وبالتناقضات، بآمال الكثيرين وتوجس الكثيرين أيضاً. فالأحزاب القومية، التي مارست السلطة، آتية من فيالق الجيوش والعسكر، تواجهت مع القوى الإسلامية في سياق ممارستها السلطة، واستطاعت إقصاءهم عن واجهة الحياة السياسية. أخوان مصر مثلاً، أبكروا في الاصطدام بثورة الضباط الأحرار التي استولت على الحكم في العام 1952. فيما سبق ومارسوا الاغتيال السياسي لرئيسي حكومة في 1945 والعام 1949. كما مارسوا العنف المسلح في مصر أيضاً. حماس في غزة جزء أصيل من حركة الأخوان، ويبدو أنها الوحدة التي مارست السلطة، ومن خلال شرعية برلمانية ملتبسة، جعلت منها عباءة لانقلاب دموي مشؤوم، مارست خلاله أبشع وأشنع ما يتصوره عقل، جرى في سياقه أكثر من اصطدام عنيف بأفراد وجماعات تشبعت من فكرها وثقافتها، دون أن تراعي الفارق بين ملكية حماس في السلطة ومسلكيتها خلال تجييشها لجماهيرها وهي خارجها. كذلك فإن من واجبنا التذكير بالخطاب الانفعالي بنبرته التكفيرية والتخوينية الذي دأبت عليه حماس طوال الفترة الماضية، والمصحوب بالقمع اللامتناهي ومحاولة إسقاط ثقافتها السياسية والدينية على مجتمع قطاع غزة وبواسطة الهراوة وما يسمى "القانون" أيضاً. الجديد الآن هو الحراك الشعبي العربي، الذي نجح في التغيير بموقعين، أحدهما في مصر المتصلة جغرافيا بقطاع غزة، والمتصلة سياسياً ووجدانيا بالقضية الفلسطينية، والمتصلة أيضاً ثقافياً بين قطبي الجماعة في كل من مصر والقطاع. على جهة العلاقات العربية، حصلت تغيرات وانزياحات عميقة على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، مما أسقط حماس في دائرة الخيارات الإجبارية. مثل أن تبقى مع جبهة الممانعة والمقاومة أو أن تذهب إلى حيث أفتى القرضاوي. حماس لا تستطيع الحياد، كونها جزءاً من مؤسسة ذات امتدادات قطرية، وتخضع لهرم قيادي متعدد الأصول والجذور. يجب أن لا ننسى صراع الأخوان في الأردن الذي اختتم بالفصل ما بين جناحي فلسطين والمملكة، والذي جرى بموجبه تحديد ما للأردن للأردن وما لفلسطين لفلسطين، بحجة خوف تيار الأردن من ذوبان هويته في القضية الفلسطينية بعد أن اتهم جهاراً بتعويم ثقافته السياسية. حركة حماس الآن، ورغم توقيعها ورقة إنهاء الانقسام، لم تزل تمسك العصا من الوسط، وتتأرجح بين خياري الوحدة وعدمها، متماشية مع سياق ما يحصل من حراك، وما يحصل من إعاقات لمشاريع التغيير، خاصة غير المتبلورة شعبياً بعد، مما يمنح حماس مساحة أوسع على المناورة وعدم التعجل في الخيارات. بمعنى آخر، عندما تحال مسألة الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يبقى الواقع على ما هو عليه من وجود لمرجعيتين. وعندما يتم الاختلاف- ولو تكتيكياً- على اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعندما توافق حماس على وجوب اختيار رئيس حكومة قادر على تنمية العلاقات الفلسطينية في المديين الإقليمي والدولي، وتوافق على منح فرضية مفاوضات السلام سنة أخرى، فإننا نجد ذلك الانسجام العميق بين سياق الوحدة الفلسطينية مع سياق الواقع العربي المتحرك. حماس الآن في صميم واقع مركب على تناقضين جوهريين، يرتبط الأول بالتقادم الفكري الذي بني على نموذج يشبه ثلاثينيات القرن الماضي، فيما التناقض الثاني يصطدم بعقبة التحديث ومقتضيات القرن الواحد والعشرين المشرَّع على تنوع الثقافات وتداخلها. وإذا كانت الجماعة ترى في ممارسة السلطات العربية الاضطهاد بحقها جواز عبور إلى خلافتها وسبباً كافياً ووحيداً لذلك، فإنها مخطئة جداً، خاصة حين نشهد الطلاق الواضح بين جماعة الإخوان وشباب الثورة في مصر، مرتدة إلى التحالف مع بقايا النظام السابق، كرافعة لها إلى الدخول في سلطة العهد المصري الجديد. ومع ذلك، فإن أزمة معبر رفح التي افتعلتها حماس مع المرجعيات المصرية، هي نتاج محاولة منها تكريس نفسها مرجعية وحيدة لشأن القطاع وللعلاقة المصرية معه، مستغلة حاجات الناس إلى التنقل وإلى الإمداد بالحاجات اليومية، مما يدل على خطأ في قراءة الواقع المصري الجديد الذي احتضن ميلاد ورقة إنهاء الانقسام وواكب ولم يزل آليات الحوار الفلسطيني حول تنفيذه، وعلى خطأ آخر مرتبط بخطاب ما بعد الثورة بالنسبة لموقع مصر الجديد في القضية الفلسطينية وبوتيرة العلاقات المصرية- الإسرائيلية، متناسبة حجم وسيادة وخصوصية مصر في هذه المرحلة الانتقالية والمتحركة، والدليل على ارتكابها الخطأ بحق العلاقات المصرية- الفلسطينية بقاء قيادة الأخوان في مصر بعيدة عن التجاذبات التي تبادلها المعنيون بأزمة المعبر، وبكون خطاب الأخوان المصريين الآن بدأ يختلف عن خطابهم ما قبل ثورة الشباب المصري. انطلاقاً مما سبق، هل تستطيع حماس التقدم بحزم في معالجة حيثيات المصالحة وترسيخها بالشكل الذي يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته؟ لا يبدو ذلك واضحاً حتى الآن، لأسباب بنيوية وسياسية. في البنيوي لا يبدو أنها قادرة حالياً للتماثل مع النموذج التركي. ولا يبدو أن النموذج المصري استقر على منظور محدد يصلح كنموذج تعمل حماس وفق موجباته. ولا يبدو أنها تستطيع بسط قبضتها المشدودة على أعناق أهل قطاع غزة تماهياً مع ما يجري في المحيط العربي، كون ذلك يصطدم حتماً بمنهجها الثقافي الداعي إلى إسقاط حالتها على المجتمع الغزي. ولا يبدو أنها أقلعت عن المساومة مع المجتمع الدولي من أجل شرعنة وجودها مقابل تنازلات على المستويين الفكري والسياسي. بالمقابل فإنه، باستثناء استحقاق أيلول، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن عجلة تكريس إنهاء الانقسام في الضفة، وبناءً على أدبيات وممارسات حركة فتح، تسير على نحو إيجابي حاسم. فالمسألة خالية من التكتيك، رغم الجاذب والاختلاف في المواقف حول النقاط ذات الصلة. وهي متسقة ومنسجمة مع خطاب ومواقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي سبقت توقيع الورقة المصرية بزمن بعيد. ومع أن شخص رئيس الحكومة الفلسطينية أخذ مساحة كبرى من الحوار بين فتح وحماس، سرد ذلك- ومن وجهة نظر حركة فتح- إلى ضرورة أن يمثل رئيس حكومة التوافق الوطني حالة تقاطع للمصلحة الوطنية، في الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، ويحظى بالميثاقية الشعبية الدولية، بحيث لا يشكل عبئاً على التواصل مع العالم ويسهم في مسألة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بدور إيجابي وفاعل. وإذا كان اعتراض حماس على شخص الدكتور سلام فياض الذي رغب الرئيس محمود عباس ببقائه، نظراً لاعتباره طرفا في معادلة الصراع بين حماس وفتح، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. لأن الدكتور فياض شخصية مستقلة، يرأس حكومة مستقلة، ولديه مشروع مستقل وخاص، ومتعارض أيضاً مع مشروع حركة فتح في مفصل التفاوض والنضال الوطني، حتى لو اعتبر أن مرجعيته السياسية تتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية. وبناء على ما سبق، فإن الرئيس محمود عباس، الذي وافق على استبدال الدكتور فياض بشخصية وطنية أخرى، كان ينطلق من فائدة وجود رئيس الحكومة على المصلحة العامة، قبل الفصائلية، ومن تمرسه المهني والدبلوماسي في المرحلة الراهنة. من هنا، يتضح الفارق بين ديناميتين فلسطينيتين. دينامية حماس التي لم تبرح الإصرار على استكمال مشروعها الأصلي، خوفاً على وحدتها الداخلية، وطمعاً بتبلور واقع عربي يمنحها المزيد من المكتسبات الفئوية. ودينامية فتح والمنظمة، اللتان يختصرهما الرئيس محمود عباس، غير الخائف من الحراك والنشاط الشعبي والجماهيري الفلسطيني، وغير المتردد في السير على طريق إنهاء الانقسام رغم السلبية الأميركية والصلف الصهيوني الذي يمثله ثنائي نتنياهو- ليبرمان. نحن الآن أمام شاشة فلسطينية محددة وواضحة المعالم والملامح، تعكس نموذجين من الطموحات والنوايا. نموذج حماس هنا لم يحسم خياره الوحدوي بعد، بانتظار ركود ترددات الواقع العربي، ونموذج الرئيس محمود عباس، الذي يماهي بين التمنيات والرغبات الشعبية والأولويات السياسية والإستراتيجية لمنظمة التحرير وحركة فتح- أي أنه يتصرف على أساس أن مصلحة الشعب أكبر من الأطر الحزبية والفصائلية. | |
خاص/ مفوضية الاعلام والثقافة-لبنان طريق الغد العربي معبدة بالأسئلة، البسيط منها والمركب. معبَّدة بالمحاذير وبالتناقضات، بآمال الكثيرين وتوجس الكثيرين أيضاً. فالأحزاب القومية، التي مارست السلطة، آتية من فيالق الجيوش والعسكر، تواجهت مع القوى الإسلامية في سياق ممارستها السلطة، واستطاعت إقصاءهم عن واجهة الحياة السياسية. أخوان مصر مثلاً، أبكروا في الاصطدام بثورة الضباط الأحرار التي استولت على الحكم في العام 1952. فيما سبق ومارسوا الاغتيال السياسي لرئيسي حكومة في 1945 والعام 1949. كما مارسوا العنف المسلح في مصر أيضاً. حماس في غزة جزء أصيل من حركة الأخوان، ويبدو أنها الوحدة التي مارست السلطة، ومن خلال شرعية برلمانية ملتبسة، جعلت منها عباءة لانقلاب دموي مشؤوم، مارست خلاله أبشع وأشنع ما يتصوره عقل، جرى في سياقه أكثر من اصطدام عنيف بأفراد وجماعات تشبعت من فكرها وثقافتها، دون أن تراعي الفارق بين ملكية حماس في السلطة ومسلكيتها خلال تجييشها لجماهيرها وهي خارجها. كذلك فإن من واجبنا التذكير بالخطاب الانفعالي بنبرته التكفيرية والتخوينية الذي دأبت عليه حماس طوال الفترة الماضية، والمصحوب بالقمع اللامتناهي ومحاولة إسقاط ثقافتها السياسية والدينية على مجتمع قطاع غزة وبواسطة الهراوة وما يسمى "القانون" أيضاً. الجديد الآن هو الحراك الشعبي العربي، الذي نجح في التغيير بموقعين، أحدهما في مصر المتصلة جغرافيا بقطاع غزة، والمتصلة سياسياً ووجدانيا بالقضية الفلسطينية، والمتصلة أيضاً ثقافياً بين قطبي الجماعة في كل من مصر والقطاع. على جهة العلاقات العربية، حصلت تغيرات وانزياحات عميقة على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، مما أسقط حماس في دائرة الخيارات الإجبارية. مثل أن تبقى مع جبهة الممانعة والمقاومة أو أن تذهب إلى حيث أفتى القرضاوي. حماس لا تستطيع الحياد، كونها جزءاً من مؤسسة ذات امتدادات قطرية، وتخضع لهرم قيادي متعدد الأصول والجذور. يجب أن لا ننسى صراع الأخوان في الأردن الذي اختتم بالفصل ما بين جناحي فلسطين والمملكة، والذي جرى بموجبه تحديد ما للأردن للأردن وما لفلسطين لفلسطين، بحجة خوف تيار الأردن من ذوبان هويته في القضية الفلسطينية بعد أن اتهم جهاراً بتعويم ثقافته السياسية. حركة حماس الآن، ورغم توقيعها ورقة إنهاء الانقسام، لم تزل تمسك العصا من الوسط، وتتأرجح بين خياري الوحدة وعدمها، متماشية مع سياق ما يحصل من حراك، وما يحصل من إعاقات لمشاريع التغيير، خاصة غير المتبلورة شعبياً بعد، مما يمنح حماس مساحة أوسع على المناورة وعدم التعجل في الخيارات. بمعنى آخر، عندما تحال مسألة الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يبقى الواقع على ما هو عليه من وجود لمرجعيتين. وعندما يتم الاختلاف- ولو تكتيكياً- على اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعندما توافق حماس على وجوب اختيار رئيس حكومة قادر على تنمية العلاقات الفلسطينية في المديين الإقليمي والدولي، وتوافق على منح فرضية مفاوضات السلام سنة أخرى، فإننا نجد ذلك الانسجام العميق بين سياق الوحدة الفلسطينية مع سياق الواقع العربي المتحرك. حماس الآن في صميم واقع مركب على تناقضين جوهريين، يرتبط الأول بالتقادم الفكري الذي بني على نموذج يشبه ثلاثينيات القرن الماضي، فيما التناقض الثاني يصطدم بعقبة التحديث ومقتضيات القرن الواحد والعشرين المشرَّع على تنوع الثقافات وتداخلها. وإذا كانت الجماعة ترى في ممارسة السلطات العربية الاضطهاد بحقها جواز عبور إلى خلافتها وسبباً كافياً ووحيداً لذلك، فإنها مخطئة جداً، خاصة حين نشهد الطلاق الواضح بين جماعة الإخوان وشباب الثورة في مصر، مرتدة إلى التحالف مع بقايا النظام السابق، كرافعة لها إلى الدخول في سلطة العهد المصري الجديد. ومع ذلك، فإن أزمة معبر رفح التي افتعلتها حماس مع المرجعيات المصرية، هي نتاج محاولة منها تكريس نفسها مرجعية وحيدة لشأن القطاع وللعلاقة المصرية معه، مستغلة حاجات الناس إلى التنقل وإلى الإمداد بالحاجات اليومية، مما يدل على خطأ في قراءة الواقع المصري الجديد الذي احتضن ميلاد ورقة إنهاء الانقسام وواكب ولم يزل آليات الحوار الفلسطيني حول تنفيذه، وعلى خطأ آخر مرتبط بخطاب ما بعد الثورة بالنسبة لموقع مصر الجديد في القضية الفلسطينية وبوتيرة العلاقات المصرية- الإسرائيلية، متناسبة حجم وسيادة وخصوصية مصر في هذه المرحلة الانتقالية والمتحركة، والدليل على ارتكابها الخطأ بحق العلاقات المصرية- الفلسطينية بقاء قيادة الأخوان في مصر بعيدة عن التجاذبات التي تبادلها المعنيون بأزمة المعبر، وبكون خطاب الأخوان المصريين الآن بدأ يختلف عن خطابهم ما قبل ثورة الشباب المصري. انطلاقاً مما سبق، هل تستطيع حماس التقدم بحزم في معالجة حيثيات المصالحة وترسيخها بالشكل الذي يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته؟ لا يبدو ذلك واضحاً حتى الآن، لأسباب بنيوية وسياسية. في البنيوي لا يبدو أنها قادرة حالياً للتماثل مع النموذج التركي. ولا يبدو أن النموذج المصري استقر على منظور محدد يصلح كنموذج تعمل حماس وفق موجباته. ولا يبدو أنها تستطيع بسط قبضتها المشدودة على أعناق أهل قطاع غزة تماهياً مع ما يجري في المحيط العربي، كون ذلك يصطدم حتماً بمنهجها الثقافي الداعي إلى إسقاط حالتها على المجتمع الغزي. ولا يبدو أنها أقلعت عن المساومة مع المجتمع الدولي من أجل شرعنة وجودها مقابل تنازلات على المستويين الفكري والسياسي. بالمقابل فإنه، باستثناء استحقاق أيلول، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن عجلة تكريس إنهاء الانقسام في الضفة، وبناءً على أدبيات وممارسات حركة فتح، تسير على نحو إيجابي حاسم. فالمسألة خالية من التكتيك، رغم الجاذب والاختلاف في المواقف حول النقاط ذات الصلة. وهي متسقة ومنسجمة مع خطاب ومواقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي سبقت توقيع الورقة المصرية بزمن بعيد. ومع أن شخص رئيس الحكومة الفلسطينية أخذ مساحة كبرى من الحوار بين فتح وحماس، سرد ذلك- ومن وجهة نظر حركة فتح- إلى ضرورة أن يمثل رئيس حكومة التوافق الوطني حالة تقاطع للمصلحة الوطنية، في الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، ويحظى بالميثاقية الشعبية الدولية، بحيث لا يشكل عبئاً على التواصل مع العالم ويسهم في مسألة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بدور إيجابي وفاعل. وإذا كان اعتراض حماس على شخص الدكتور سلام فياض الذي رغب الرئيس محمود عباس ببقائه، نظراً لاعتباره طرفا في معادلة الصراع بين حماس وفتح، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. لأن الدكتور فياض شخصية مستقلة، يرأس حكومة مستقلة، ولديه مشروع مستقل وخاص، ومتعارض أيضاً مع مشروع حركة فتح في مفصل التفاوض والنضال الوطني، حتى لو اعتبر أن مرجعيته السياسية تتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية. وبناء على ما سبق، فإن الرئيس محمود عباس، الذي وافق على استبدال الدكتور فياض بشخصية وطنية أخرى، كان ينطلق من فائدة وجود رئيس الحكومة على المصلحة العامة، قبل الفصائلية، ومن تمرسه المهني والدبلوماسي في المرحلة الراهنة. من هنا، يتضح الفارق بين ديناميتين فلسطينيتين. دينامية حماس التي لم تبرح الإصرار على استكمال مشروعها الأصلي، خوفاً على وحدتها الداخلية، وطمعاً بتبلور واقع عربي يمنحها المزيد من المكتسبات الفئوية. ودينامية فتح والمنظمة، اللتان يختصرهما الرئيس محمود عباس، غير الخائف من الحراك والنشاط الشعبي والجماهيري الفلسطيني، وغير المتردد في السير على طريق إنهاء الانقسام رغم السلبية الأميركية والصلف الصهيوني الذي يمثله ثنائي نتنياهو- ليبرمان. نحن الآن أمام شاشة فلسطينية محددة وواضحة المعالم والملامح، تعكس نموذجين من الطموحات والنوايا. نموذج حماس هنا لم يحسم خياره الوحدوي بعد، بانتظار ركود ترددات الواقع العربي، ونموذج الرئيس محمود عباس، الذي يماهي بين التمنيات والرغبات الشعبية والأولويات السياسية والإستراتيجية لمنظمة التحرير وحركة فتح- أي أنه يتصرف على أساس أن مصلحة الشعب أكبر من الأطر الحزبية والفصائلية. | |
خاص/ مفوضية الاعلام والثقافة-لبنان
طريق الغد العربي معبدة بالأسئلة، البسيط منها والمركب. معبَّدة بالمحاذير وبالتناقضات، بآمال الكثيرين وتوجس الكثيرين أيضاً.
فالأحزاب القومية، التي مارست السلطة، آتية من فيالق الجيوش والعسكر، تواجهت مع القوى الإسلامية في سياق ممارستها السلطة، واستطاعت إقصاءهم عن واجهة الحياة السياسية.
أخوان مصر مثلاً، أبكروا في الاصطدام بثورة الضباط الأحرار التي استولت على الحكم في العام 1952. فيما سبق ومارسوا الاغتيال السياسي لرئيسي حكومة في 1945 والعام 1949. كما مارسوا العنف المسلح في مصر أيضاً.
حماس في غزة جزء أصيل من حركة الأخوان، ويبدو أنها الوحدة التي مارست السلطة، ومن خلال شرعية برلمانية ملتبسة، جعلت منها عباءة لانقلاب دموي مشؤوم، مارست خلاله أبشع وأشنع ما يتصوره عقل، جرى في سياقه أكثر من اصطدام عنيف بأفراد وجماعات تشبعت من فكرها وثقافتها، دون أن تراعي الفارق بين ملكية حماس في السلطة ومسلكيتها خلال تجييشها لجماهيرها وهي خارجها.
كذلك فإن من واجبنا التذكير بالخطاب الانفعالي بنبرته التكفيرية والتخوينية الذي دأبت عليه حماس طوال الفترة الماضية، والمصحوب بالقمع اللامتناهي ومحاولة إسقاط ثقافتها السياسية والدينية على مجتمع قطاع غزة وبواسطة الهراوة وما يسمى "القانون" أيضاً.
الجديد الآن هو الحراك الشعبي العربي، الذي نجح في التغيير بموقعين، أحدهما في مصر المتصلة جغرافيا بقطاع غزة، والمتصلة سياسياً ووجدانيا بالقضية الفلسطينية، والمتصلة أيضاً ثقافياً بين قطبي الجماعة في كل من مصر والقطاع.
على جهة العلاقات العربية، حصلت تغيرات وانزياحات عميقة على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، مما أسقط حماس في دائرة الخيارات الإجبارية. مثل أن تبقى مع جبهة الممانعة والمقاومة أو أن تذهب إلى حيث أفتى القرضاوي. حماس لا تستطيع الحياد، كونها جزءاً من مؤسسة ذات امتدادات قطرية، وتخضع لهرم قيادي متعدد الأصول والجذور.
يجب أن لا ننسى صراع الأخوان في الأردن الذي اختتم بالفصل ما بين جناحي فلسطين والمملكة، والذي جرى بموجبه تحديد ما للأردن للأردن وما لفلسطين لفلسطين، بحجة خوف تيار الأردن من ذوبان هويته في القضية الفلسطينية بعد أن اتهم جهاراً بتعويم ثقافته السياسية.
حركة حماس الآن، ورغم توقيعها ورقة إنهاء الانقسام، لم تزل تمسك العصا من الوسط، وتتأرجح بين خياري الوحدة وعدمها، متماشية مع سياق ما يحصل من حراك، وما يحصل من إعاقات لمشاريع التغيير، خاصة غير المتبلورة شعبياً بعد، مما يمنح حماس مساحة أوسع على المناورة وعدم التعجل في الخيارات.
بمعنى آخر، عندما تحال مسألة الأجهزة الأمنية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يبقى الواقع على ما هو عليه من وجود لمرجعيتين. وعندما يتم الاختلاف- ولو تكتيكياً- على اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعندما توافق حماس على وجوب اختيار رئيس حكومة قادر على تنمية العلاقات الفلسطينية في المديين الإقليمي والدولي، وتوافق على منح فرضية مفاوضات السلام سنة أخرى، فإننا نجد ذلك الانسجام العميق بين سياق الوحدة الفلسطينية مع سياق الواقع العربي المتحرك.
حماس الآن في صميم واقع مركب على تناقضين جوهريين، يرتبط الأول بالتقادم الفكري الذي بني على نموذج يشبه ثلاثينيات القرن الماضي، فيما التناقض الثاني يصطدم بعقبة التحديث ومقتضيات القرن الواحد والعشرين المشرَّع على تنوع الثقافات وتداخلها.
وإذا كانت الجماعة ترى في ممارسة السلطات العربية الاضطهاد بحقها جواز عبور إلى خلافتها وسبباً كافياً ووحيداً لذلك، فإنها مخطئة جداً، خاصة حين نشهد الطلاق الواضح بين جماعة الإخوان وشباب الثورة في مصر، مرتدة إلى التحالف مع بقايا النظام السابق، كرافعة لها إلى الدخول في سلطة العهد المصري الجديد.
ومع ذلك، فإن أزمة معبر رفح التي افتعلتها حماس مع المرجعيات المصرية، هي نتاج محاولة منها تكريس نفسها مرجعية وحيدة لشأن القطاع وللعلاقة المصرية معه، مستغلة حاجات الناس إلى التنقل وإلى الإمداد بالحاجات اليومية، مما يدل على خطأ في قراءة الواقع المصري الجديد الذي احتضن ميلاد ورقة إنهاء الانقسام وواكب ولم يزل آليات الحوار الفلسطيني حول تنفيذه، وعلى خطأ آخر مرتبط بخطاب ما بعد الثورة بالنسبة لموقع مصر الجديد في القضية الفلسطينية وبوتيرة العلاقات المصرية- الإسرائيلية، متناسبة حجم وسيادة وخصوصية مصر في هذه المرحلة الانتقالية والمتحركة، والدليل على ارتكابها الخطأ بحق العلاقات المصرية- الفلسطينية بقاء قيادة الأخوان في مصر بعيدة عن التجاذبات التي تبادلها المعنيون بأزمة المعبر، وبكون خطاب الأخوان المصريين الآن بدأ يختلف عن خطابهم ما قبل ثورة الشباب المصري.
انطلاقاً مما سبق، هل تستطيع حماس التقدم بحزم في معالجة حيثيات المصالحة وترسيخها بالشكل الذي يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته؟
لا يبدو ذلك واضحاً حتى الآن، لأسباب بنيوية وسياسية. في البنيوي لا يبدو أنها قادرة حالياً للتماثل مع النموذج التركي. ولا يبدو أن النموذج المصري استقر على منظور محدد يصلح كنموذج تعمل حماس وفق موجباته. ولا يبدو أنها تستطيع بسط قبضتها المشدودة على أعناق أهل قطاع غزة تماهياً مع ما يجري في المحيط العربي، كون ذلك يصطدم حتماً بمنهجها الثقافي الداعي إلى إسقاط حالتها على المجتمع الغزي. ولا يبدو أنها أقلعت عن المساومة مع المجتمع الدولي من أجل شرعنة وجودها مقابل تنازلات على المستويين الفكري والسياسي.
بالمقابل فإنه، باستثناء استحقاق أيلول، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن عجلة تكريس إنهاء الانقسام في الضفة، وبناءً على أدبيات وممارسات حركة فتح، تسير على نحو إيجابي حاسم. فالمسألة خالية من التكتيك، رغم الجاذب والاختلاف في المواقف حول النقاط ذات الصلة. وهي متسقة ومنسجمة مع خطاب ومواقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي سبقت توقيع الورقة المصرية بزمن بعيد.
ومع أن شخص رئيس الحكومة الفلسطينية أخذ مساحة كبرى من الحوار بين فتح وحماس، سرد ذلك- ومن وجهة نظر حركة فتح- إلى ضرورة أن يمثل رئيس حكومة التوافق الوطني حالة تقاطع للمصلحة الوطنية، في الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، ويحظى بالميثاقية الشعبية الدولية، بحيث لا يشكل عبئاً على التواصل مع العالم ويسهم في مسألة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بدور إيجابي وفاعل.
وإذا كان اعتراض حماس على شخص الدكتور سلام فياض الذي رغب الرئيس محمود عباس ببقائه، نظراً لاعتباره طرفا في معادلة الصراع بين حماس وفتح، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. لأن الدكتور فياض شخصية مستقلة، يرأس حكومة مستقلة، ولديه مشروع مستقل وخاص، ومتعارض أيضاً مع مشروع حركة فتح في مفصل التفاوض والنضال الوطني، حتى لو اعتبر أن مرجعيته السياسية تتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية. وبناء على ما سبق، فإن الرئيس محمود عباس، الذي وافق على استبدال الدكتور فياض بشخصية وطنية أخرى، كان ينطلق من فائدة وجود رئيس الحكومة على المصلحة العامة، قبل الفصائلية، ومن تمرسه المهني والدبلوماسي في المرحلة الراهنة.
من هنا، يتضح الفارق بين ديناميتين فلسطينيتين. دينامية حماس التي لم تبرح الإصرار على استكمال مشروعها الأصلي، خوفاً على وحدتها الداخلية، وطمعاً بتبلور واقع عربي يمنحها المزيد من المكتسبات الفئوية. ودينامية فتح والمنظمة، اللتان يختصرهما الرئيس محمود عباس، غير الخائف من الحراك والنشاط الشعبي والجماهيري الفلسطيني، وغير المتردد في السير على طريق إنهاء الانقسام رغم السلبية الأميركية والصلف الصهيوني الذي يمثله ثنائي نتنياهو- ليبرمان.
نحن الآن أمام شاشة فلسطينية محددة وواضحة المعالم والملامح، تعكس نموذجين من الطموحات والنوايا. نموذج حماس هنا لم يحسم خياره الوحدوي بعد، بانتظار ركود ترددات الواقع العربي، ونموذج الرئيس محمود عباس، الذي يماهي بين التمنيات والرغبات الشعبية والأولويات السياسية والإستراتيجية لمنظمة التحرير وحركة فتح- أي أنه يتصرف على أساس أن مصلحة الشعب أكبر من الأطر الحزبية والفصائلية











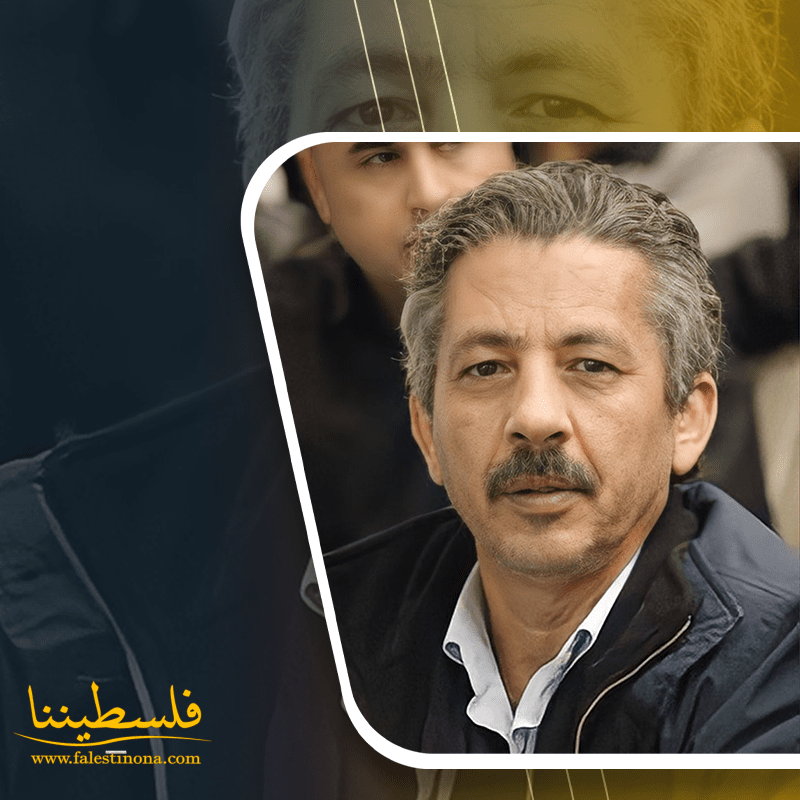




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها