رحم الله الذين قضوا في البحر، بأفاعيل فاعلين، أو ابتلعهم الموج ومن ثم الأسماك المتوحشة أو تكسرت بهم القوارب الرديئة التي تشبه زمنها العربي. فلا حُكم راسخاً ومحدداً، لدوافع الهجرة، لا في شروحات الدين ولا في اعتبارات الدنيا والوطن. الدين نفسه، يقول في الهجرة الشيء ونقيضه. وحتى من سورة «النساء» نفسها، يأخذ الشارحون منها، مستندين الى معطيات ناقصة، ما يجزم بُحرمة الهجرة، وآخرون يأخذون ما يؤكد على أن الهجرة في الظروف التي تدفع اليها، فريضة وواجباً. الأولون يقولون بحُرمة اللجوء الى بلاد الكافرين، باختزال تفسير الآية الكريمة من سورة النساء «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» والأخيرون يبررون الرحيل فيأخذون آية أخرى هي «ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا اليها». وأضاف الشارحون الى هذا السياق الأخير، قولاً عاطراً للرسول عليه السلام، يحدد فيه اشتراطات البقاء في الوطن، جاء فيه نصّاً وحرفاً: «من أصبح منكم آمناً في سِربه، مُعافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».
مسألة محيّرة في الحكم الديني، ومحيرة في مسالك الطريق الى المهجر، ومحيرة في عفونة الضالعين والسماسرة والربابنة، ومحيرة حيال الاختلاف المتعلق بمسألة شروط البقاء، وما اذا كانت أرضنا أرض رباط أو أرضاً يصعب فيها على الانسان أن يكون آمناً في سربه، معافى في بدنه أو متيسرة طبابته الشافية أو محصنّاً من القصف، ومتحصلاً على قوت يومه، لكي يحوز على مقومات العيش في دنياه!
كل شيء في حكاية المهاجرين له قراءتان أو ثلاث. فأخونا الشيخ القرضاوي، الذي يراه البعض مفتياً للصمود والصبر والمقاومة، يقول ان هذه الهجرة ليست مجرد مباحة، بل هي واجب على المسلم، اذا وجد أرضاً تسعه وتسع دينه، ويستطيع ان يحتفظ بها بدينه، على الأقل في الشعائر والأشياء الأساسية، فتتوجب عليه الهجرة. وربما استأنس السماسرة المرتشون في الحلقة الأولى من رحلة المهاجر (وهؤلاء متنفذون في هوامش حلقة الحكم في غزة)؛ بتفسير القرضاوي للآية، فقبضوا «الأتعاب» معتبرين أنفسهم يعينون المسلم على أداء واجب شرعي، مثلما تُعين مكاتب السفريات، المسلم على أداء الحج والعُمرة!
محتارون نحن ومحزونون. فالمأساة تُدمي القلب. وهناك راقصون على المصائر والدماء. أحدهم ممن يقدمون أنفسهم على شاشات التلفزة كمختصين في القانون وحقوق الانسان، طَلَع يقول ان «أبو مازن» يتحمل مسؤولية مركبة عن الموت في البحر. تذكرت قولاً طريفاً لأخي المرحوم الحاج أبو أنور أبو طير، الذي كان يرد باستفهام انكاري على كل من ينسب الى «أبو عمار» كل رزيّة أو واقعة مؤلمة: «من وراك.. يا حليمة». فلو سايرنا العيّار لباب الدار، سنفتش عن موضع للسلطة في سياق حلقات الاتجار بالبشر، وسنعجز فلا نعرف أين نضعها. هل هي التي أقامت منظومة اعتصار الناس عند فتحات الأنفاق وقبضت المعلوم، مثلما تقبض منظومة أخرى المعلوم من المسافر مقابل اعطائه أولوية للصعود الى الحافلة المتجهة الى الجانب المصري؟ أم هي الحاضرة على الجانب الآخر، مع منظومة الفاسدين الأوغاد الذين يقبضون من المهاجر لتأمين الوصول الى نقطة الابحار مروراً بسيناء. أم ان السلطة متعاقدة مع «أم سليم» السورية المقيمة في الاسكندرية، أو مع غيرها من مقاولي تهجير البشر عبر البحر؟ كأن السلطة، في الواقعة الأليمة الأخيرة، هي التي حركت أسطولها لضرب سفينة المهاجرين المتهالكة، فيقسمها الى نصفين ويُغرقها؟
ربما، قبل ذلك كله، تكون السلطة في خلفية المشهد، هي التي جعلت أراضي قطاع غزة منطقة منكوبة، لا أفق فيها للشباب، وهي التي، بعد كل نكبة، تتجاهل الركام والمآسي فتتحدث عن تحرير وشيك للأقصى، لعله يكون بعد أيام قليلة!
كأننا في زمن مجنون. الجنون هو الذي يغوي صاحبه ويجعله يثرثر بأي كلام دون أن يعتني بنفسه وبحياته وحياة سواه. ان شهداء البحر لم يُخطئوا. لقد ضاقت بهم الدنيا. حاولوا الوصول الى أرض أخرى، أخطأ المفسرون الرديئون في جعلها أرض كافرين. ففي أوروبا يصلي المسلم ويؤدي الفرائض بحرية ويخطب الخطيب ويهدر مطالباً بتحرير الأندلس ويأكل عن سعة. ان الكافرين الحقيقيين هم المارقون والسماسرة ومعتصرو الوطن، والفاسدون، والمقامرون بورقة الحياة وشروطها، وبائعو الكلام. فهؤلاء جميعاً هم قتلة الناس في البحر. وليست «أم سليم» أو سواها، الا عاملاً لوجستياً يلاعب الحائر لعبة خطرة، مقابل المال، فإما ينجو ويصل، أو يموت فيربح صلاة الغائب على روحه. لكن سماسرة الشاطئ، ليسوا قائمين على الحلقة الأولى من رحلات الموت!
السماسرة والشهداء في البحر/ بقلم عدلي صادق
22-09-2014
مشاهدة: 487
عدلي صادق





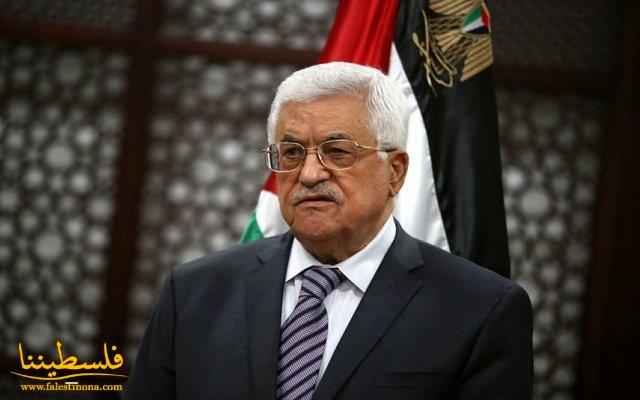



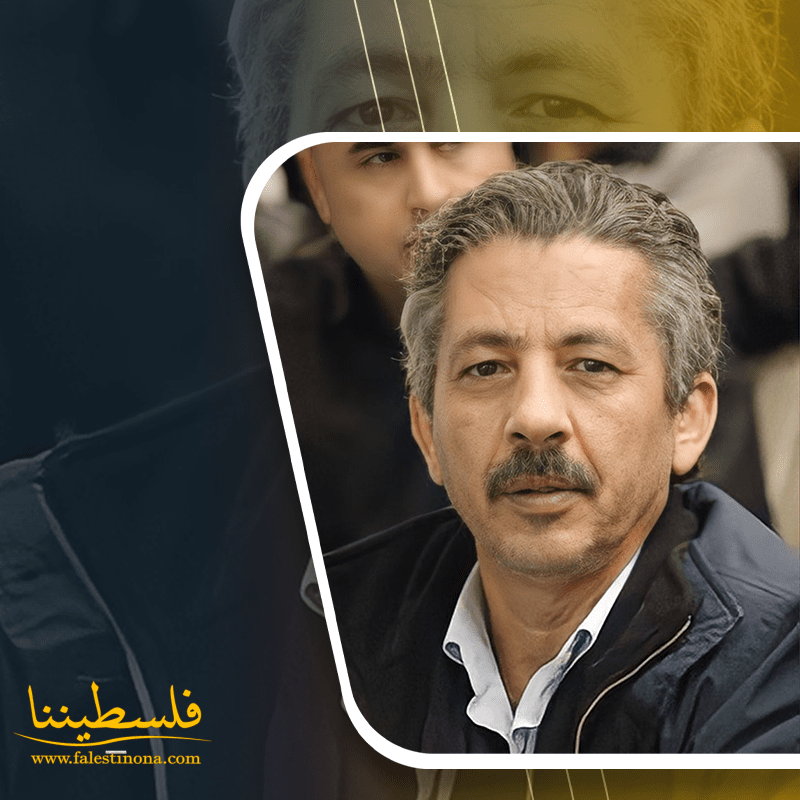
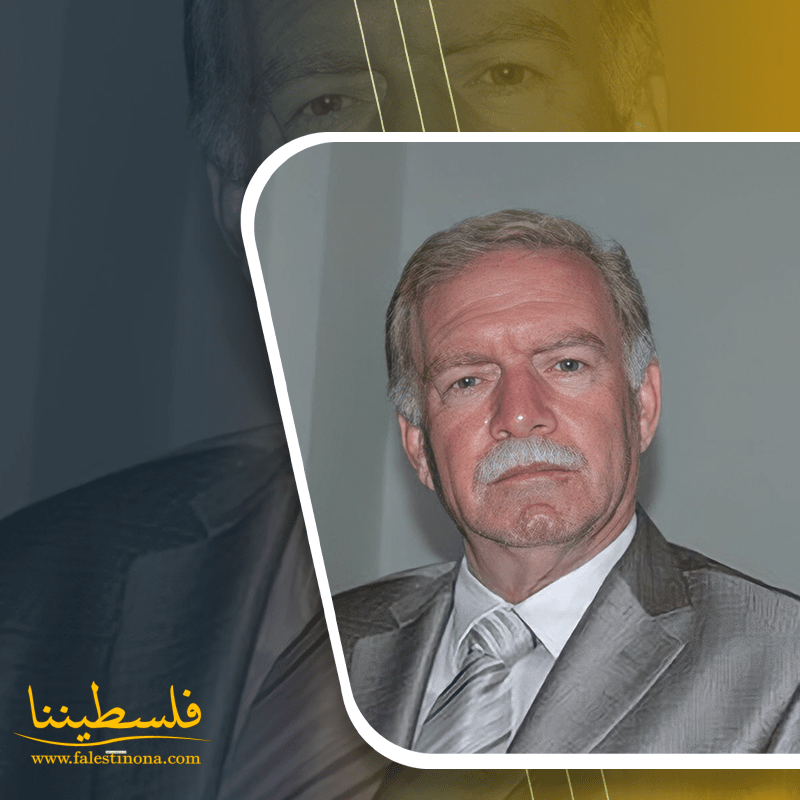





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها