بقلم : خالد أبوعدنان
قصيدة لا أحد للشاعر الاسترالي اليوناني الأصل باي وو في وصف أزمات اليونان المتراكمة: لا أحد هو اسمه وهناك لا أحد آخر * ذهبا إلى البار * جلسا تحت حيث الهدوء * لم يطلبا أي شيء * لم يقولا أي شيء * لم ينظرا لأي شيء * فهما لا يعرفان أي شيء * ولا يستطيعا أن يسمعا أي شيء * فهما لا يعرفان أي شيء. على الحائط * بالقرب من لا أحد * أقصد الذي اسمه لا أحد * هناك لوحة فنية * هي عن لا أحد * في داخل بلاد اللا أحد الكثيرين * كلهم اسمهم لا أحد * كلهم لا يتكلمون مع لا أحد * كلهم يكتبون للا أحد * كلهم يقرأون للا أحد * لكنهم لا يفهمون لا أحد * لا يوجد حوارات مع الغرباء * لا يوجد موت أو حياة * بل صمت يقتل.
مسؤولية أن يصل المجتمع لمرحلة من الإحباط تفقده القدرة على إيجاد حلول لمشاكله لا تقع على عاتق قيادته فحسب، بل أن المسؤولية تقع على أكتاف الطلائع الثورية الموصوفة بالفدائية، فهي التي تحرر المجتمع من براثن الهزيمة وتبني له لبنات الأساس لمستقبل متفائل قادر على التغيير. وهم وحدهم القادرون على تبديل أدوات الصراع مع القوى الظلامية والاستعمار، فيكون العنف الثوري أسلوب حتمي ووحيد لتحرير الأرض من المحتل، إلا أن العنف الثوري لا يعني غزارة الرصاص حتى النصر، بل مزاوجة الرصاص بالعمل السياسي في غمار معركة طويلة بحاجة لنفس طويل واستمرارية في النضال مع التغني بالنجاحات الصغيرة واعتبارها من إنجازات الثورة ومصل الأمل للشعب المضطهد.
كتب ديفيد شوارتز: الإيمان أنك تستطيع أن تنجح، يوصلك للنجاح النجاح هدف الحياة، الإيمان يستطيع أن يحرك الجبال، أنا إيجابي إذن أنا أملك القدرة على التغيير، تحدّي المستحيل والسير عكس التيار، وعدم الخوف من المجهول، وتحضير البديل لا يعني تغيير الهدف بل تعديل طريقة الوصول للهدف. فقول الحقيقة عند الهزيمة مختصرة بأننا سنكرر المحاولة بأسلوب جديد، فالأمل هو وقود الثورة، ولا يوجد نجاح كامل ولا يوجد فشل كامل بل إن المسافة بينها متغيرة بتغير المكان والزمان، فهناك نجاح متأخر وهزيمة تقتل المنتصرين. ففي بدايات الثورة يكون هناك خوف شعبي كبير من رجال الثورة، ينعتونهم بأقبح الصفات مثل العملاء والمخربين والمغامرين لأنهم لا يراعون أن الشعب المضطهد غير قادر على مواجهة ردة فعل العدو من ناحية، كما أن الشعب وصل لمرحلة من الإحباط كفر بها بأن هناك قوة قادرة على الانتقام له. إلاّ أن تحلّي الثوار بأخلاق الفدائين يجعل الشعب يتعاطف معهم في البداية ثم يبدأ في الدفاع عنهم وعن أفكارهم وبالنهاية يبدأ بالالتفاف حول مشروع الثورة. ومن أهم صفات الفدائي أن يكون باعثا للأمل والتفاؤل في صفوف الشعب، بل إن الفدائي يمدح صمود الشعب ويصف إحباط الشعب بأنه دليل على نقائه الثوري ورفضه لأن يكون مهزوما للأبد.
وسجل تشي جيفارا ملاحظات من خبرته العملية في صناعة الثورة: إن لغة الحوار الجماهيري لابد أن تتناسب وثقافتها، فلن يكون حوار الأستاذ الجامعي مفهوماً من الفلاحين بل أنهم يهابون حتى أن يستفسروا على بعض مفرداته الصعبة، كما أن لغة الفلاح البسيط غير قادرة على إقناع طلبة الجامعة، إن الكفاءة الثورية تتطلب اختيار المحاور المناسب لكل تجمع جماهيري، ويبقى الخطاب الجماهيري فن بناء الروح الثورية التي تحتاج لتدريبات كثيرة في علم الكادر الكريزماتي. والحكم الخاطئ على الخطاب الجماهيري يكمن بتحديد أسماء الكوادر المتحدثة فقط، رغم أن هناك فريق عمل كامل أنجز اللقاء الجماهيري بداية من القيادة التي قررت هذا النشاط الثوري وثم قسم الدراسات الذي أعد الكلمات ثم قسم الدعاية الثورية التي سوّقت هذا النشاط ثم أبناء التنظيم الذين شجعوا الجماهير على ضرورة الحضور، أما إذا كان كل هذا المجهود عمل فردي عصامي فهو لا يعد عملا ثورياً بل مجرد فعل مساند للثورة.
ولشرح أوسع لمفهوم الكادر الكريزماتي فقد كتبت وليفيا كاباني: الكاريزما ليست صفة خلقية يولد بها الإنسان، بل هي مهارة يتعلمها ويتدرب على استخدامها في أوقات يختارها بنفسه، فالإنسان الكاريزماتي لا يستطيع أن يتقمص هذا الدور طوال الوقت. ورغم أن هذا العلم يُدرّس في الجامعات خاصة في أقسام الإدارة والتسويق، إلا أن القيادات السياسية تتعلمه سراً في الدروس الخصوصية. ويمكن اختصارصفات القائد الكاريزماتي بأنه لا يمدح نفسه بل يمدح مجموعته إن اضطر لذلك، لكنه بالغالب يمدح المستمعين له، ويبالغ في مدح أفعالهم لدرجة أن يشعرهم أنهم هم القيادة وهو جاء ليتعلم منهم فن القيادة. إن ثقة القائد بأفكاره يجعله لا يناقش الشعب بها، بل أنه يقنع المستمعين أن هذه أفكار الشعب وهو مجرد مندوب عندهم في القيادة، والقوة الحقيقية لهكذا قائد هو امتلاكه الحضور الدافئ الذي يسيطر على المشاعر ويلهم القلوب لضرورة الخشوع في صلاة الوطنية التي ترفض عقلانية الطرح أو صوابية الإجماع على أقواله. إنها سطوة الروح الجماعية التي تزيل كل الفروقات بين الناس وتجعلهم يتوحدون في هتاف واحد مختصر نحن القيادة والقيادة هي الشعب.
كما أن ديفيد شوارتز استنتج: إن تطوير الإيمان بالفكر الثوري يلزمك أن تفكر بالانتصار ولا تفكر بالهزيمة، الكثيرون يتغنون بالفدائي ولا بالانتحاري، فكر بتحقيق خطوة للأمام لا تسجيل احتجاج لثائر هامشي. ذكّر نفسك دائماً أنك قادر على الفعل، لا تستسلم لليأس وتعلن أنك هامشي، لا تفصل نفسك عن الجماعة بل أنت جزء من الكل، ولا يوجد انتصارات فردية لكن هناك اُناس محبطين بحاجة لجرعة أمل. طموحك كبير وهو الانتصار الكامل، أما أصحاب الطموحات الصغيرة فهزائمهم سريعة، فالمعركة هي صراع أفكار، والعمل الدؤوب لإنجاح فكرتك يعتمد أساساً على مدى إيمانك بها.
فلا يوجد فدائي غير منتمي لتنظيم ثوري، ولا يمكن أن نعتبر المناضلين الفرديين فدائيين، لأن الفدائي يطرح فكر استمرار الثورة بينما يكتفي الفرد المستقل باحتجاج والقتال الفردي دون أن يبني خلايا ثورية قادرة على مواصلة النضال. إن النظر للمجتمع بشكل عام على أنه ثائر يحرف تفكير الثورة وأحياناً الكفر بالفكر الثوري، الثورة تتمدد بمجهودات أبناء التنظيم الإيجابية وتجعل دائرة تأييد قيادة الثورة بين صفوف الشعب أكبر من حجمها الطبيعي المختصر بجماهير التنظيم السياسي المحدد
بل أن خوسه أورتغا إي غاست ذهب إلى أبعد من ذلك عندما دوّن: هناك خلط كبير بين جمهور الثورة وشعبية تنظيم ثوري معين، فجمهور الثورة متمرد على التنظيمات الثورية، بل يطالبها بضرورة الإئتلاف في صيغة الوحدة الوطنية لتسريع عملية التحرير ولزيادة كفاءة الفعل الثوري، وهي ميزة إيجابية للجمهور الثوري، لكن هناك صفة مرعبة لجماهير الثورة وهي أنها تفضل الثائر المماثل لها، أي أنه ثائر لحظي، خاض ثورته وحده وقتل ثم مات وأصبح أسطورة، فعملية البناء الثوري للفدائي عند الجماهير تعتبر عبثية لأنها على قناعة أن الفدائي سوف يقاتل يوم واحد ثم يموت ويتحول إلى أسطورة. أما شعبية التنظيم الثوري فهي بالتأكيد جزء متطور من الجماهير الثورية وصل لقناعة أن الثورة بحاجة لاستمرارية وأن الفدائي قد لا يموت بأول عملية قتالية. وهذا ما جعل فيدل كاسترو يكتب عن الثوار الفرديين: إن الكثيرين ممن لقوا حتفهم كقطاع طرق (المقصود: البندقية بلا فكر ثوري هي قاطعة طريق)، هم ضحايا لوهم خادع، واليوم ينبغي النظر إليهم باعتبارهم أبطالاً. بل أن الثوار الفرديين كثيراً ما ينعتوا التنظيمات الثورية بأنها انتهازية ومستفيدة من استمرار الاحتلال وتطرح نفسها كثورة فوضوية جديدة، كما شرحها فيلريدو باريتو: جميع الثوريين يعلنون على التوالي أن الثورات الماضية لم تصل في النهاية إلا إلى خداع الشعب، والثورة التي يضعونها نصب أعينهم هي وحدها التي ستكون الثورة الحقيقية.
وهنا لابد التمييز بين المناضل المناصر للثورة والملتزم بقرارات قياداتها وبين الفرد المضطهد من قبل الاحتلال إلا أنه متمرد على التنظيم الثوري، فالمناضل المناصر للثورة قادر على الفعل الثوري، بل أنه يشكل الجدار الواقي لجسد الثورة، وعلى سبيل المثال قدرته على كتمان تحركات الفدائية يعتبر فعل ثوري مهم. وكتب خوسه أورتغا إي غاست عنه: السرية هي ليست إخفاء الحقيقة عن الجماهير بل هي أسلوب لحماية الفعل الثوري والمناضلين وأيضا الجماهير الثورية، إن تستر أحد الفلاحين على عملية ثورية وعدم الاعتراف بمشاهدته تحت تهديد العدو يعني أنه يمارس السرية الثورية، أما مسألة مقدار الشفافية مع الجماهير يعتمد على جاهزية الجماهير لتحمل أعباء إضافية وانخراطهم في العمل الثوري المنظم. إلا أن تيم واينر له وجهة نظر مغايرة: رغم أن الإنسان البسيط ثرثار بالفطرة يحب أن يخبر مشاهداته لدائرته الخاصة في البيت والعمل ويستطيع عملاء العدو الحصول على المعلومة بسهولة بالغة، ولقد استخدمت الاستخبارات العسكرية الأمريكية نظرية الثرثرة للحصول على معلومات رخيصة في أفغانستان، وقالوا لو أننا استخدمنا هذه النظرية في الفيتنام لنتصرنا.
أما إذا تتبعنا مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة، فلابد أن نبدأ في تحديد هل هي ثورة فدائيين؟ وبمعنى أوضح هل تملك أهلية تمثيل الشعب الفلسطيني؟ وأتصور أن الأستاذ خالد الحروب أجاب باستنتاج علمي عندما عرّف الشرعية الفلسطينية الثورية فكتب : يقصد بالشرعية الفلسطينية هي منظومة الأعراف المقاومية والسياسية التي أقرها الإجماع الفلسطيني التنظيمي والشعبي وما نجم عنها من آليات مؤسساتية صانعة للقرار الفلسطيني وللعلاقات الإقليمية والدولية. وهي أيضاً منظومة الأعراف المتضمنة حمولة رمزية تراكمية انتزعت الإقرار الشعبي بحق تمثيل الفلسطينيين، وصنع القرار الفلسطيني، أما الشرعية الثورية فقد نشأت في ظل مقاومة الاحتلال وهي البنية التحتية لكل قيادة فلسطينية، ثم هي التي أعادت إنتاج نفسها عبر اكتساب شرعيات انتخابية وإقليمية ودولية في مراحل لاحقة من تاريخ فلسطين نضالها. فقد بدأ مفهوم الشرعية الفلسطينية بعد انطلاق حركة فتح وهي بامتياز من حقق معادلة التفاف الجماهير حولها، وهذا ما لم يتمكن تحقيقه الشقيري في منظمة التحرير الفلسطينية، بل إن اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين كان مشروعا فتحاويا بامتياز وكان هدفه الوقوف بوجه بعض الدول العربية التي تدعي حقها بتمثيل الفلسطينيين.
يتجرأ البعض بالقول أن الشرعية الفلسطينية سقطت من يد حركة فتح وأن الشعب الفلسطيني عاد لنقطة الصفر بلا قيادة قادرة على التحدث باسمه، وأن المفاوضات متوقفة لهذا السبب، ولا يوجد أفق لحل معضلة الانقسام. لكن هذا التجني يتغافل الظرف التاريخي الذي شرخ الساحة الفلسطينية والمسمى ظلماً بالانقسام لأنه انقلاب بكل أبعاده الفلسفية. فعند الحديث عن الانقسام يلوم الكثيرون حركة فتح بأنها لم تمنح حركة حماس الفرصة لإدارة السلطة ويبرروا انقلاب حركة حماس بأنه كان طبيعيا من أجل تنفيذ برنامج حركة حماس الانتخابي! متناسين أن برنامج حماس الانتخابي كان متوافق مع حركة فتح وهو ضرورة إتمام العملية السلمية وإعطاء فرصة للمفاوضات لإنجاز تغيير على أرض الواقع. وهذا التوافق جاء نتيجة انتهاء مرحلة انتفاضة الأقصى، حيث أن حركتي فتح وحماس خرجتا من انتفاضة الأقصى التي بلورت مشروعهما المشترك، والذي كلفهما الكثير من الشهداء خصوصاً على المستوى القيادي، كما أن الوضع الاقتصادي كان مدمراً والشعب كان يُطالب بهدنة للملمة الجراح وإعادة التعمير، ولا يوجد أي حادثة تدلل على أن الخلاف بين الحركتين كان على ضرورة التصعيد العسكري، بل أن بداية الانقلاب شهدت هدوءا حذرا مع قوات الاحتلال.
وبعد فترة قصيرة من الانقلاب بدأت الصحافة العربية تتحدث عن هموم الشعب الفلسطيني بين المخفر الفتحاوي والمسجد الحمساوي، حيث بدأت حركة فتح تفرض الهدوء بالقوة لتوفير أرضية مقنعة للأطراف الدولية للعمل على دفع المفاوضات نحو الخطوات العملية، ومن الزاوية المغايرة فرضت حركة حماس خطابها السياسي على منابر المساجد سعياً وراء إضفاء صبغة الوصاية على الإسلام والمشروع الإسلامي في فلسطين في سابقة مستحدثة في فلسطين لم يفرضها حتى الحاج أمين الحسيني رغم أن له صفة دينية كمفتي للقدس إلا أنه كان لا يخلط الخطاب السياسي بالدرس الديني، بل إن خطابه السياسي كان بعد صلاة الجمعة حتى يكون المصلين مخيرين بين سماعه أو مغادرة المكان، فالكل يعلم أن المسلم مهما كان فكره السياسي لا يستطيع أن يغادر المسجد إذا لم تعجبه خطبة الجمعة لأنها فرض ديني لا واجب وطني لتنظيم سياسي معين.
وضعت الأستاذة نادية أبو زاهر سؤالا مهماً للبحث لماذا وصل الأمر بين حركتي فتح وحماس إلى الاقتتال الدموي، ولم تجري إدارته وفق مبادئ الديموقراطية؟ فوجدت أن اختلاف المنهج والبرامج السياسية هي السبب الأول (60% من آراء فتح، 40% من آراء حماس) وهي فرضية أن الانتخابات تلغي ما قبلها من التزامات مثل القبول بسقف اتفاقية أسلو وإعطاء المفاوضات فرصة، وإلا لماذا تم إيقاف انتفاضة الأقصى؟ لماذا لم يستمر العمل المقاوم من حركة حماس؟
لعل شرح جورج سوريل لمصطلحات المقاومة المسلحة لمجتمع الثورة، يوضح الفروقات بكيفية استخدامها: إن هدف القوة هو فرض تنظيم للنظام الاجتماعي بحيث يوفر المناخ لاستمرار الحياة اليومية للعوام، بينما العنف هو تقويض قوة الثورة على تنظيم مجتمعها، وقد يكون العنف إحدى طرق تصويب المسار الثوري إذا ما وجد التفافاً جماهيراً، أما إذا انحصر بفئة انعزالية فعليها تغيير قناعتها وتسليم نفسها للمحاكم الثورية، أما مفهوم الوحشية الثورية فهي استمرار العنف من الفئات الانعزالية ليس ضد قوة الثورة بل ضد الشعب لأنه لم يدعم أهدافهم في تدمير قوة الثورة. كما كتب أيضاً المفكر الافريقي أميلرال كابرال: لابد أن نتفق أننا جميعاً نعيش في وطن محتل، وأن هناك تنظيمات متعددة لكنها ليست عميلة للاحتلال، بل كل منها يُقاوم بطريقته الخاصة، إلا أننا لا نملك أن نفاوض والكفاح المسلح مستمر، علينا جميعاً أن نقرر هل نحن قادرين على انجاز حل عبر المفاوضات أم أن نستمر بالكفاح المسلح؟ ومهما كان خيارنا لابد أن نختاره معاً ونعمل على إنجاحه معاً وإن لم يكن هذا ممكناً، فالشعب سيشعل الفوضى التي لا نستطيع استثمارها ولا ترويضها لأننا سنكون بنظر الشعب مجرد عملاء للاستعمار. وهي نفسها النظرية الماركسية للثورة والتي شرحها لينين فكتب: إن المقاومة العسكرية هي أسمى ما يمكن أن يقوم به التنظيم الثوري، يسمو أكثر إن كان عملا جماعيا لكل التنظيمات الثورية، لكن لابد من حصد نجاح سياسي من الفعل الثوري، وهذا بحاجة لفترة هدنة مؤقتة متفق عليها بين التنظيمات الثورية، ومن يخرق الهدنة منفرداً يعد عدواً للثورة، فهذه انتهازية المناشفة (الأقلية) تسعى لفرضه على البلاشفة (الأغلبية).
أما عن قضية إعادة اللعبة القديمة بضرورة بناء تحرير الشعب من الفكر المنحل والعودة الصدوقة للدين كمشروع بديل للثورة على الاحتلال فهو نوع من الوصاية المرفوضة على أسلوب تفكير الشعب، بل لا يأتي من باب حماية الشعب من الانحلال الخلقي بقدر فرض القرار السياسي لأنه جزء من المقدس الديني. فقد سجل الباحث الاسترالي ميشلي ترنر حواراً مع الرفيق مونسيغنور دا كوستا لوبيز أحد قيادات ثورة تيمور الشرقية: هل الفروقات الدينية هي سبب استمرار الثورة لمدة طويلة؟ أجاب لوبيز: لا يوجد أحد يفرض دينه على أحد، بل أن الجنود الإندونيسيين ليسوا كلهم مسلمين، وحتى المسلمين منهم لديهم طرق تعبد مختلفة، لا يوجد شيء واحد يمكن أن يختصر الإسلام أو المسيحية، لكن السياسيين يعتبرون أنفسهم أوصياء الله في الأرض ويحاولون أن يختصروا الدين وفقاً لرغباتهم السياسية وهذا ما يرفضه المجتمع الإندونيسي والتيموري على حد سواء.
إلا أن البعض لا ينتبه لخطورة هذا الموضوع وأنه يهدد استمرارية الثورة بسبب تغيير أهدافها عند بعض التنظيمات، ولعل الاستشهاد بالبروفيسور التاميلي برين سينيويراتني يعد مهماً لأنه يحذر من مستقبل معتم لهذا الانحراف الفكري فقد كتب: لقد هزم التاميل ليس نمور التاميل فحسب، بل كل فصائل المقاومة بل الشعب كله هزم، وكل القيادات الثورية في المعتقلات السياسية أو قتلوا، لقد اختلفوا فيما بينهم، وجعلونا نقاتل بعضنا أكثر مما قاتلنا الحكومة السيرلانكية، ولم نصل لمرحلة الوحدة الوطنية في الثورة رغم أننا كنّا مجتمعين غير قادرين على حماية شعبنا من تنكيل القوات السيرلانكية، والنتيجة أننا خسرنا كل شيء وقياداتنا الآن تنظف حمامات الجيش السيرلانكي.
وهنا لابد أن نتذكر أن خطاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الأمم المتحدة كان يحظى بإجماع وطني وعربي شامل، فقالها على المنبر الأممي: جئتكم وفي يدي بندقية ثائر وبيدي الأخرى غصن الزيتون فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، وهنا لا يكون إسقاط غصن الزيتون برمزية السلام بدون مفاوضات بل أنه رمزية التعايش السلمي مع الشعب الإسرائيلي، إلا أن ذوي الأفق الضيق يبحثوا عن انسحاب منفرد من جانب قوات الاحتلال دون ضرورة الدخول في المفاوضات، لكن لا يوجد أي عملية سلمية إلا وكانت المفاوضات جزءا منها، ولن تنجح المفاوضات إلا بتوحيد الجبهة الداخلية. وقد كتب مرشال روزنبيرغ: مهما كانت كفاءة القيادة السياسية في المفاوضات، ومهما كان موضوع المفاوضات واضح وسهل، إلا أن المفاوضات لا تبدأ على الطاولة بين الخصوم، بل هي مفاوضات داخلية في كل بلد بين الأحزاب السياسية فإن نجحت أن ترسم ما تريده وتدعم وفدها في المفاوضات فهي الأقوى أمام الخصم، أما إذا كانت في حالة صراع فلا يوجد مفاوضات بالمطلق لأن الاحتلال يناسبه استمرار الاحتلال ولا يجد خصم موحد يجبره على الانسحاب.
الفدائي هو من الطليعي بالثورة بكل مراحلها، فهو مفجر الثورة بالكفاح المسلح وهو من نشر فكر التحرر بين أبناء الشعب، وهو منذ بداية الثورة يعلم أنه في النهاية لابد أن يقنع قوى الاحتلال بضرورة الاعتراف بحق الشعب بالمضطهد وبأن الشعب بدأ يتحرر ويقيم دولته المستقلة عبر المفاوضات التي تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الثورة المنتصرة والاحتلال المنهزم، وإننا بالثورة الفلسطينية أنجزنا المراحل الثورية العنفية ونحن بحاجة للبدء الفعلي والجاد بالعملية السلمية، فهل التنظيمات السياسية وخاصة حركة حماس واعية لطبيعة المرحلة؟











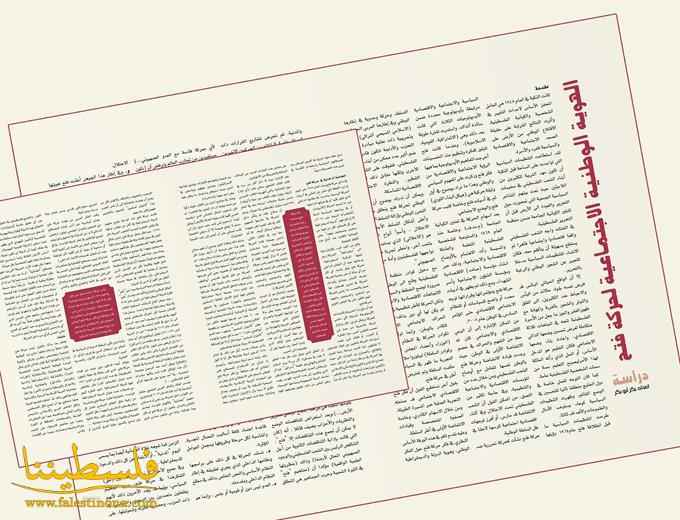







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها