حوار: غادة اسعد- خاص مجلة "القدس" الاصدار السنوي 333 كانون ثانٍ 2017
في قصيدة أحمد الزعتر للشاعر محمود درويش وقف أحمد الزعتر خلفَ الماضي، أحمد المنسيّ والمذبوح يبكي جراح تل الزعتر، يومَ غابَ أهلُ المخيّم، وما بقي فيه سوى رائحة الموتى، وبقايا لأطفالٍ غابوا بعد أن قنصتهم البنادق، لم يكونوا فدائيين، ولم يُحاربوا، مع ذلك سجّلهم التاريخ في دفترِ الماضي.
وإن كان الوجع بحجم القصيدة، فإنَّ الماضي وذكريات "تل الزعتر" لا تهرُبُ أبدًا من ذاكرة الذين عاشوها، فها هو الدكتور يوسف عراقي، الجراح والمحاضر الجامعي الذي عايش أحداث المجزرة يومَ كان طبيباً في تل الزعتر، يعود من جديد ليأخذنا إلى تل الزعتر، رغم أنه يعرف أنّ الجرح لا يزال ينزف، وكلّما وقفَ على أطلال حيفا، يتذكر أنّه كان من المفترض أن يكون في حيفا، يومَ وقعت مجزرة تل الزعتر.
التهجير من فلسطين والعمل في تل الزعتر
يحدّثنا د.يوسف عراقي، عن ارتباطه بوطنه فلسطين، وتهجيره إلى لبنان وعمله بتل الزعتر، إذ يقول: "ولدتُ العام 1945 في حيفا، وفي العام 1948 خرجتُ مع عائلتي التي هُجِّرت، وبقيَت أملاكنا غير منقولة، أراضٍ لا مالك لها، خرجنا فوجدنا أنفسنا قد صرنا "لا شيء"، وسنبدأ من جديد. كنتُ أذهبُ إلى المدرسة وأعمل في الصيف، لتمويل تعليمي، ولاحقاً حصلتُ على منحة لدراسة الطب في الاتحاد السوفيتي سابقاً، فكان الأمر حلمًا بالنسبةِ لي، وحين كان يسألني أحدهم لماذا أردتُ أن أكون طبيباً، كنتُ أقول لأنّ عائلتي ليس فيها طبيب، وقد حصلت حوادث أمامي وأنا طفل، ورأيتُ قسوة الحياة على الفقير والمحروم، ففي إحدى المرات حين كنا نلعب ونحنُ صغار، كُسِرت رِجلُ صديق لنا، أخذناهُ إلى المستشفى في لبنان، فرفضوا إدخاله وإعطاءه العلاج قبل أن ندفع المال، وهذه الحادثة أثّرت بي جدًا، وهي التي وجَّهتني نحو الطب".
ويضيف: "عُدتُ من موسكو بعد تخرجي طبيبًا، وكانت عودتي في فترة هدوء، بعد أحداث عين الرمانة، وكان الاختيار تل الزعتر، وكان أول عهدي بالعمل في مستشفى المخيم، في الحادي عشر من آب 1975، ومنذ عودتي، كنتُ أحمل في عقلي الكثير من النظريات، وأفكاري حبلى بالعديد من المشاريع، رغم أنني طبيب حديث التخرج".
يوميّات طبيب في تل الزعتر
يوسف عراقي الطبيب الذي ساهم بعلاج عدد من الفلسطينيين واللبنانيين والأجانب، تركَ فراغًا بعد غيابه عن المكان، فقد كان شخصيةً محبوبةً في عيون أهالي تل الزعتر، ومن شدة الوجع، قرَّر أن يكتُب مذكراته في كتاب يحمل اسم "يوميّات طبيب في تل الزعتر".
وخلال زيارته إلى حيفا حيثُ تمَّ تكريمه واستقباله بحفاوة بالغة، حدَّثنا د.عراقي عن كتابه الذي جسَّد فيه المأساة التي عايشها، فقال: "جاءت الفكرة بعد خروجي من المخيّم، إذ كنتُ أكيدًا أنَّ الذاكرة الجماعية في حياة أي شعب شيءٌ مهم للاستمرار، فقررتُ تحمُّل المسؤولية داخل الحصار، ودقائق الأمور التي كانت وقت الحصار، بقيتُ في تل الزعتر، والأحداث صارت تقتربُ مني كوني طبيبًا، هكذا قررتُ الاحتفاظ بتفاصيل ذاكرتي، وحاولتُ ترجمتَها إلى كتاب هو الآن قد صدر بأكثر من طبعة، والهدف من الرواية أن نحفظَ الذاكرة الجماعية لأهل المخيّم وللعالم بأسره. فتل الزعتر حكاية وجع، وقصة نكبة، قصّة مصغّرة عن النكبة، إذ كان في المخيّم فلسطينيون من 77 قرية، وحِفظ الذاكرة الجماعية كان نابعاً من مسؤوليّتَين، مسؤولية أمام الذين استشهدوا وضحّوا، وأمام الجيل الصاعد ليعرف ماذا حدث في الماضي، في الشتات، والآن حان دور الجيل الثالث ليُحيي التفاصيل الموجعة وليحافظ على الذاكرة التي كانت، ولينقلها للأجيال التي تأتي بعدنا".
وعن مشاهداته في المخيّم يقول: "كان المخيّم ذا كثافة سكانية كبيرة، أزقته ضيقة، ومجاريه مكشوفة، والمزابل منتشرة في كل مكان. وقد كان واقعاً تحت قبضة المخابرات العسكرية للجيش اللبناني، وكانوا يمنعون السكان من إجراء تعديلات في البيوت، بل ولم يكن باستطاعة أحد فعل شيء، فإذا أدار المذياع على إذاعة "صوت العرب" كان يُعتقَل، ومن لديه نشاط سياسي يُعتقَل، ومن يلقي الماء، تلاحقه الشرطة، باختصار كانت الحياة عذابًا، وكان المخيم تابعًا للأونروا، لكن الإمكانيات كانت ضئيلة وغير متوفّرة، لا من حيثُ الأدوية، ولا من حيثُ التعليم، واستلمَت "م.ت.ف"، الوضع الأمني في المخيم، وشُكِّل ما يُسمَّى بالكفاح المسلَّح وهو عبارة عن شرطة فلسطينية مسؤولة عن الأمن، فبدؤوا بتحسين المخيّم، وبدأ الناس يبنون بيوتًا من باطون وزينكو، وصاروا يبنون حمامات في البيوت، وبدأ الوضع يبدو أكثر إنسانية. وكان المخيّم يقع على تلّة منخفضة، وعبارة عن وادٍ، طوله نحو 1كلم، وعرضه نحو 750 متراً، وكان مكتظًّا بـ30,000 مواطن. ومن الأمام كانت هنالك منطقة راقية، فيها قصور ومؤسسات، وحول المخيّم مصانع تُقدَّر بـ40% من الصناعة اللبنانية، بسبب توفُّر أيدٍ عاملة رخيصة وقريبة".
ويضيف: "كان في المخيّم مجمع طبي بُنيَ حديثًا، ساهم أهالي المخيم واتحاد عمال فلسطين في تكاليف بنائه، بإشراف الهلال الأحمر الفلسطيني، تكوّن البناء من جامع، وقاعة محاضرات لاتحاد العمال، والطابق الثاني كان عبارة عن عيادتَين خارجيتَين ومختبراً للأدوية وإدارة للمستشفى. وفي الطابق السفلي كان هناك قسمان واحد للرجال وآخر للنساء، وكانت تُجرَى عمليات التخدير وتوابعها. وفي العام 1975 لم يكن المستشفى قد اكتمل بعد، كان لدينا قسم طوارئ ونجري العمليات الصغيرة، ولم يكن لدي الخبرة الكافية لإجراء عمليات كبيرة، وكنا نحوِّل بعض الحالات الى المستشفيات في بيروت. وقد بدأتُ العمل في العيادة الخارجية، حيثُ كان معظم المرضى من الأطفال، وغالبًا ما كان الازدحام كبيرًا، كنا ثلاثة أطباء في البداية، ثم تركَنا طبيباً يُدعى صلاح وانتقل إلى بيروت، فكنا نستقبل المرضى ليل نهار، ولكون المستشفى يقع في وسط المخيّم. وكان أغلب المرضى من الأطفال".
وعن تجربته كطبيب خلال الأحداث يقول: "بعدما توتّرت الأوضاع في منطقتَي المسلخ والنبعة أخذنا نستقبل بعض الحالات من هناك، ففكرنا بتنظيف الطابق السفلي الكائن تحت الأرض، وإزالة الأتربة وفرش الأَسرّة، وأذكر يومها أن القرار السريع بترتيب المستشفى كان في مكانه، فقد توالت الإصابات بعدها بكثرة. وأخذ المستشفى يقوم بدور مركز إخلاء للإصابات، وإجراء الإسعافات الأوليّة اللازمة، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات المنطقة الغربية من بيروت، وكانت عملية نقل الجرحى من منطقة سن الفيل والنبعة تتم بواسطة لجنة الارتباط اللبنانية الفلسطينية".
ويتابع: "لن أنسى فاطمة التي أُصيبت بطلقة قناص في ظهرها، وصلتنا وهي بحالة صدمة عصبية، واستطعنا إنقاذها في الوقت المناسب، وكانت تلك المرة الأولى التي أرى فيها الإصابات، ولحسن حظنا، كان يومها حاضرًا اد.نبيل وهو الطبيب الذي عمل قبلنا في المخيم وعاصر أحداث 1973، واشتباكات الجيش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية في تل الزعتر، وبعد فاطمة جاءتنا عجوز كردية مصابة في صدرها، وكانت في وضع ميئوس منه، ولكنّني بذلتُ كلَّ ما أستطيع لإنقاذ حياتها، ونجحت التجربة، ودخلت بعد ذلك، مرحلة جديدة في العمل الطبي، إذ بدأت أقوم بالجراحات البسيطة إذا استدعت حالة المصاب ذلك".
ولعلَّ ما سطّره د. يوسف عراقي من روايات مؤلمة وموجعة، لا تنتهي، لكنه نجح على الأقل في تسجيل شهادته من خلال تجربته الطويلة في تل الزعتر ولبنان عمومًا.
ويلخّص د.عراقي ذلك قائلاً: "مرَّ شريط المجزرة أمامي رهيبًا. كانوا يأخذون الأهالي جماعات ليطلقوا النار عليهم. وكان أحد الفاشيين ضخم الجثة، وقد تعتعه السكر، يحمل سكيناً كبيرة ملطّخة بالدماء. ويأتي كل بضع دقائق ليمسح السكينة الملطّخة بدماء الأهالي بقميص مَن كان يجلس عند الباب منهم. لقد كان يذبح كما يذبحون الغنم. وبعدها يبدأ التفتيش في جيوب الضحايا عن أشياء. كان منظرًا رهيبًا وقذرًا في لحظة تتجمَّد فيها العاطفة، كانوا يأخذون من الناس كل شيء. لا وفقّهم الله".
وثيقة للتاريخ والأجيال القادمة
يُعتبر الكتاب وثيقةً، إذ وثّق فيه د.عراقي ما حدث في تل الزعتر، وفيه وضع مشاعره، آخذاً الموضوعية بعين الاعتبار، وقال إنه يَعُدُّ نفسه يكتب للتاريخ وللأجيال القادمة، والكتاب صدر باللغة الانجليزية أيضًا في مونتريال في كندا، بدعم من مجموعة كنديين وفلسطينيين، واعتُمِد كمرجع في كلية التاريخ في مونتريال.
وفي الكتاب تحدَّث عن أهل المخيَّم وليس عن نفسه، لأنّه اعتبر ما حدث في تل الزعتر نتيجة عمل جماعي، وكان للمرأة الدور الأول وهي التي كانت تخاطر بنفسها لتحصيل نقطة ماء لأطفالها، وكثيرٌ منهن استشهدن في الطريق، كما أنّه جسّد ووثّق المجزرة في لوحات، آخرها لوحة لخّصت كل المجزرة، منها النساء اللواتي استشهدن، والطاقم الطبي المؤلّف من 14 ممرّضاً وممرّضة، حين أوقفوهم وأطلقوا النار عليهم، وكان يمكن أن يكون واحدًا منهم، فقد أوقفوه معهم، لكن أحد المليشيا من الكتائب تعرّف عليه كونه أجرى له عملية سابقًا، وأراد إنقاذ حياته، بينما وقف مليشي آخر يريد الضغط على الزناد، فكانت الصدفة التي أخرجته من الموقف، ربما ليتحدث عن قصة المخيم كما يقول، ويضيف: "من خلال الكتاب أسعى للحفاظ على الذاكرة الجماعية وهذه مهمتنا الأساسية، كما أنّ الأجيال لديها أدوات متطوّرة ومتعدّدة، ونأمل ألّا نُصاب بالخيبات. أمَّا زيارتي إلى فلسطين مؤخّرًا فقد حمَّلتني مسؤولية كبيرة، مثل مسؤولية تل الزعتر، أحملها وأتحدث عنها، وفي كل عام أصل إلى لبنان، أولاً أمرُّ على تل الزعتر، لأقرأ الفاتحة على الأحبّة، وأترحّم عليهم".
ويردف: "لقد بقي التل بمقاتليه يصارع ويقاوم، وشَهِد المخيّم وقائع مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ النضال الفلسطيني، 52 يومًا من الصمود الأسطوري تعرّض المخيّم خلالها لسبعين هجومًا سقط خلالها أكثر من 3,000 شهيدٍ و6,000 جريح، غالبيتهم من المدنيين، بدون أن يستسلم كما كانوا يراهنون، وبعد سقوط المخيّم بيومين شقَّ مقاتلو التل المدافعون عنه طريقهم عبر الجبل خلال معارك ضارية مع القوات الانعزالية ليلحقوا بقواعد القوات المشتركة في منطقة الجبل. ولتنتهيَ بذلك الملحمة الأسطورة لمخيّم صغير في قلب بيروت الشرقية اسمه "تل الزعتر" كان عاصمةً للفقراء"، هكذا ختم د.يوسف عراقي الطبيب والرسام والروائي، روايته التي سجّل من خلالها صمود المخيم وأهله ومقاتليه في وجه المجزرة التي ارتكبتها القوات اللبنانية الانعزالية والتي لم تزل معالمها شاهدة على وحشيّة العدو مقابل روعة وثقافة الصمود لشعب عربي أعزل.



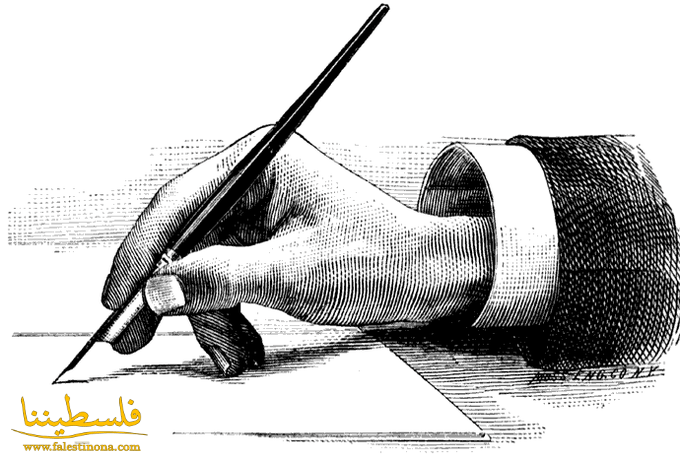







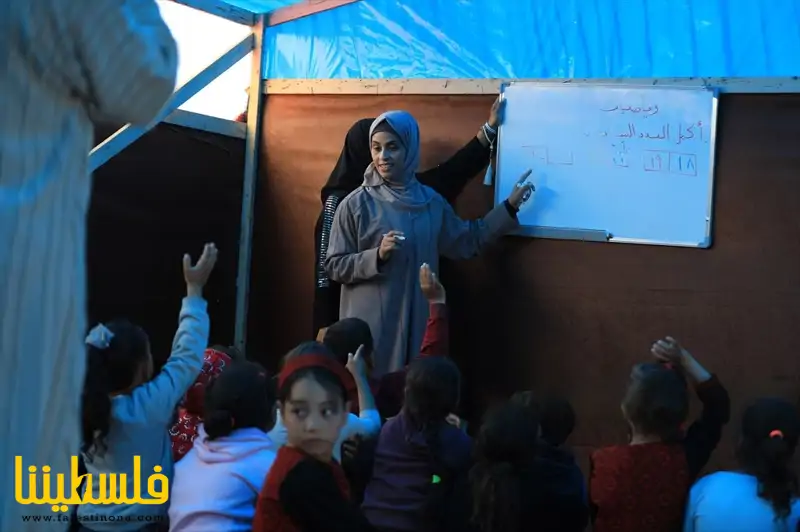






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها