خاص مجلة "القدس" العدد 329 اب 2016
تحقيق: ولاء رشيد
لم يكن مخيّمُ تل الزعتر مجرَّدَ مخيّم عادي، بل كان عموداً فقريّاً للثورة الفلسطينية، ولعلّ هذا أحد أسباب كون المجزرة التي ألـمَّت به مِن أكثر المجازر إجراماً ووحشيةً. بيدَ أنَّ أهالي المخيّم لم يفقدوا الأمل، فكابدوا ضنك المعيشة، وسطروا ملحمة في الصمود والأمل، ليُثبتوا أنَّ الفلسطيني لا ييأس، وإنما يستمدُّ القوة من كلِّ أزمة يمرُّ بها، ويغدو أكثر تمسُّكاً بقضيته العادلة وحقّه المشروع في الاستقلال والحريّة والعيش بكرامة.
الثاني عشر من آب يوم أليمٌ في الذاكرة الفلسطينية
بعدَ العديد من المضايقات والاحتكاكات المتفرِّقة بين المليشيات اليمينية اللبنانية المتطرّفة والفلسطينيين، التي حدثَت في خضم حرب أهلية لبنانية كانت في مهدها، تصاعدَت وتيرةُ استهداف الفلسطينيين لتبلغَ أشدّها مع ارتكاب قوات للكتائب اللبنانية مجزرة حافلة "عين الرمانة" التي كانت تُقلُّ فلسطينيين ولبنانيين من أهالي مخيّم تل الزعتر وجواره في شهر نيسان العام 1975، فكانت هذه الحادثة المحطة الأولى من محطات استهداف مخيّم تل الزعتر وأهله، والذي تراوح عدد سكانه آنذاك ما بين 50 و60 ألف نسمة معظمهم من الفلسطينيين وفقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. وفي أواخر حزيران من العام 1976 فرضت المليشيات اليمينية الانعزالية حصاراً شديداً على المخيّم- كان قد سبقه حصار آخر أخف وطأة- وهجوماً واسعاً على المخيّم وعلى تجمُّعَي جسر الباشا وحي النبعة المجاورَين له، وقصفَت المخيّم بالدبابات وبالمدفعية وبراجمات الصواريخ وبالرّشّاشات المتوسطة والثقيلة بشكل عنيف يومياً من الفجر وحتى المغيب وعلى مدى 52 يوماً، وقد قُدِّر عدد القذائف التي سقطت على تل الزعتر بـ55,000 قذيفة وفق المرصد الأورومتوسطي، وتشير التقديرات المختلفة إلى أنَّ العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء الحصار حتى انتهاء المجزرة يتراوح ما بين 3000 إلى 4280 شهيداً، قُتِل معظمهم بالتصفيات الجسدية وجرّاء القصف العنيف على المخيّم، فيما قُتِل مئاتٌ خلال خروجهم من المخيّم بعد إبرام اتفاق من قِبَل قوة الردع العربية مع المليشيات اللبنانية يقضي بخروج المدنيين والمقاتلين الفلسطينيين من المخيّم بدون أن يستسلموا للميليشيات اليمينية، فما كان من المليشيات إلا أن فتحت النار على جميع سكان تل الزعتر وهم يغادرون المخيّم عُزّلًا من السّلاح، وأنزلت حديثي السن الذين اشتبهت بكونهم فدائيين من الناقلات التي تراكم فيها الناجون على الحواجز المنصوبة على الطرقات لتقتلهم بوحشية أو تقتادهم إلى جهات مجهولة. وفي الثاني عشر من آب سقط مخيّم تل الزعتر بعد أن كان حصناً منيعاً أنهكَهُ الحصار، فدخلتهُ المليشيات وارتكبَت فيه أفظع الجرائم من إعدامات جماعية وهتكٍ للأعراض وبقرٍ لبطون الحوامل وهدمٍ للبيوت وسلبٍ للأموال.
سميرة شحرور"أم ربيع": المجزرة حيّةٌ في ذاكرتنا
لم يكن أهالي مخيّم تل الزعتر يتخيّلون يوماً أن يعيشوا نكبة أخرى وهم الهاربون من جحيم النكبة الأولى. حياةٌ ملؤها المحبّة والألفة والقناعة والسلام كان يحياها أبناء المخيّم حتى حلّت الأحداث الأليمة، كما تقول "أم ربيع"، ابنة مخيّم تل الزعتر والتي تقطن اليوم في حي تل الزعتر في مخيّم البداوي، وحول ما حلّ بالمخيّم خلال المجزرة تقول: "مهما تكلّمنا فإنَّنا لن نستطيع التعبيرَ عن هول ما شاهدنا. تل الزعتر حكايةُ ألمٍ ووجعٍ، ولكنّه أيضاً حكاية شهادةٍ وصمودٍ وبطولةِ مخيّمٍ بكامل أهله الذين دافعوا عنه رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً حتى النفس الأخير. لقد كنتُ ممرضةً في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشهدتُ استشهادَ الشُّبان بسبب نقص الادوية والطواقم الطبية لإجراء العمليات، واضطّرارنا لمداواة الجرحى بالماء والملح فقط، ولا بدَّ من الإشادة بدور د.عبدالعزيز ود.يوسف العراقي اللّذين قاما بأعمال فوق العادة في معالجة الحالات الصعبة حسب الامكانيات المتوفرة. وقد كانت المرأة أحد مقومات صمود الرجال، لأنَّها كانت تعدُّ الطعام، وتسعف الجرحى، وتجلب الماء، وهذه الأخيرة لم تكن بالمهمة السهلة، إذ إنَّ النسوة كُنَّ يذهبن عشرة لجلب المياه فتعود واحدة فقط وماؤها مختلطٌ بدماء رفيقاتها، وكم مِن شهيد سقطَ في البئر الذي كنا نشرب منه. لقد قاسى المخيّم العطش والجوع، وأُبيدَت عائلاتٌ بأكملها وليس هناك عائلة من المخيّم إلا وفقدت عدداً من أفرادها، وكل هذه المأساة عشناها وسط صمت ومؤامرة عربية، ولن نستطيع أن ننسى ما حيينا هذه المجزرة الوحشية التي تجرّد مرتكبوها من كلِّ صفات الإنسانية، لقد رأينا بأعيننا كيف أعدموا طاقم الهلال الأحمر، وكيف كانوا يوثقون يدَي الواحد من الرجال بسيارة ورجليه بسيارة أخرى ويفلخونه (يشقونه) إلى نصفين، ويبقرون بطون الحوامل، ويهتكون أعراض النساء، ويعتقلون الفتيات، ويقطعون أوصال الأطفال".
وترفض "أم ربيع" أن يُقال إنَّ مخيّم تل الزعتر "سقط"، حيثُ تقول: "لم يسقط مخيّم تل الزعتر، لأنَّ شبابنا صمدوا بعد خروج الأهالي أكثرَ من يومين، وقاوموا حتى نفاذ ذخائرهم، وسطروا ملاحم بطولية، وخرج عددٌ كبير منهم باتجاه الجبل فاستشهد بعضهم وفُقِد الكثير منهم".
وتضيف "نُقيمُ في مخيّم البداوي منذ الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في حي أسميناه حي مخيّم تل الزعتر، وكل عائلاته من أبناء المخيّم الشهيد. لقد تمكّنا من بناء أنفسنا وأولادنا من جديد، ولكن الذاكرة لم تُمحَ مع مرور الأيام بل هي دائماً محط أحاديثنا، وحتى في بلاد الاغتراب توجد روابط لأبناء تل الزعتر، ونحن نحرص على إحياء ذكرى المجزرة لمحاسبة القتلَة بإعادة تحريك هذه القضية وإحياءً لذكرى شهدائنا الأبطال الذين رسموا خارطة المخيّم بدمائهم، وحافظوا على كرامة شعبنا الفلسطيني".
خليل شمس: تل الزعتر حلقة في مسلسل نكبات شعبنا
كان ابن 14 عاماً يوم شهدَ مجزرة المخيّم. مشاهد موجعة تخترق مخيّلته وهو يحاول استحضارَ أحداث تلك الأيام بترتيبها الزمني، فيشرع بالتحدّث قائلاً: "في بداية الحصار كان للثورة الفلسطينية الفضل في الدفاع عن المخيّم، ولكن في قلب الحصار نفسه أصبحَ ابن المخيّم هو الموجود وهو الذي يدافع عن أهله وناسه، وكنتُ آنذاك شبلاً في حركة "فتح". ومع مرور 20 يوماً على الحصار، شحَّ الطعام والمياه، وكنا نضطّر للمشي مسافة 4 كلم من المخيّم الفوقاني للمخيم التحتاني حتى الدكوانة لجلب المياه، حتى أنّ عمتي أصيبت وفقدت قدرتها على الحركة بسبب غالون ماء كانت ذاهبةً لملئه! ونتيجةً لندرة المياه وعدم الاستحمام انتشرت آفة القمل. وأحياناً كانت تدخل للمخيّم بعض البقوليات كالعدس والرز والحمص بـ(تريلات) للمقاومة من العراق والجبهة العربية، أمّا الخبز وسائر أنواع الطعام فلم تكن متوفرة".
ويردف "خلال الأحداث أُصيب أبي في محور جسر الباشا، وانفجرت قذيفة فوق رؤوسنا فأصيب أفراد من عائلتي، كما استشهدت عمتي و4 من أبناء خالي ووالدتهم وعائلة ابو جمال شمس، واستشهد عمي بفعل اصابته بالغرغرينا وعدم وجود الأدوية، وذلك بعد تعرّضه لإصابة في فخذه عند محور لحركة "فتح" في المكلّس كان تحت إشراف عمي "أبو محمد" عيد، إضافةً إلى استشهاد ابنته وأبنائه، ومن عائلتنا وحدها استشهد نحو 22 شهيداً جُلّهم من أبناء حركة "فتح".
ويتابع "مساء الأربعاء 11/8/1976 وصلَنا خبر أن المخيّم قد سقط، فعدنا من الدكوانة للمخيّم القديم، البعضُ أراد الخروج عن طريق الجبل، وما زال مصير معظمهم مجهولاً، وآخرون تجمّعوا على رأس الدكوانة، وجُلبَت (الكميونات) لنقل الناس من الدكوانة للمتحف، وأخذوا يضعون الناس فيها بعضهم فوق بعض (أهلك مش أهلك المهم تطلع بالكميون)، فضعتُ عن أهلي. وعند المتحف رأيتُ المسلّحين يفرزون الناس، ويأخذون الفلسطينيين منهم ليعدموهم واقفين إلى الجدران. أذكر أننا يومَ خرجنا (طلعنا حافيين ما معنا شي)، وتوجّهنا لاحقاً إلى الدامور حيثُ أقمنا حتى العام 1982، وأثناء الاجتياح سافر بعض أبناء تل الزعتر ومن بينهم اخوتي إلى المانيا وأسسوا كياناً لأنفسهم، وتنقّلنا نحن حتى حطَّت بنا الرِّحال في مخيّم البداوي".
ويؤّكد خليل شمس، وهو اليوم مسؤول لجنة القطاع "د" وعضو في اللجنة الشعبية لمخيم البداوي، أنَّ أهالي تل الزعتر رغم ما مروا به من نكباتٍ لم ينكسروا بل بقوا متماسكين، ويضيف "رغم تشتُّتنا على صعيد مخيمات لبنان وعلى صعيد دول العالم ولكن وحدة الألم والقضية تجمعنا، فالجميع سقط لهم جرحى وخسروا شهداءَ ومفقودين وبيوتاً وممتلكاتٍ، وما زلنا محتفظين بكل ذكرياتنا عن مخيّمنا ومأساته. واليوم تسكن 160 عائلةً من تل الزعتر في هذا الحي في مخيّم البداوي الذي اسميناه حي تل الزعتر لتبقى ذكرى المخيّم راسخةً في الأذهان، ونشكرُ أهل مخيّم البداوي على حسن استقبالهم لنا، فهم فتحوا لنا بيوتهم ولم يعاملونا كضيوف، واليوم تمكّنا من تجاوز المحنة وربّينا أبناءنا الذين أسّسوا عائلاتٍ بدورهم، ونشكر كلَّ مَن ساعدنا، ونؤكّد أنَّ قضية تل الزعتر هي قضية كل الشعب الفلسطيني الذي لحقه الظلم في كثير من المحطّات، فمنذُ أيلول الأسود بدأت محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكان تل الزعتر العمود الفقري للثورة، ويومَ نكبة نهر البارد كنتُ من السبّاقين لمساعدة أهالي البارد وفتحنا لهم بيوتنا لئلا يعيشوا ما عشناه من مأساة، لذا علينا كشعب أن نحافظ على وحدتنا وتكاتفنا وأن نُحبَّ بعضنا".
سهام قدورة "أم جمال": الأمل كان حافزنا للاستمرار
سهام قدورة كانت أمّاً عشرينية لثلاثة أطفال حين حصلت مجزرة تل الزعتر، وكغيرها تذكر ذات السياق لتصاعد الأحداث حتى حدوث المجزرة، وتضيف "مجردُ محاولةِ الرجوع بالذاكرة يشعل في نفسي الشعور بالمرارة والقهر وكأنني أعيش الكابوس مرة أخرى. عشتُ طفولتي وصباي في مخيّم تل الزعتر، ولم أتخيّل أنني سأقف يوماً في وجه الموت لأنجو بأطفالي".
وتتابع "ما مرَّ علينا أقسى وأدمى وأوجع من أن يُحكى، كان الموت يحيط بنا قصفاً وقنصاً وجوعاً وعطشاً. كثيرون حاولوا الخروج من المخيّم لجلب الطعام والشراب للأهالي ولكنَّ معظمهم لم يعودوا، باستثناء قلة بينهم والدي الذي عادَ آنذاك وقد حمَّل سيّارته بشوالات من السكر والعدس والسجائر، فكان العدس طعام الأهالي الوحيد منه يُعدّون الطعام ويطحنونه خبزاً".
وعن خروجها من المخيّم تقول: "الثاني عشر من آب لم يكن تاريخ سقوط المخيّم بل تاريخ الخديعة التي أخرجوا بها أبناء المخيّمات، إذ قالوا لنا إنَّ سيارات اسعاف تنتظر الأهالي في الدكوانة لنقلهم لمكان آمن، وأن أحداً لن يتعرَّض لنا، فخرج آلاف الأهالي، لنُفاجأ باعتداء المليشيات على مَن خرج بالرصاص والسلاح الأبيض، وإعدام الكثير من الرجال والشبان، واقتياد النساء لجهات مجهولة، ويومها خرجتُ أنا وأولادي الثلاثة وكان أكبرهم جمال ابن السنوات الأربع، وأمي ووالدي واخوتي الأحد عشر، كنا نسير خلف والدي وفجأة اقتادتهُ الكتائب المسلّحة لجهة مجهولة، وجعلتُ شقيقتي الأصغر مني تمسك ابنتي لأنهم كانوا يقتادون الفتيات العازبات بشكل خاص، ووسط هول ما يحدث فوجئت بأحد الكتائبيين المسلّحين يضع الطرف المدبَّب من البندقية في خاصرتي، ويقتادني بالقوة إلى منطقة مليئة بالأبنية المهدَّمة، ذعرتُ وخشيتُ إن قاومتُه أن يقتلني وعندها ماذا سيحل بأبنائي؟! وفي الطريق لمحتُ أمي وهي تحمل أخي الصغير على مسافة منا في الجهة المقابلة، وما أن رأتني حتى أخذت تصرخ باسمي بأعلى صوتها وهي تضرب بيديها على رأسها، كم آلمني هذا الشعور، ولكنني استمديتُ منها القوة، وأخذتُ أفكر بطريقة للهرب من الشاب قبل الوصول إلى الوجهة التي يقتاد الفتيات إليها، وفي تلك اللحظات، ظهرَ شاب مسلّح آخر يقتاد فتاة، وعندما التفت مُقتَادي صوبهما اغتنمتُ الفرصة وركضتُ بأقصى سرعتي، وتمكّنتُ من الهرب بحمدالله، واجتمعتُ بعائلتي وخرجنا بعأ ان أخذوا منا ما حملناهُ من مال أو مجوهرات. وأقمنا فترة عند أقارب لنا في الداعوق، ثم انتقلنا للعيش في بلدة الغازية في الجنوب اللبناني، ثُمّ في صيدا، وبدأنا حياتنا من الصفر كما يقولون، وكانت مرحلةً صعبة جداً علينا، فقد كافحت والدتي رغم مرضها وعملت لرعاية وإعالة أشقائي وشقيقاتي في ظل غياب والدي الذي لم نعرف عن مصيره شيئاً حتى اليوم، ولكننّا لم نيأس، وتجاوزنا هذه المرحلة بمشيئة الله وبمساعدة الأهل والأقارب، وبعد أن خسر زوجي ورشة الموبيليا خاصته في المخيّم، بدأ العمل من جديد في محل صغير في المدينة الصناعية في صيدا، وأصرَّت أمي على أن يستكمل أشقائي تعليمهم، لإيمانها أنَّه السلاح الوحيد في يدنا للخروج من هذا الواقع، ومعظمهم اليوم خريجو معاهد وجامعات، وكذلك الأمر بالنسبة لأبنائي".
وتضيف "أم جمال": "منذُ البداية كان من الواضح وجود مخطّط يُحاك من قِبل القوات الانعزالية اليمينية المتطرفة بهدف القضاء على المخيمات، وعلى رأسها تل الزعتر نظراً لوجوده في منطقة صناعية حيوية واقعة في القسم الشرقي من بيروت، وعند حدوث المجزرة لم تكن هناك وسائل إعلام وفضائيات تغطي ما يحدث من إجرام، ولم تنل القضية الاهتمام المفترَض محليّا وعربياً، وإنما طُويت صفحتها وكأنَّها حادث عرضي بسيط".
وتختم بالقول: "رغم محاولتهم إنهاء وجودنا إلا أننّا تمكّنا بقوة إرادتنا من صناعة حياة جديدة من الحياة التي سلبوها منا، فهم كانوا مخطئين لأنّهم راهنوا على استسلام شعب لم تهزمه النكبة ولا المجازر ولا التهجير، ولا تمكّنت من احباط عزيمته لأنّ ما يبقينا صامدين هو أملنا بالعودة إلى الوطن. ونحن اليوم بعد 40 عاماً على مجزرة تل الزعتر و68 عاماً على النكبة نطالبُ كلَّ طرف شارك في المجزرة بالاعتذار من شعبنا الفلسطيني، ونطالبُ الدولة اللبنانيّة بالكشف عن مصير المفقودين ورفاة شهداء المخيّم، التي لم يُعرَف مكان دفنها بعد أن سوَّت جرافات الكتائب أبنية المخيّم بالأرض، ونؤكّد أنّنا كنا وما زلنا وسنبقى متمسّكين بحق العودة إلى وطننا طال الزمان أم قصر".
بعد 40 عاماً المئاتُ مجهولو المصير والقبور!
على الرغم من مرور 40 عاماً على المجزرة المروِّعة، لم تُفتَح أيُّ تحقيقات جديّة في عمليات القتل والتصفية التي حدثت لسكان مخيّم تل الزعتر منذ ذلك الحين، ولم تُبلَّغ مئات العائلات بمصير أبنائها، وما يزال المئات من ضحاياها جثثاً بلا قبور معروفة حتى اللّحظة.
وقد أكَّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانٍ صدرَ عنه الجمعة 12/8/2016، أنَّ "الشهادات المختلفة تشير إلى أنَّ ما استُرجِعَ من جثث الضحايا يُقدَّر بالعشرات فقط"، وأنَّ "مجزرة تل الزعتر وما تبعها من تجاهل تُشجِّع على سياسة الإفلات من العقاب التي تسيطر على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان"، داعياً إلى أن تكون ذكرى المجزرة البشعة "منطلَقاً لوضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها اللاجئون والفئات المستضعفة في كل أماكن إقامتهم".
وأشار المرصد إلى أنَّ إبقاء جثث الضحايا لتلك الفترة الطويلة من الزمن بدون قبور معروفة تؤويهم أو مدفونةً في أماكن عامَّة هو "انتهاكٌ لحرمة وكرامة جثث الضحايا وعائلاتهم، ما يوجب على كافة الأطراف في لبنان، وخاصةً الحكومة اللبنانية، ضرورة فتح هذا الملف والعمل على استعادة المفقودين وجثامين الضحايا أو معرفة أماكنها وتبليغ الأهالي بها".
قد لا يخطر ببال مَن يمرُّ اليوم بالطريق العام المحاذي لتل الزعتر أنَّ حياةً سابقةً كانت هناك، وأنَّ هذه الأرض الوعرة التي تحمل على ظهرها عدداً من المصانع ارتوت يوماً من دماء أبرياء سُفِكَت كلّ ذنبهم أنهم كانوا فلسطينيين عصيين على الانكسار، وما زالت تحملُ في جوفها جثامينَ لأحباء لا يعرف ذووهم مكان رقادهم الأخير. لكنَّ المؤكّد أن هذه المجزرة ستبقى حاضرةً في أذهان أبناء شعبنا الذين يزرعونها مع بذور الإرادة والصمود في الأجيال الجديدة، وكلُّهم أملٌ أنه سيأتي يوم يُحاسَب فيه المجرمون الطلقاء على ما اقترفت أيديهم، وسيطلع من العتمة نور يُحيلُ محطّات لجوئهم عودةً مظفّرة.













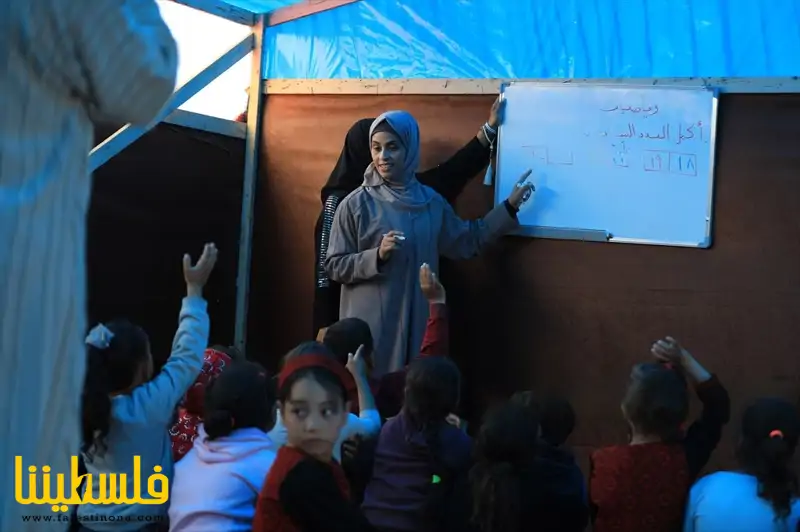
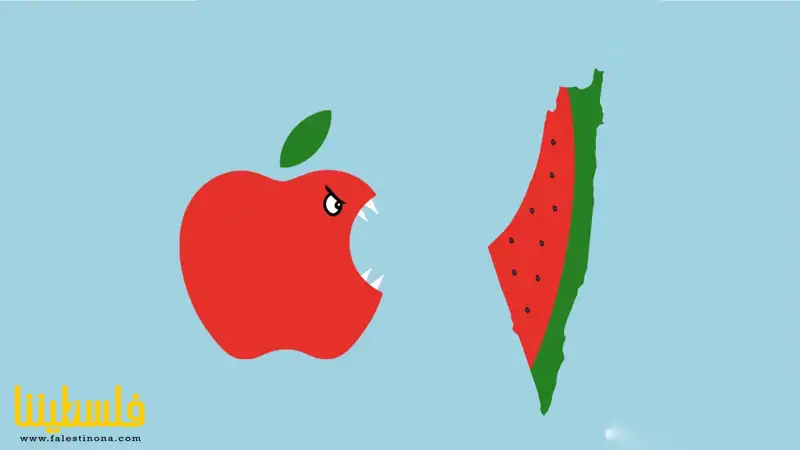


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها