شخصيّتان بارزتان احتلّتا مكانة مميّزة بالفهلوة، والبلطجة، والعنصرية، والديماغوجيا، وسوء الأمانة، والخسة والنذالة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كلاهما صعد للحُكم، وتربّع على سُدّته بكل ما سبق ذكره.
لو توقَّفنا أمام ما أدلى به مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس ترامب مؤخّرًا أمام لجنة الإصلاح والإشراف في الكونغرس، ودقَّقنا في دلالاتها، لوجدنا ما ذُكِرَ آنفًا ينطبق عليه، حيثُ قال ثلاث كلمات، اختزل فيها سمات وخصال الحاكم الأميركي الفاسق: "عنصري ومحتال ومخادع". لا داعي لإضافة أية صفات أخرى، لأنَّها تكفي لتشخيص مكانة وموقع الرجل. الأمر الذي يحتِّم وضعه في المكان، الذي يليق به، وليس رئيسًا للشعب الأميركي، لأنَّه غير أمين، ونصَّاب، وعنصري، وبلطجي، ومستعد لارتكاب أيّة جريمة، أو أيِّ عمل لا يمت بصلة للقانون والمصلحة الأميركية العامة، وهو ما يهدِّد، وهدَّد فعلاً الدور المركزي للولايات المتحدة، وترك آثارًا خطيرة على مستقبلها ووحدتها، وآفاق تطورها.
رجلٌ ترفع عليه ست عشرة ولاية قضايا أمام المحاكم الأميركية لعزله، ولرفض الفيتو، الذي استخدمه لتمويل الجدار العنصري على الحدود الأميركية المكسيكية، أي ثلث الولايات المتحدة المكوَّنة من خمسين ولاية. فضلاً عن كمِّ الأزمات التي ورَّط بلاده فيها على المستويين الداخلي والخارجي، تكشف للقاصي والداني، أنّه ليس أهلاً لقيادة شركة، ولا مؤسسة، فكيف وهو يملك بين يديه زمام الحكم لقرابة 340 مليون أميركي؟ ما هو مصيرهم؟ وإلى أي جهنم يأخذهم؟
كلُّ الدلائل تشير إلى أن نجاحه في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، كان نجاحًا للعنصرية البيضاء، وقهرًا للديمقراطية، ووصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام 1776، وانحدارًا نحو الإفلاس السياسي والأخلاقي والثقافي.
وفي المقابل يتَّسم صديقه وحليفه المقرَّب نتنياهو بذات الخصال، وفق تهم الفساد، التي أعلن المستشار القانوني لحكومته، مندلبليت، أنّه سيوجه له لائحة الاتهام بها، وهي القضايا: 1000 و2000، و4000، بالرشوة، وسوء الأمانة، والاحتيال، وحدث ولا حرج عن العنصرية الصهيونية، التي يتغنَّى بها، والتي تمظهرت بأبشع صورها في عهد حكوماته الأربع.
نتنياهو الليكودي استعمل أيديولوجيا اليمين المتطرّف الصهيونية، والكراهية، والديماغوجيا، والتلاعب بالقانون، وكرسي الحكم لحسابه الخاص، وللحفاظ على بقائه في سدة الحكم. واستغلَّ موقعه لنهب المال، والاستئثار بالهدايا من أصحاب رؤوس المال لصالحه، ولصالح زوجته وعائلته الصغيرة، ونصَّب نفسه رقيبًا على وسائل الإعلام، التي ارتضى أصحابها العمل كخدم للترويج له، فاستغلَّ رحلاته المكوكية لدول العالم للادعاء، بأنّه محل احترام وتقدير عند قادة الدول، وأنَّه يحقق إنجازات سياسية للتغطية على فضائحه ومفاسده.
صفات الرجلين لستُ أنا قائلها، إنَّما أقرانهما من قيادات الأحزاب في البلدين، ورجال الإعلام، ورجال القانون، ومن شهد عليهم أمام المحاكم (شهود الملك)، ودونيتهم، وتفاهاتهم، ورخصهم في ابتذال مراكز القرار لحسابات ضيقة، وشخصوية، ونتيجة نزعات نرجسية.
كلاهما ساقط أخلاقيًّا، وسياسيًّا، ولص صغير، ومحتال، وأفّاق، ومأزوم، يُجيّر كلَّ مراكز القرار لصالحه، ولمنفعته، ولخياراته المجنونة واللاديمقراطية. وإن دلَّ هذا على شيء، فإنَّه يدل على صعود البناء الفوقي في كلا البلدين إلى مستويات جديدة من التصدع، والتفكك، حتى وإن بدا متماسكًا بالمعايير النسبية. فالبُعد الشكلي للتماسك، بات مؤقّتًا، غير أنَّ مركبات البناء آخذة في التفتُّت التدريجي، وانعكاس ذلك يتمثَّل في:
أولاً، وجودهما في الحكم.
ثانيًا، تبوُّؤ أنصارهم من اللصوص، وقطاع الطرق، والدجالين مراكز أساسية في الحكم.
ثالثًا، تحالفهم مع شياطين رأس المال العالمي على حساب مصالح دولهم وشعوبهم.
رابعًا، ضرب ركائز الديمقراطية حتى بالمعايير الشكلانية.
خامسًا، اختلاق الأزمات نتاج التخبّط السياسي والاقتصادي.
سادسًا، تجاوز الدستور والقانون، والتعدي على المصالح العامة للدولة، وليس للنظام السياسي فقط، إلخ.
النتيجة المنطقية لبقائهما في الحكم تهديد السِّلم الأهلي في البلدين، وتهديد السِّلم الإقليمي والعالمي مع دول الجوار، ومع دول العالم، كما في الحالة الترامبية، الأمر الذي يُملي ضرورة إسقاطهما، وعزلهما، وإن كان وصولهما للحكم، هو النتاج الطبيعي لأزمة عميقة في المجتمعين، ولن تُحلَّ بمجرَّد خروجهما، بل تحتاج المجتمعات إلى ثورات على الواقع القائم، وتغيير جذري في مؤسسات البناءين التحتي والفوقي.















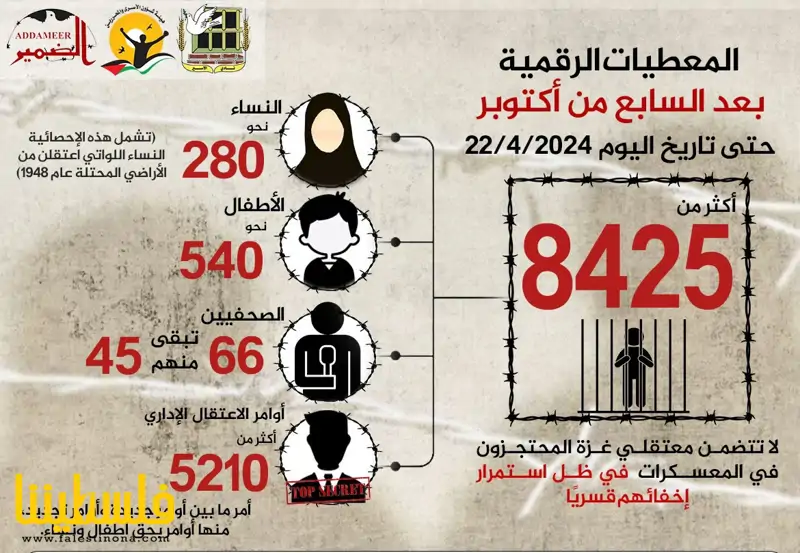


تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها