خاص- مجلة "القدس" العدد 347 ايار 2018
تحقيق| مصطفى ابو حرب
شكَّلَت مرحلةُ التهجير من فلسطين إحدى أكثر المحطّات صعوبةً في حياة أبناء شعبنا، فليس بالهيّن أن يُضطَّر الفلسطينيون مُرغَمين على تركِ منازل بناها أجدادُهم قبل مئات السنين لينطلقوا في مسيرةٍ طويلةٍ محفوفةٍ بالمخاطر بحثًا عن الأمن والملاذ. ومع حلولِ الذكرى السبعين للنكبة، يستذكرُ اللاجئون في لبنان خروجَهم القَسريَّ من قُراهُم ومسارَ رحلتهم وصولاً إلى المخيَّمات.
"أبو وليد": ألمُ فراق الوطن يفوق أيَّ ألمٍ جسديٍّ
بسلامٍ وطمأنينةٍ كان يعيش أهالي بلدة شفاعمرو شمالي فلسطين كما يروي ابن البلدة والمولود فيها الحاج محمد مصطفى العبد "أبو وليد" (93 عامًا) لمجلة "القدس" مُنوِّهًا بحالة الوئام والتعايش المشترَك التي كانت سائدةً بين المسلمين والمسيحيين والدروز قبل مجيء الحركة الصهيونية التي حاولت بثَّ سمومها بين أبناء البلدة الواحدة، وبذلت جهدها لشراء أراضي الأهالي. ومع شعورهم بخطرها الداهم، شرع الأهالي في شراء السلاح للاشتباك مع العصابات الصهيونية التي حاولت احتلال البلدة عدّة مرات.
ويُضيف "أبو وليد": "في إحدى الليالي هاجمت الطائراتُ الصهيونيةُ شفاعمرو، فخرجت العائلات إلى الضواحي، وعدنا في الصباح، ولكنَّ الطائرات عادت لتُغيرَ مرة أخرى على أحياء البلدة، ما دفعنا لمغادرتها وسط ذعر الأهالي وبكاء الأطفال باتجاه بلدة كفرمندة، ومنها إلى صفورية حيثُ أقمنا عدّة أيام، وهناك سمعنا أنَّ الصهاينة احتلوا شفاعمرو، وسَرَت أخبارٌ عن مهاجمة القرى القريبة من صفورية، فتركناها، وسِرنا على الأقدام نحو حدود لبنان في رحلةٍ كانت أصعب تجربةٍ خضتها في حياتي، إذ كُنّا نسيرُ وسط خوف وهلع، ودُسنا على الأشواك حتى تضرَّجت أقدامُنا بالدماء، ولكنَّنا لم نشعر بالألم الجسدي لأنَّ ألمَ فراق الوطن كانَ أصعب".
ويُتابع: "وصلت العائلات إلى بلدة بنت جبيل اللبنانية التي أقمنا فيها 20 يومًا لم تكن خلالها أيُّ عائلةٍ تملكُ قوت عيالها، ثُمَّ انتقلنا إلى عنجر، وبعدها إلى بعلبك، وتحديدًا إلى ثكنة ويفل، وهناك بدأت مسيرةُ شقاءٍ من نوعٍ آخر".
ويُسهبُ الحاج التسعيني في الحديث عمَّا واجهته العائلات المهجّرة من صعوباتٍ ومعاناةٍ إنسانية، فيقول: "فَقَدنا الخصوصيّة العائلية، حيثُ أقمنا في غرفٍ مشتركةٍ لا يفصلنا عن العائلات الأخرى فيها سوى ملاءةٍ لا تستر شيئًا، فإذا حدَّثتَ أهلَ بيتك سَمِعَكَ الجميع، عدا عن أنَّنا كُنّا من قرى وبلدات مختلفة، وجميعنا يعيش ظروفًا صعبة، ولا طاقة لأحدٍ على تحمُّل الآخر. وفوقَ ذلك عانينا جرّاء قسوة المناخ وشدّة البرودة والثلوج في بعلبك في حين كنا معتادين على الجو الدافئ في فلسطين، واضطّرتنا الظروف للعمل في مدينة زحلة في زراعة البصل ولم نكن نعرف عن ذلك شيئًا، وكُنّا نعملُ في الصيف كي نتدفَّأ في الشتاء إلى أن جاءتنا فرصةُ الانتقال إلى مخيَّم البداوي، حيثُ أسَّسنا حياةً جديدةً، وما زلنا ننتظر العودة إلى شفاعمرو".
وعن الحنين إلى الديار يقول "أبو الوليد" بعينَين مُغرَورَقَتَين بالدموع وعبارات مُتَقطِّعة: "لا أتمنّى اليومَ سوى العودة إلى قريتي.. ولو في الحلم.. هذه القرية التي ما زالت تضاريسها حتى اليوم محفورةً في أعماق ذاكرتي وحنايا قلبي".
"أبو فوّاز": عشنا أيامًا رهيبةً من الجوع والخوف والفزع!
وُلِدَ محمد الحسن "أبو فوّاز" في قرية صفورية قضاء الناصرة، والتي كانت تشتهر بزراعة الرّمان والزيتون والصّبار، وتعجُّ بالسكان من مختلف القرى المحيطة. ومع بدء المجازر الصهيونية في القرى والمدن الفلسطينية المجاورة، نزح العديد من الأهالي إلى صفورية بحكم وجود علاقات الصداقة والمصاهرة، وأخذ الأهالي ببيع ممتلكاتهم بغية شراء السلاح للدفاع عن قراهم، كما يستذكر "أبو فواز".
وعن خروجه من قريّته ورحلة لجوئه، يقول: "في 16 حزيران عام 1948 كانت عائلات القرية تجتمعُ لتناولِ طعام الإفطار خلال شهر رمضان حين سمعنا صوتَ الطائرات تحوم فوق القرية، فغادر الجميعُ منازلهَم وتوجَّهوا إلى شمالي القرية ريثما تختفي الطائرات تاركين أمتعتهم وممتلكاتهم. وفي صبيحة اليوم التالي، دارت معارك ضارية بين شباب القرية وجيش الاحتلال الصهيوني، وأُعلِنَ عن وقوع القرية بيد الاحتلال، فتشرّد أهل القرية في الطرق، وقادتهم أقدامهم إلى قرى دير القاسي، وسحماتا، وفراضة، حيثُ عايشوا ظروفًا لا توصف من التعب والجوع والخوف، وكانت الأخبار تتوارد يوميًّا عن احتلال مزيدٍ من القرى، فأخذت الجموع المتّجهة إلى لبنان تتزايد. وبعد مسيرة يوم ونصف اليوم، وصلنا إلى قرية بيت ياحون، وأقمنا في العراء تحت الأشجار لمدة تزيدٍ عن أربعة أشهر، وكان أهالي القرى اللبنانية يُقدِّمون لنا بعض الطعام، وطيلة ذلك الوقت كُنّا نسمعُ وعودًا بقرب عودتنا الحتميّة للوطن، ولكن للأسف تبيَّن أنَّ كلَّ الوعود أكاذيب".
ويُردف "أبو فوّاز": "بعد فترة، نقلت الدولة اللبنانية جميع اللاجئين إلى منطقة القرعون، وأقمنا في ثكنة عسكرية مهجورة، حيثُ تولَّى الصليب الأحمر اللبناني مسؤوليتنا، وبدأ يُقدِّم لنا حصة غذائية يوميّة لكلّ فرد قوامها رغيف خبز وبعض الحبوب. وقد عانينا ذلّ التهجير ومهانة الحاجة وقساوة الطقس وعدم توفُّر الأدوية اللازمة ما أدَّى لوقوع بعض الوفيات. وكانت تقطن كلَّ مبنى من هذه الثكنة أكثر من عشرين عائلة لا يفصل بينها سوى بعض الملاءات المربوطة بالحبال كـ"ستار"، وكانت حصة العائلة الواحدة مساحة 3 أمتار فقط للنوم".
أمَّا عن الوصول إلى المخيّم فيقول: "في العام 1950 حضرت شاحناتٌ ونقلتنا إلى نهر البارد الذي كان آنذاك تلةً مليئةً بالنباتات البَرية، ووُزِّعَت الخِيَم على العائلات، وبدورها كانت تلك الفترة عصيبةً علينا بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج، وتطايُرِ الخيم أو وقوعها على رؤوس أصحابها وهُم نيام"، موضحًا أنَّ حال الفلسطينيين لم تأخذ بالتحسُّن إلا بعد إنشاء وكالة "الأونروا" ومباشرتها تقديم الخدمات للاجئين.
"أم عصام": لم تنتَهِ مأساتُنا بالتهجير بل تواصلت حتى في المخيّم
وُلِدَت الحاجة فاطمة زغموت "أم عصام" عام 1927 في قرية الصفصاف شرقي مدينة صفد. ورغم الأمن الذي شهدته القرية في الشهور الأولى من العام 1948، بحكم وجود أفواجٍ من جيش الإنقاذ العربي فيها، إلّا أنَّ حالة الطمأنينة لم تدم طويلاً، إذ ما لبثت ظلال الحرب أن خيَّمت على القرية، وبعد أن كانت ملاذًا للهاربين من قرى أخرى تعرّضت للهجوم، تحوَّلت الصفصاف لمسرحٍ لإحدى أعنف المجازر الدموية، بحسب ما ترويه زغموت لـ"القدس".
وحول تفاصيل العدوان الصهيوني على الصفصاف تقول: "فجر 29 تشرين 1948، تعرَّضت قريتنا لهجوم صهيوني عنيف من كلِّ الجهات، وأقدموا على ربط 52 رجلاً بحبالٍ وألقوهم في بئر وأطلقوا الرصاص عليهم، كما قتلوا 10 نساء، على مرأى من جيش الانقاذ الذي لم يحرّك ساكنًا فيما وقف أبناء القرية وحيدين يدافعون عن أهلهم. وبعد دفن الشهداء ومعالجة الجرحى بطريقة سريعة، فضَّل الأهالي ترك القرية خوفًا من أن يرتكب العدو الصهيوني مجازر جديدة بحق الأهالي أو يتعرّض للنساء، فغادرنا جميعًا القريةَ تحت جنح الظلام. ولقرب الصفصاف من الحدود اللبنانية عَبَرَ معظم الأهالي الحدود باتجاه بنت جبيل حيثُ وجدنا العديد من أبناء قرى الجليل الذين كانوا قد خرجوا قبلنا من قراهم هربًا من المجازر وصونًا لأعراضهم، ولاحقًا توجَّه بعض أبناء الصفصاف إلى سوريا، أمَّا مَن بقوا في لبنان فمعظمهم سكن في مخيَّمات عين الحلوة، والرشيدية، والبداوي".
وتشير "أم عصام" إلى أنَّ عائلتها كانت ممَّن توجَّهوا إلى مخيَّم البداوي شمالي لبنان، لافتةً إلى أنَّ المأساة لم تنتهِ بالتهجير، بل تواصلت مع صنوف المعاناة التي واجهها الأهالي في المخيّم بسبب الفقر، وظروف السكن، والمعيشة الصعبة.
وتُضيف: "صحيحٌ أنَّنا ذقنا الأمرَّين في المخيَّم، ولكنَّنا حافظنا على عائلاتنا، وسكنّا، كأهالي قرية الصفصاف، بجانب بعضنا البعض، وحمينا وجودنا، ونلنا احترام الناس. وبرغم الجوع والحاجة، لم نذلّ أنفسنا، وحافظنا على كرامتنا، وبالعزيمة والإرادة وفَّرنا التعليم لأبنائنا، وأسَّسنا حياةً محترمةً، وانخرَطنا في الثورة، وقدَّمنا الشهداء والجرحى في سبيل العودة، ولي كلُّ الشرف بأنَّني أُمٌّ لشهيد، وحتى هذه اللحظة ما زلتُ على استعداد للشهادة وتقديم كلِّ أبنائي فداء لفلسطين".
وبشوقٍ وحنينٍ يسكنان أعماقها تختم "أم عصام" كلامها قائلةً: "أُمنيتي أن أموت هناك، في الصفصاف، ولكن عندما تصبح محرَّرةً لا تحت سيطرة الصهاينة، وكم كنتُ أتمنى لو كان الشهيد ياسر عرفات حيًّا ليشهد معنا هذا اليوم الذي باتَ قريبًا إن شاء الله".
ويبقى أملُ العودة قوتًا يوميًّا للفلسطينيين يخفّف عنهم وجع فراق الوطن وضيق العيش، فكلّما استذكروا نكبتهم وما خلّفته من آلام جسدية ونفسية في وجدانهم، زادوا تمسُّكًا بأملِ أنَّ العودة حتمية وقريبة بإذن الله.













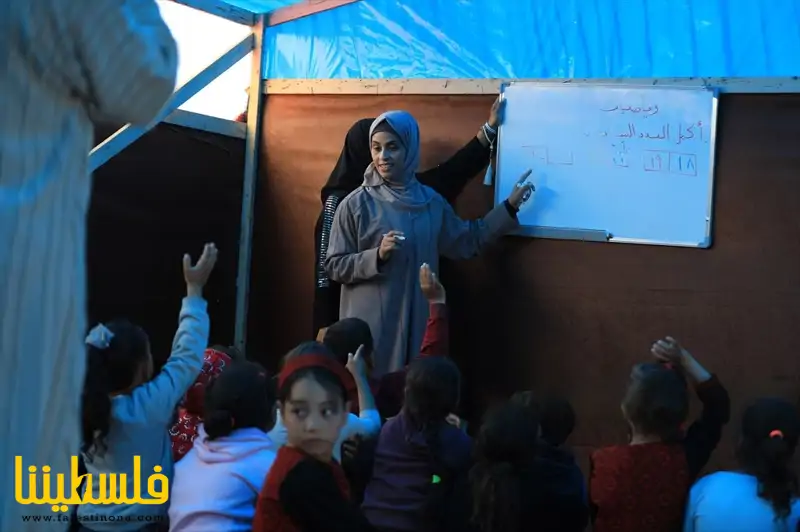




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها