مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية لمختلف مكونات المجتمع العراقي بكافة أشكاله وتلاوينه السياسية والاجتماعية والأثنية والعرقية، وبطريقة لا تخلو من استفرادية ضيقة بعدما أصبح كل تجمع يطرح متطلباته وشعاراتها بمعزل عن اي مكون آخر، وهذا الأمر يبدو أنه السبب الرئيسي والأساسي في تعقيد الأمور العراقية وتفاقم الأزمات بدلاً عن محاولة إيجاد الحلول الشاملة والعامة لمختلف المشاكل التي يرزح تحتها المجتمع العراقي.
فبعدما كانت الأمور وبمختلف جوانبها قد وصلت إلى درجة من التعقيد ايام حكومة الرئيس الأسبق نوري المالكي الذي تفاقمت خلال عهده المشاكل بصورة لم يكن العراق قد شهدها من قبل، وهي بمعظمها عائدة إلى أسلوب المالكي نفسه، حيث إزداد الفساد الإداري والسياسي بطريقة جعلت من العراق من أول الدول المصنفة بالفساد المستشري. جاءت حكومة حيدر العبادي تحت عناوين إصلاحية وفي محاولة معالجة ما أفسدته السياسات العراقية ورموزها التي جاءت بعد سقوط نظام صدام حسين وما رافقها من إنهيار لمعظم المؤسسات بما فيها الادارات العامة وعلى رأسها الجيش وطبقاً لمخططات أميركية كانت قد وضعت حيز التنفيذ منذ أيام "الحاكم الأميركي" وهي للأسف مخططات نفذت بحذافيرها كما وضعها ذلك الحاكم.
ورغم محاولة رئيس الوزراء الحالي البدء بسياسة اصلاحية بدأها برأس الهرم السياسي من نواب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين الذين أثخنت بهم الادارة بلا سبب، إلا أسباب الترضية السياسية وتقاسم المراكز والوظائف العامة. وكل ذلك أضيف إليه جيش كبير من موظفي القطاع العام دون أن يكون لهم أي مبرر أو ضرورة.
وابتداء "مسيرة الاصلاح" المرجح أن تكون طويلة لآلاف الأميال بالخطوة الأولى وهي معالجة الفساد من الرأس أولاً وهو على قناعة أن العطب فيه، ولذلك أصر منذ اللحظة الأولى لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة التي خلفت حكومة سلفه المالكي بأن تكون من "التكنوقراط"، وبعيداً عن المحاصصة السياسية التي كانت السبب والأصل في وصول العراق إلى هذا المستوى من الاهتراء السياسي والتراجع الاقتصادي والتدهور الأمني الكبير.
لكن هذه الدعوة لم ترق لكثير من القوى السياسية وخصوصاً من "خصمه اللدود" نوري المالكي رئيس تكتل دولة القانون، التي ثبتت أنها لا تحمل من صفات القانون الا الاسم وحسب.
ففي الوقت الذي انطلق فيه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في خطته الاصلاحية لمعالجة الفساد المتعدد الجوانب وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بلغت ذروتها في عهد المالكي عن هدر أموال فاقت 800 مليار دولار على الرغم من استئناف العراق لتصدير النفط لم يعرف إلى أين وكيف ضاعت؟!
فقد واجهت القوى المتضررة من هذا الاصلاح لكشف حقيقتها من خلال النظرة لهذه الزعامات التي ترى في العراق بأنه ليس إلا منجم للذهب وكنز دفين لا ينضب تسعى للاستحواذ عليه بشتى الطرق والوسائل بما فيها غير المشروعة أو المألوفة في مثل هذه الحالات الصراعية على السلطة والمكاسب، ولهذا يحاول كل تيار منها أن يفرض سيطرته على أكبر مساحة ممكنة من أرض العراق ليساوم بخيراتها الآخرين فيما بعد على أساس الشراكة، وكأن الأمور في النهاية بالنسبة لهم ليست سوى تجارة بتجارة، ولهذا تحاول معظم القوى السياسية تغليف الصراع السياسي بالأصل بمفردات وأجندات طائفية ولتوظيف الانتماءات الطائفية والمذهبية لأبناء الشعب العراقي في صراعها مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى أهداف سياسية تتمثل بالاستحواذ على السلطة السياسية والموارد الطبيعية للعراق، وعلى هذا الأساس يتبين أن المشروع الذي تعمل هذه القوى السياسية على تحقيقه في العراق ليس مشروعاً وطنياً لبناء دولة مواطنة "يتعايش" فيها الجميع ولهم فيه نفس الحقوق والواجبات بل هو مشروع يهدف إلى تحويل العراق إلى كانتونات طائفية وعرقية تقودها وتتحكم بها هذه القوى وتسكنها مجاميع بشرية أحادية الانتماء يراد منها أن تنعزل عن بعضها البعض ثقافياً وسياسياً والأهم إقتصادياً والأكثر إيلاماً أمنياً، ربما يصل بها الأمر في نهاية المطاف إلى إلغاء العراق الحالي واستبداله بعراقات مختلفة تماماً عما هو حالياً أو ما تبقى منه على الأقل.
فما حصل في شمالي العراق (إقليم كردستان) لجهة بناء تشكيله السياسي والمؤسساتي وحتى جيشه الخاص "البشمركة" يشير الى الوجهة النهائية لهذا الأمر، وما عززه ما تم طرحه مؤخراً في شمالي سوريا حول "الفيدرالية الكردية" يصب في هذا الاتجاه.
وهذا الأمر بدأت ملامحه جدياً في الوسط السني والجنوب الشيعي اللذان يعانيان من مشكلات معقدة وشائكة تتجسد في الخلافات ما بين قيادته الدينية والمذهبية من جهة والسياسية من جهة ثانية والتي تثبت أيضاً أن لكل منهما حساباته الخاصة ورؤيته المستقبلية "للعراق" القادم.
فالصراع ما بين القيادات الشيعية الدينية يمثلها السيد مقتدى الصدر الملتزم بالمرجعية الكبرى آية الله على السيستاني والسياسية التي يمثلها نوري المالكي وهو صراع وصل إلى درجة خطيرة استوجبت تدخل جهات خارجية لرأب الصدع وهذا الأمر كان على بساط البحث خلال زيارة الوفد العراقي إلى لبنان ولقاءاته مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في محاولة لاعادة اللحمة التي تبدو صعبة المنال نتيجة عمق الخلافات بين الرمزين الديني والسياسي على الرغم من مرافقتهم لوكيل المرجع السيستاني السيد علي الشهرستاني وهي زيارة جرت بعيداً عن وسائل الاعلام المعتادة، تجسدت في عدم التداول لهذه الزيارة بالمستوى المفترض أن يكون لها لو حدثت في غير هذه الظروف وبالمقابل هذا الأمر ينطبق على القيادات السنية في وسط العراق بما فيها العاصمة بغداد الذي يبدو أنها لن تكون موحدة هي الأخرى في حال وقعت الواقعة المؤلمة.
وهذا الأمر دفع بحركة الاحتجاجات إلى التصاعد والعودة إلى الشارع من جديد بعدما كانت قد هدأت بعد تعيين العبادي رئيساً للحكومة الذي جاء على قاعدة محاربة الفساد والذي اتخذ سلسلة من الخطوات على هذا الطريق الذي اصطدم بانسداده أمامه نتيجة تعرضه لمواجهة شديدة من قبل كثير من القوى والتكتلات السياسية التي استشعرت بأن هذه الاجراءات فيما لو استكملت الى نهايتها ستؤدي الى انتزاع مكاسبها وحصتها من كعكة السلطة الموروثة.
ولهذا عادت هذه التحركات للمطالبة بتغيير الحكومة بعد الفشل في التوصل الى تسوية تنهي المحاصصة الطائفية والتي رافقها هذه المرة اجراءات أمنية مكثفة ومشددة غير مسبوقة على خلفية الخلافات حول التشكيلة الحكومية التي اقترحها العبادي والتي أصر على أن تكون مؤلفة من شخصيات ذات كفاءة "تكنوقراط" بعيداً عن الانتماء السياسي وذات استقلالية بدلاً من وزراء مرتبطين بأحزاب يدينون بكراسيهم ووظائفهم لها.
وما زاد من بلة طين مشروع العبادي ما أقدم عليه عدد من النواب من إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري إثر تعليقه لجلسة كانت منعقدة للتصويت على لائحة حكومة العبادي والمؤلفة من 14 مرشحاً بعد التفاوض عليها مع رؤوساء الكتل السياسية.
وكان الجبوري قد طالب وحث الفصائل والقوى العراقية على بحث سبل إنهاء الأزمة ومصراً على أن "البرلمان العراقي" هو الأوحد الذي يمثل السلطة التشريعية والدستورية في البلاد... وكذلك اختلاف الرؤى لطبيعة التحركات الشعبية وخلفياتها.
فالبعض يراها فرصة لإنهاء المحاصصة السياسية قبل كل شيء والبعض الآخر يرى فيها مناسبة للمطالبة بعزل السياسيين واستبدالهم لأنهم لم يقدموا أي شيء منذ العام 2003 حتى الآن، بل على العكس كانوا يعيشون بعيداً عن هموم ومشاكل العراقيين وظروفهم القاسية من كافة النواحي وخصوصاً الاقتصادية والتي رافقتها زيادة في نسبة الفقر وبدرجات غير مسبوقة لم يعتادها العراقيون حتى في ظل الحروب والتدمير وكذلك الحصار القديم الذي كان مضروب على العراق أيام الرئيس الراحل صدام حسين.
وهذا ما يبدو أن السيد مقتدى الصدر قد التقط ما يمكن أن يوصف بالفرصة الذهبية والتي حذر في بيان أصدره متضمناً التهديد باستئناف التحركات والاحتجاجات ما لم ينجح قادة الكتل السياسية في البلاد في تسليك الطريق أمام حكومة "التكنوقراط العبادية" المستقلة ودعاها إلى التنسيق لعقد جلسة البرلمان من دون النظر أو الاستماع لاصوات المطالبين بدوام المحاصصة ومطالباً الوزراء الحاليين بالاستقالة على الفور، مهدداً بتظاهرات مليونية للضغط على السلطة بكل مكوناتها.
وعلى ما يبدو فإن الواقع العراقي الحالي يسير وللأسف نحو ترجمة ما نشرته قبل سنوات صحيفة الواشنطن بوست الأميركية والمقربة من صناع القرار الأميركي وخصوصاً الدوائر الاستخبارية مثل السي أي أيه والبنتاغون حول ما تم رسمه لمستقبل نظام العراق عبر الكونفدرالية الجغرافية والسياسية وهي هدف لا يمكن تحقيقه الا بوجود كيانات او حتى دول على الأرض وهذا لا يزال غير معلن حتى الآن بشكل صريح في العراق.
فعليه يخشى أن يكون العراق أرضاً وشعباً ومؤسسات أمام مخاطر تناحرية جديدة وعلى قواعد تؤدي، للأسف، إلى تقسيمه فعلياً.












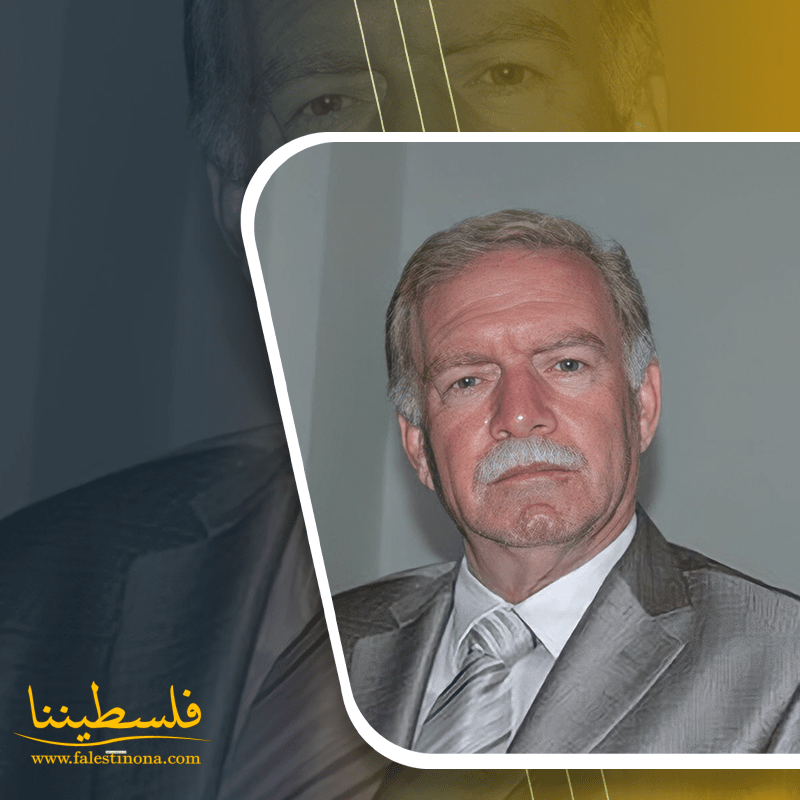




تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها