قد بات الحليم حائراً، أمام هول ظاهرة الإرهاب، التي تعصف بالمنطقة العربية، دون أن تظهر بوادر سعيدة لنهايتها، ويقف الكثيرون حائرون أمام هذه الظاهرة الخطيرة، والتي باتت شبه كونية عامة، وشرق أوسطية خاصة، يكتوي بنتائجها الجميع، والدول والشعوب العربية هي الأكثر تضرراً منها، على مستوى الأفراد والشعوب والدول، بسبب ما أدت إليه من دمار هائل وسفك لدماء الأبرياء وزعزعة لإستقرار الدول العربية، وتدمير لنسيج ترابطها المجتمعي، وإضعاف لمؤسسات الدولة، وإغتيال لإستقرارها ونموها، كخطى أساسية لتفكيك وحدة الدولة والمجتمع وإفشالهما، ومن المؤسف أن تستند هذه الظاهرة المقيتة إلى شعارات دينية، في الوقت الذي يحرم فيه الدين مثل هذه الأفعال الشريرة، تحريماً قطعياً، ويرفض كافة المبررات التي يسوقها أصحابها، ويسوقوها للعامة وللبسطاء منهم، الذين يجري تضليلهم بشعارات تحاكي الغرائز والعواطف والمشاعر الدينية أو المذهبية أو الجهوية، وتثير الغرائز والتوجسات المريبة لديهم إزاء الدولة ومؤسساتها، أو إزاء المجتمع ومكوناته المختلفة، خصوصاً وأن طبيعة المجتمعات الإنسانية تقوم على أساس التنوع والتعدد، وتلك فطرة الخالق عز وجل، التي فطر عليها الخلق في قوله تعالى:
((وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم)).
إن الحكمة من الإختلاف والتنوع هي التعارف، أي ليأخذ بعضكم عن بعض، والتعايش معاً رغم الإختلاف، على أساس من العدل فيما بينكم، رغم هذا الإختلاف أو التباين أو التنوع والتعدد، وأن أكرم الخلق عند الله، هم من اتسموا بالتقوى، وليس من اتسموا بالعنف، والقتل، والدمار، والإرهاب، والإستعلاء على الآخر، والتنكر له، والخروج على المجتمع والدولة ومؤسساتها، فالإختلاف في الدين أو المذهب أو الطائفة أو الجهة، ليس مبرراً للإقتتال والتدمير والإرهاب، أو تفكيك عرى وحدة المجتمع والدولة، وإنما هذا التنوع الثقافي، أو الطائفي، أو الديني، أو الجهوي إنما هو عناصر إثراء وإغناء، وقوة للفرد وللمجتمع وللدولة، إذا ما أُخذَ بالعبرة التي فطر الله عليها البشر وهي الإختلافُ والتعارفُ وليسَ التناكرُ ورفضُ الآخر.
إن ((ظاهرة الإرهاب)) المتلبس بشعارات الدين أو الطائفة، يطرح إشكالية في غاية الأهمية والتعقيد، تتمثل في العلاقة بين الدين أو المذهب والطائفة من جهة والفرد والمجتمع والدولة من جهة أخرى، ولا يمكن التوصل إلى حل نهائي ومستقر لظاهرة الإرهاب، والمواجهات المنتشرة في المنطقة العربية بسببها، دون تعريف جديد، وأساسي لتحديد العلاقة بين الدين، والفرد، والمجتمع، والدولة، فالدين أو المذهب هو علاقة بين الفرد وربه، لا يستطيع أن يتحكم فيها فرد أو جماعة، وسوف يسأل عنها فردياً، لقوله تعالى: ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم))، والمجتمع يقوم على التعدد والتنوع، ويشبه إلى حدٍ ما تنوع التضاريس في الدولة الواحدة، فهناك السهول الساحلية أو الداخلية، وهناك المرتفعات من جبال وهضاب، وهناك المنخفضات من الأودية والبقاع، وهناك الصحاري ...الخ، والتي في مجموعها تمثل إقليم الدولة، كما تمثل الوطن الواحد الموحد، لمجموع المجتمع بكل تنوعاته الثقافية والفكرية والقبلية والمذهبية، تجمعها وحدة المصير المشترك، ووحدة الأهداف والغايات، والمصالح الخاصة والعامة، والتي لا يمكن تحقيقها، إلا في ظل وحدة وطنية مجتمعية رغم ما أشرنا إليه من تنوع وتعدد.
الدولة، أي دولة هي دولة جميع مواطنيها على إختلاف مناطقهم وجهاتهم وثقافاتهم ومذاهبهم، فجميع المواطنين لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، وهنا تتحقق مصلحة الفرد كما تتحقق مصلحة المجتمع، في تنمية دور الدولة ومؤسساتها في حياة المجتمع، والفرد، على السواء، لما تحققه الدولة من ضمان لحياة وحقوق أفراد المجتمع كافة، وضمان حرياتهم في العيش بأمن وكرامة وسلام ومساواة تامة أمام القانون للجميع، حكاماً ومحكومين، وضمان لإستقلال الوطن ووحدته والذود عنه.
لذا من هنا تبدأ مواجهة ظاهرة الإرهاب، الذي يعصف بعالمنا العربي، بشعوبه وأفراده ودوله، فلابد من تعريف جديد، وتحديد واضح وحاسم في تحديد العلاقة بين الدين والفرد والمجتمع والدولة، على مستوى الدولة الواحدة، وهذا يقتضي جهد كبير وعميق، داخلياً يقوم على أساس تعميق الإنتماء للمجتمع والدولة وهويتها الثقافية، والقيام بالإصلاحات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وتجفيف البيئة الثقافية والفكرية التي تتغذى عليها قوى الإرهاب والتكفير والقتل والتدمير، مبررة بها الخروج على المجتمع وعلى الدولة وتهديدها لوحدتهما وسلامتهما ومستقبلهما معاً.
الإرهاب والعلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ...!: بقلم عبد الرحيم جاموس
25-05-2015
مشاهدة: 539
عبد الرحيم جاموس









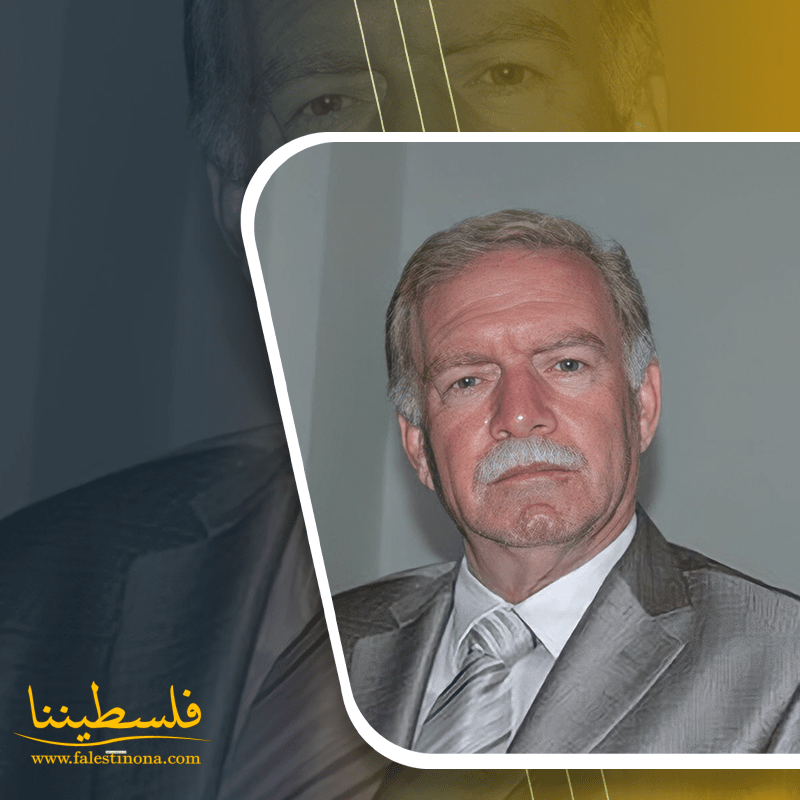
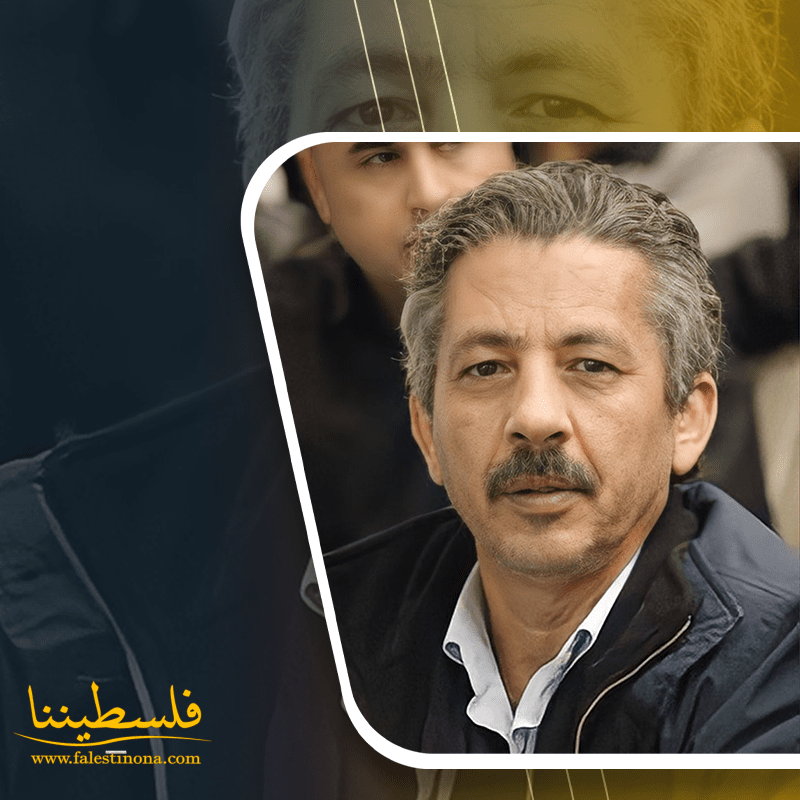





تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها