بقلم: محمد سعيــد
تنبش سامية عيسى في روايتيها "خلسة في كوبنهاغن"(2014) و"حليب التين" (2010) الصادرتين عن دار الآداب بيروت قضايا متعددة مرة واحدة بدءا من المعاناة الانسانية والحياتية والسياسية في مخيمات اللجوء، مروراً بالمجازر والاقتلاع والتهجير المبطن الذي تتعرض له هذه الأسر وما ينتج عنه من هتك للنسيج العائلي لهذه الأسر التي عاشت في المخيمات، ثم اندفعت الى بلاد الصقيع نتيجة المجازر والحصار والاختناق الاقتصادي والخوف في عملية اقتلاع جذري ضارٍ سلطت فيه الضوء على المآسي التي يعيشها هؤلاء الفلسطينيون بعد نكبة الـ 48 والاجتياح الاسرائيلي للبنان في الـ 82 والحروب المدمرة التي تعرضت لها هذه المخيمات وما نتج عنها من خراب. وهي مرحلة مختلفة عن الروايات الفلسطينية التي صدرت وواكبت النكبة الأولى وما تلاها من نضال فلسطيني، على يد غسان كنفاني واميل حبيبي كنموذجين بارزين للسرد الروائي لتلك المرحلة، التي ارتكزت على قصص مستوحاة من تداعيات النكبة وحنين العودة الى ارض الاجداد "ارض البرتقال الحزين" والتي ركزت على قدسية الارض ومقاومة المحتل ورمزية العودة بكافة الوسائل المتوفرة، والتي لعبت دورا مهما في توصيف المأساة الفلسطينية المستمدة من واقع القضية، وتأثيراتها على حياة الفلسطينيين الذين هجروا أرضهم مكرهين تحت وطأة الحرب والمجازر في تلك المرحلة. وكأن الزمن يعيد نفسه ويُخضع هذا الشعب مرة أخرى تحت ضغط المجازر والحروب الى الهجرة من مخيماته. وبحسب روايتي سامية عيسى، فالملاحظ انهما تتعرضان حصراً للمأساة الانسانية الفلسطينية في الشتات الفلسطيني، وكأنهما جاءتا لتسردا الملحمة الفلسطينية الجديدة، وما آلت اليه أحوال اللاجئين في المخيمات وديار الهجرة بعد الهجرة الأولى من أرض الوطن عبر نماذج من فلسطينيي المخيمات، اذ يواصل اهل الشتات الهجرة والتشتت تحت الضغط والحصارات المختلفة التي تحصل لهم في مخيمات لبنان ( تل الزعتر صبرا وشاتيلا) وغيرهما، وحاليا مخيمات سوريا وما نجم عنها من تهجير الى ارض الصقيع والجليد في الدول الاسكندنافية، فإذا كانت روايات كنفاني وحبيبي تحدثت عن الفلسطيني المنكوب الطامح للعودة، وتمسُّك مَنْ بقي بأرض الوطن في المرحلة السابقة فإن "حليب التين" "وخلسة في كوبنهاغن" تتحدثان عن الفلسطيني الذي ترك مخيمه واضطر مرة اخرى للهجرة بعد ان ضاقت به ارض العروبة واثخنته بالجراح، ولم تترك لمَنْ بقي في هذه المخيمات غير المآسي على كل صعيد حتى أصبحت الهوية الفلسطينية مهددة بالضياع، فاتسعت دائرة الشتات نتيجة هذه المعاناة والظروف القاسية وتأثيراتها النفسية واخضاع الفلسطينيين لأنواع من العنصرية والتهميش داخل المخيمات وخارجها وفي أماكن تواجده الكثيرة.
ولفتت الروائية الى الاحاسيس الموحدة التي تربط الانسان الفلسطيني بأرضه والتي تتجلى بحب الارض والاستفادة من الشتات كمساحة للتلاقي من أجل تجديد حلم العودة بدل الرضوخ للتعقيدات والمتاهات التي مزقت شمل العائلات، والتوجه الى الصيغة الفلسطينية الجامعة حتى لا تكون الهوية الغريبة وراء كل منفى يصل اليه الانسان الفلسطيني، بدلا من التماس المباشر في الصراع مع العدو والوقوف في وجه سياسة الغيتوات المفروضة عليه في المخيمات وحرمانه من أبسط الحقوق المدنية وحرية الحركة والعمل والعيش بأمان، وقد وجدت الكاتبة أن مشاكل أخرى وصعوبات بدأت تتسلل الى هذا الفلسطيني على صعيد الهوية الضائعة والارض المصادرة والمستقبل الغامض في تلك الدول لكي لا يكون موضوع الشتات مهماً الى درجة تختفي معه قراءة مستقبل الفلسطينيين بواقعية وموضوعية بعيداً من الأمنيات وحتى لا يكون المنفى والشتات يشكلان باستمرار وجوداً وازناً في حياتهم وصراعهم من اجل البقاء بعيدا من هذه العصا الغليظة، ليبدأ الصراع مجددا في كيفية الحفاظ على الهوية المتمحورة في كلمة "فلسطين".
الروايتان تشتعل جذوتهما بكوابيس تل الزعتر وصبرا وشاتيلا وغيرها من التجارب المقيتة ما خلق ملحمة جديدة ووجهاً آخر لصور العذاب الفلسطيني حيث اصبحت جزءاً من تاريخه النضالي الطويل وما زال هذا النضال مستمراً وإن اخذ اشكالا اخرى تحت مطارق القمع والتهجير. ومن هذه الاشكال العلاقة مع الآخر والممارسات العنصرية، حتى صار الفلسطيني غنيا عن التعريف بأنه بدون هوية وبدون وطن وبدون تعريف، ما خلق له أزمة وجودية، مع أنه يناهض ويواجه هذه الموجات الحادة التي تحاول اقصاءه والوقوف في وجهه ويقوم بالتركيز على موضوع عودته وعدم تناسيه لارضه وهويته ووطنه. رجلاً كان او امرأة في المخيمات وبلاد الصقيع وغيرها، والتصدي لمحاولات الفساد والافساد المتفشية على ارض الواقع وان كانت صادمة بشكل عام وعدم جعل المرأة ضحية الواقع الاضطهادي الذي تقوم به آلت الحرب والبطالة والفقر وبطحن الرجال أيضاً.










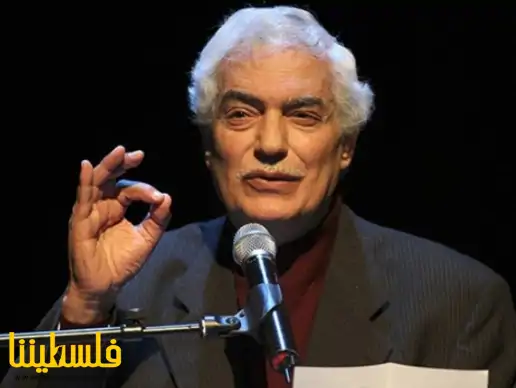







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها