قد تُظلم رواية "شمس بيضاء باردة" للروائية الأردنية كفى الزعبي، لفرط عمقها، وإسقاطاتها، ودلالاتها التي لم تترنح، رغم ترنح شخوصها الأساسيين على قلتهم في صراعهم مع أنفسهم، ومع المحيطين، ومع حياة يريدونها ويمقتونها لفرط قسوتها، ربما، ومع موت يريدونه، ويخشون منه، لفرط قسوته، ربما، أيضاً.
فالرواية تسقط جلجامش من عرشه الأسطوري، باستعارات على لسان "راعي"، ذلك المعلم "المثقف" المعدم، المنهزم، أو الانهزامي، المهمّش أو المهمّش لنفسه، فلا هو باحث عن الخلود الجسدي، ولا هو الواصل إلى قناعة جلجامش الأخيرة بأن الخلود بالأعمال لا بالأعمار، وكما هي سقطات أنكيدو، وعشتار، وغيرهما، لذا فالبحث عن روابط مشتركة ما بين الأسطوري والواقع في الرواية، لن يفيد لجهة تأويل مضامينها، هي التي يبدو أن هدفها الإطاحة بالأسطورة في الأساس، وليس إعادة تجسيدها عبر الشخصيات.
فجلحامش 2018 أو 2019، يائس، محبط، "مثقف" صوريّ أو يخال نفسه، فليس كل قارئ مثقفا، بل إن أي بطولات لم تسجل له، لا على المستوى الإنساني، هو النادم على أفعاله دوماً، وعلى أخطائه المقصودة المدفوعة بالاكتشافات، أو حتى تلك التي تحدث مصادفة، وهو الجبان غير القادر حتى على اتخاذ قرار بالانتحار بعيداً عن المتخيل والحلم، على عكس ذلك الأسطوري الباحث عن الخلود، والرافض للمغريات الجسدية، والذي خلد نفسه بأعماله قبل البحث جاهداً عن الخلود الجسدي الذي لا يصل إليه بشر، في حين أن "راعي" لم يخلد نفسه في أي عمل إبداعي، أو إنساني يترك وراءه أثر يتذكره عبره من يأتي بعده.
والأمر ذاته إذا ما ربطنا شخصية أحمد بـ"أنكيدو" وعائشة بـ"عشتار"، فإننا نجد إصراراً مكثفاً لدى كاتبة الرواية على القضاء على الأسطرة في ظل واقع شديد الضراوة والفتك بمن يقعون تحت وطأة براثنه.
وهي هنا، وعبر حكايات "راعي"، وصراعاته المتعددة واللامتناهية مع ذاته، ومحيطه القريب، وخاصة والده ومدير المدرسة، ومن ثم اتساع الدائرة لصراع مع مجتمع بغالبيته إن لم يكن بأكمله، تنقلنا الرواية إلى الحديث عن أزمات "المثقف"، إن كان "راعي" مثقفاً بالمعنى الحقيقي، فهل المثقف هو من يستبدل قوت يومه بزجاجات من الخمر، تبقى معدته فارغة، ورأسه تتقاذفها التخيلات حد التناقض؟!
ومع أن ظاهرة انتحار "المثقف" ليست جديدة، إلا أنها بدأت تظهر بكثافة نسبية، خاصة في الدول العربية، مؤخراً، فما بين همنغواي، والأديب الأردني تيسير سبول، والشاعر اللبناني خليل حاوي، والمطربة داليدا، وقبلهم فان كوخ وفرجينيا وولف، قوائم كثيرة تواصل قراراتها بوضع حد لحيواتها البائسة، وإن تعددت الأسباب، وهي ظاهرة تستحق التبّحر، وإن كان البعض يرى في تسليط الضوء عليها، انتصاراً للانهزامية، وليس الواقعية.
وإن كنت أرى أن الرواية، وربما عن قصد، تعمّدت استخدام عدسات مكبّرة في التعاطي مع الظاهرة هذه، إن وصلت إلى درجة الظاهرة، للالتفات إليها.
وما ينطبق على الانتحار ينطبق على الجنون، وفي هذين الجانبين، تراوح مصيرا جلجامش وأنكيدو (الأردنيان) في الرواية التي منعت قبل أن يعاد السماح بتداولها في الأردن، وسؤال المنع قبل السماح، قد يقودنا إلى فكرة عادة ما تؤرق الرقيب، ألا وهي "تشويه صورة البلد"، وكأن الواقع ليس أكثر سوداوية من رواية كهذه، أو أكثر فنتازية من روايات غيرها، ففي الواقع ما يفوق كآبة أي نص، أو خياله العلمي المفترض، أو فنتازيته مهما تطاولت، ولذا لا أجد في الرواية ما يسيء إلى المثقف، بقدر ما يدين المجتمع، إن كان، وأكرر، "راعي" مثقفاً بالأساس.
ولا يمكن لقارئ رواية "شمس بيضاء باردة" تجاهل دلالات تلك الغرفة القذرة الخالية من النوافذ، والتي كان يسكنها عجوز مهمل مات فيها، وكأنها الوطن بمفهومه الواسع، الذي بات يضيق على أحلام شبابه الصغيرة، في مجتمع يدفع بهذا أو ذاك إلى الارتماء في أحضان الوحدة، قبل أن يتملكه الجنون فينتصر لسُكر يعتقد أنه قد ينسيه ولو شيئاً يسيراً من واقعه، أو انتحار مجازي لشخص هو من ناحية بيولوجية على قيد الحياة .. هذا الانتحار المجازي هنا قد يكون أكثر قسوة من انتحار فعلي.
"من قال إن المرء يحيا بالخبز أو بالفكر؟ أنا الجائع العطش، المخذول، المهمّش، بالوهم وحده كنت دائماً أحيا. لا نقود لديّ، فقد رفض جميع زملائي المدرسين في الأمس إقراضي ولو ديناراً، وربما سيطردونني عمّا قريب من الوظيفة، وأعيش في غرفة بلا نافذة. يدهمني الرعب حينما أتذكر أنني سأعود إلى تلك الغرفة في المساء، فأهرع إلى حانة صديقتي .. يكاد الخوف يقتلني. يهجم عليّ في الليل ويشلّ أطرافي، سأتخيل العجوز الذي مات في الغرفة وتعفّنت جثته. سيساعدني المشروب على النوم. سينسيني الخوف (...)".










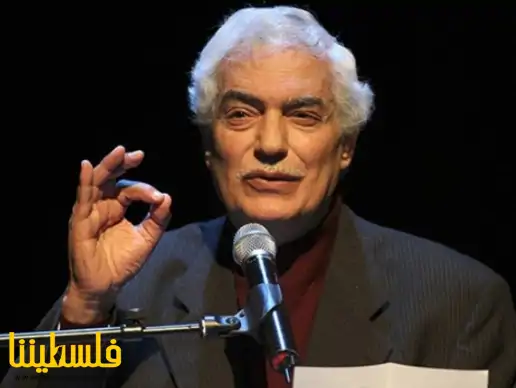







تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها