انتظرت كثيرا من الوقت لسبر أغوار ما يجري في الشارع الفلسطيني من تداعيات حول قانون الضمان الاجتماعي، ولاحظت عمليات استقطاب وتجاذب غير عادية في المدن، وفي أوساط النخب ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وبين أوساط رجال المال والأعمال، وارتدادات ذلك داخل أصحاب المصلحة الحقيقية في إصدار القانون وتطبيقه من العمال والمسحوقين بمن فيهم الموظّفون بمختلف درجاتهم. وعدت قرأت القانون مجدّدًا، لعلّي أجد المبرّر الموضوعي لحملات التشهير والتطبيل والردح غير المشروع، والمظاهرات، التي لم تحصل في أشد لحظات الصراع احتدامًا مع العدو الإسرائيلي ضدّ القانون والحكومة. للأسف الشديد لم أجد مبرّرًا موضوعيًّا واحدًا يمنح أولئك المتهافتين والمتساوقين مع رأس المال بشكل مباشر، ومع دولة الاستعمار الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ومن حيث لا يدرون، وإن كانوا يدرون، فهي المصيبة والطامة الكبرى.
أعترف أني لست رجل قانون، ولست متبحّرًا في قوانين الضمان الاجتماعي، ولكني أعلم علم اليقين، أني مدافع بثبات عن مصالح المواطنين الفلسطينيين عموما وطبقاتهم وفئاتهم الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة خصوصًا. ورغم أنّي محسوب نظريا وعمليا على المؤسسة الرسمية، غير أني لم أُداهن يوما مسؤولا أو مؤسسة عندما تقع في الخطأ، أو تسيء استخدام صلاحياتها، وأعترف أني محدود القدرة والتأثير، ورصيدي فيما أخلص إليه يعتمد بالأساس على الشعب ونخبه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الوطنية، التي تنطلق من مصالح العباد، وليس من جيوب رأس المال وأصحاب الشركات والمؤسسات.
وعليه فإني بموضوعية، وبعد التفاعل مع عدد من المختصين والسياسيين، الذين تابعوا فكرة القانون وولادته وتطوره إلى أن وصل إلى إصداره بشاكلته الحالية، أرى أن القانون أولا يحتاج إلى تعديل فيما يخص النسب المحددة للخصم من العمال والموظفين، لأن نسبة الـ7% عالية، وتحتاج إلى إعادة نظر بحيث لا تزيد عن 5%، رغم أن البعض يرى وفقا وتماثلا مع قوانين الضمان المعتمدة في دول الجوار العربي وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة تخفيض النسبة إلى 2,5%؛ ثانيا إعادة النظر فيما يتعلق بالورثة وخاصة المرأة، التي حرمها القانون من الوراثة في حال كانت تعمل. لأن الراتب هنا لها وللعائلة ككل؛ ثالثا توسيع نسبة مشاركة ممثلي العمال والموظفين وأصحاب العمل في الهيئات القيادية المشرفة على إدارة صناديق الضمان الاجتماعي، لخلق مزيد من الثقة بين المواطن والمؤسسة المنفذة للقانون؛ رابعا أقترح التدرج في تطبيق القانون، بحيث تبدأ من الشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية والمالية (البنوك وما يرتبط بها) والاتصالات الكبيرة، وأيضا وكلاء الشركات (الكمبرادور) الرأسمالية العربية والإسرائيلية والأجنبية، ثم تتدرج إلى المؤسسات الأصغر بعد ستة أشهر، ثم المؤسسات والورش ذات الطابع العائلي والصغيرة بعناوينها ومسمياتها المختلفة، ولا أدري إن كانت هناك ملاحظات أخرى يمكن إضافتها، مع ذلك أبدت القيادة ممثلة بشخص الرئيس أبو مازن ورئيس حكومته الدكتور رامي الحمد الله استعدادها لأخذ الملاحظات والانتقادات المختلفة المثارة حول القانون بشكل موضوعي، وفتحت الباب فعلا للحوار مع كل القوى المعترضة على القانون.
ومن الجانب الآخر، أرى أن القانون يصب في مصلحة الشعب، كل الشعب، لأنه قانون عصري، ومتميز في الخدمات، التي يقدمها للموظف والعامل، ويكفل له ولعائلته بعد وفاته حياة كريمة بالمعايير النسبية. وبالتالي الواجب والضروري أن يكون الشعب وقواه العاملة إلى جانب القانون، وليس العكس. لأنّ وقوفهم مع رأس المال وممثليه، يعني وقوفهم ضد مصالحهم وحقوقهم المسلوبة منهم طيلة سنوات عملهم في المصانع والمؤسسات والشركات والمزارع الكبيرة وبمستوياتها المختلفة.
وتكمن أهمية القانون في الآتي: أولا استعادة الأموال المكدسة في البنوك الإسرائيلية، وتقدر بمليارات الشواقل والدولارات، واستثمارها في الاقتصاد الوطني أو حيثما تراه الهيئات المختصة الموكلة المسؤولية على الصناديق المختلفة؛ ثانيا إلزام أصحاب العمل بتأمين راتب تقاعدي مناسب للموظف والعامل من الجنسين؛ ثالثا يحول دون نهبهم وسرقة جهودهم، أو التمنن عليهم من أصحاب العمل، وكأنهم يمنحونهم هبة وعطايا من أموالهم، أو كأنهم يمنحونهم زكاة أموالهم، وليس باعتبار نهاية الخدمة والراتب التقاعدي حقا مكتسبا لهم، دفعوا قيمته من جهودهم وقوة عملهم؛ رابعا إنصاف البسطاء من العمال وخاصة النساء والأطفال، الذين تنتهك حقوقهم دون أي وازع أخلاقي أو قانوني أو اقتصادي، حيث يتم استغلالهم بشكل مخيف، فلا يتم تسجيلهم في ملاكات الشركة أو المؤسسة أو الورشة، ولا يمنحون الحد الأدنى من الراتب المقر من قبل الحكومة، وليس لهم أية تأمينات على الحياة أو الطبابة ومستويات العجز الناجمة عن العمل؛ خامسا إيجاد نوع من التوازن داخل المجتمع، وحماية مصالح الفقراء والبسطاء من الناس، وتأمين مستوى لائق نسبيا للطبقات والفئات الاجتماعية الدنيا في المجتمع.
أما الحديث عن الثقة من عدمها بالحكومة ومستقبل السلطة، فهذا أمر مردود على كل من يردد ذلك. لان الحكومة الفلسطينية بكل الملاحظات المثارة حول عملها، هي افضل بكثير من حكومات عديدة في دول العالم الثالث، وأكثر مصداقية من العشرات من الحكومات المناظرة. دون ان أقلل من الثغرات الموضوعية والذاتية الموجودة في مؤسساتنا المختلفة. وأما المستقبل في بقاء السلطة من عدمه، فهذا الأمر مرهون بموضوع الصراع برمته، ولا يقتصر على موضوع قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي حصر الخشية على جانب جزئي ومتواضع جدا في مجمل العملية الفلسطينية بمختلف جوانبها، يعكس بؤس التفكير، وعقم تقزيم المسائل إلى جزيئات متناهية الصغر، فعندما تنهار السلطة، لا سمح الله، سينهار الكثير من مركبات المجتمع والمؤسسة السياسية والاقتصادية والمالية الفلسطينية. أضف إلى ذلك لو وجد أحد الفاسدين في المؤسسة، فإن القيادة ستلاحقه، وتعيده للوطن، لا سيما وان دولة فلسطين انضمت إلى الانتربول الدولي، وتمكنت من استعادة عدد من الهاربين، واستعادت الأموال، التي هربوا بها. ثم اسأل سؤالا للجميع، هل الشعوب العربية والعالمية الأخرى تثق بحكوماتها، وهي دول مستقلة؟ الجواب: لا لا تثق بحكوماتها، ومن يتابع يستطيع أن يرى بأم عينه حجم الصراعات بين الشعوب وحكوماتها بما في ذلك داخل الدول الرأسمالية المتقدمة.
على الفقراء والعمال وصغار الموظفين التنبّه للأخطار الناجمة عن عدم تطبيق القانون، وليس العكس. وفي الوقت نفسه تملي المسؤولية فتح باب الحوار بين الحكومة وممثّلي العمال وأصحاب العمل، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لحماية حقوق الجميع دون استثناء.




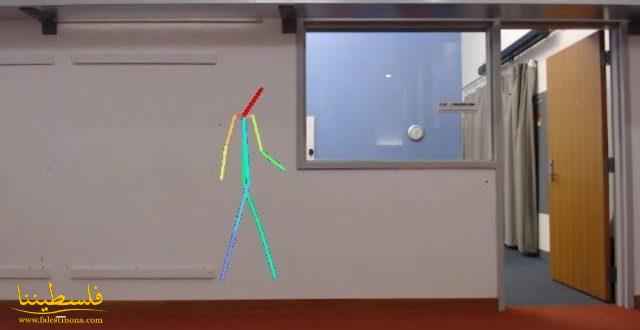





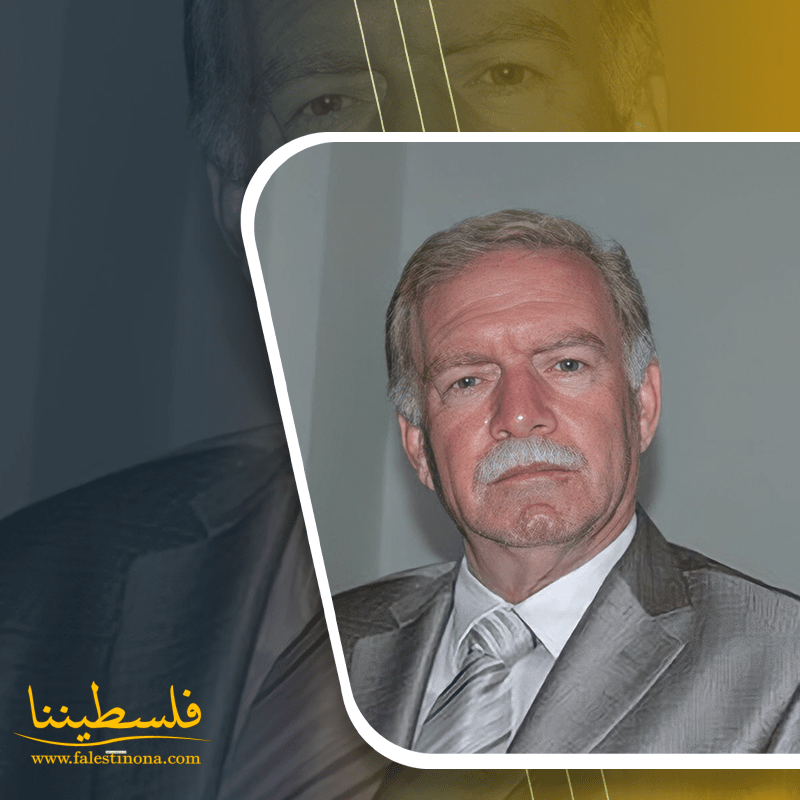

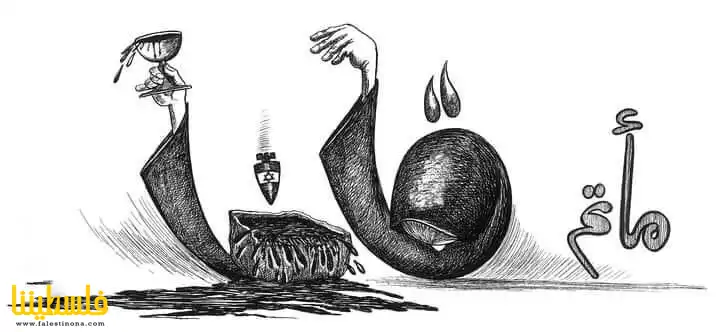



تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها