في حمأة واحتدام التنافس بين مكوّنات اليمين، واليمين الصهيوني المتطرّف على استقطاب أصوات المقترعين الإسرائيليين تحتل مسألة الاستيطان الاستعماري، وتكثيفها في أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967، واستباحة الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية أولوية في الخطاب الأيديولوجي والسياسي لها، حيث لا يمكن فصل المعركة الآنية (الانتخابات) عن الهدف الاستراتيجي للحركة الصهيونية، وقاعدتها المادية (إسرائيل) الاستعمارية، لا بل يوجد تكامل عميق بينها.
وفي قراءة سوسيولوجية لصعود المشروع الصهيوني الكولونيالي الإجلائي والإحلالي، لاحظنا مرحلة نشوء وتأسيس دولة (إسرائيل) عام 1948، واعتمادها على ثلاثة عوامل:
أوّلاً؛ الدعم والإسناد الغربي الرأسمالي للمشروع الصهيوني، وتأمين قواعد الارتكاز السياسية والقانونية (وعد بلفور، تأمين الهجرة والاستيطان، والإسهام في بناء القاعدة المادية الصناعية والزراعية، وقلب المعايير والحقائق رأسًا على عقب بين الشعب صاحب الأرض والوطن الفلسطيني، وبين المستعمرين الجدد، ومنحهم الأفضلية والأولوية، لدرجة أنَّ الشعب الفلسطيني تمَّ ذكره كأقلية من دون تسميته، ثُمَّ قرار التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وقيام الكيان الإسرائيلي على انقاض النكبة عام 1948).
ثانيًا؛ تلازم ذلك مع تأسيس نواة جيش الاستعمار الإسرائيلي من مجموع المنظمات الإرهابية الصهيونية المعروفة للجميع، وارتكاب سلسلة من المجازر لاقتلاع الشعب الفلسطيني عبر سياسة التطهير العرقي الصهيونية.
ثالثًا، تواطؤ النظام السياسي العربي آنذاك مع الغرب والحركة الصهيونية، ما هيَّأ الشروط لنشوء (إسرائيل)، ولم تقتصر حدودها على ما نص عليه قرار التقسيم، بل تمدَّدت مساحتها لتصل إلى 78% من مساحة فلسطين التاريخية.
تلت ذلك مرحلة جديدة من المشروع الصهيوني تمثَّلت في الآتي: تثبيت شرعية (إسرائيل) في الجيوبوليتك الإقليمي؛ وتعزيز قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية، وتطوير قوتها العسكرية؛ ومواصلة استقطاب المستعمرين الصهاينة من مختلف بقاع الأرض وخاصة من الدول العربية؛ بالتلازم مع تعميق سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين العرب حتى هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، ما منح الدولة الصهيونية تأكيد الذات من خلال الحروب، وأعطى جيشها صورةً "سوبرمانيّة" بدعم جلي من دول أووبا وأميركا.
ما بين 1967 و1993 تعزز الاستيطان الاستعماري الصهيوني في أراضي دولة فلسطين المحتلة عموما والقدس العاصمة الفلسطينية خصوصا استنادا إلى الأبعاد الأمنية والاقتصادية والدينية والآيديولوجية، فتنامى الاستيطان بشكل ملحوظ، واشترك في العملية كلٌّ من حزب العمل بشكل خاص حتى 1977، ثُمّ حزبا العمل والليكود بعد ذلك، وتلا ذلك صعود اليمين واليمين المتطرّف من كلّ ألوان الطيف الصهيوني بما في ذلك الحريديم المتزمّت.
غير أنَّ مرحلة مؤقّتة حصل فيها تراجع نسبي في مسار وصعود المشروع الصهيوني، تمثَّلت في الانتفاضة الكبرى 1987/ 1993، والتوقيع على اتفاقية أوسلو. إلّا أنَّ الكمون والمراوحة المحدودة لم تدم طويلاً، لأنَّ المطبخ الاستراتيجي الصهيوني لم يقبل فكرة وجود دولة فلسطينية ما بين البحر والنهر، وجرى التحريض على رئيس وزراء (إسرائيل) الأسبق، اسحق رابين، وتمَّ اغتياله باكرًا عام 1995، كإنذار لكلِّ صهيوني يفكر بإمكانية التساوق مع أيّة تسوية سياسية. ولذا تعاملت القوى الصهيونية المختلفة خاصّةً اليمين واليمين المتطرّف على القتل البطيء لاتفاقية أوسلو، وما أن جاءت الانتفاضة الثانية 2000 و2005 حتى تغيّرت الكيفية، التي تعاملت فيها القوى الصهيونية مع القيادة والمشروع الوطني الفلسطيني، رغم تفكيك المستعمرات من قطاع غزة أيلول/سبتمبر 2005، التي لم تكن سوى مناورة لاستباحة مظاهر السلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل بالتعاون مع قوى محلية على إضعافها، وشلِّ قدراتها، حيث جرى العمل بشكل حثيث لفصل القطاع عن الضفة عبر الانقلاب الأسود لحركة "حماس" على حساب الشرعية الوطنية أواسط 2007. وفي ذات الوقت، تصاعد الاستيطان الاستعماري بشكل غير مسبوق مع تولّي الليكود رئاسة الحكومات المتعاقبة، وتعزيز تحالفه مع اليمين المتطرف والحريديم.
وباستثناء فواصل زمنية متقطّعة برزت فيها إمكانية بناء ركائز تسوية زمن حكومة أولمرت 2006/2009، غير أنَّها سرعان ما انتهت. وتوالى صعود مضاعف للمشروع الكولونيالي الصهيوني بسن سلسلة من القوانين العنصرية في دورات الكنيست الـ18 و19 و20، والتي تجلَّت بوضوح في المصادقة على قانون "القومية الأساس"، الفاشي، الذي نفى أيَّ حق للفلسطينيين بتقرير المصير على أي جزء من أرض وطنهم الأم فلسطين، وحصر الأمر بالصهاينة اليهود. وبالتالي لم يعد خيار حل الدولتين قائما في الفكر السياسي الصهيوني.
ومع صعود اليمين الأميركي، ووصول الرئيس ترامب إلى سدّة الرئاسة الأميركية، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية 2017، ونقل السفارة في أيار/مايو 2018، وغيرها من القرارات المعادية للحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية، تجرأت حكومة نتنياهو الأخيرة (الرابعة والحالية) على نفض يدها من فكرة التسوية السياسية، وآخر ما تفتّق عن العقلية الاستعمارية الإسرائيلية، هو إصدار تعهد من قبل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، أكّدوا فيه مضاعفة الاستيطان في الضفة والقدس العاصمة وصولاً لتركيز مليوني مستعمر فيها على حساب الشعب العربي الفلسطيني، حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء الموافق 5/2/2019.
لكنَّ هذا الخيار هل هو قابل للتحقق؟ أم أنَّه سيصطدم برفض قطاع واسع من اليهود في العديد من دول أوروبا وأميركا الشمالية وغيرها من تلبية نداء الحركة الصهيونية؟ وهل الشعب العربي الفلسطيني سيرضخ للمشيئة الاستعمارية الإسرائيلية، ويبقى واقفًا ومستسلمًا، أم أنَّه سيردُّ الصاع صاعين للمخطط الاستعماري؟ وهل (إسرائيل) جاهزة لخيار الدولة الواحدة، أم ستلجأ لسياسة الترانسفير والتطهير العرقي للكلِّ الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية؟ وإذا ما تمَّ السير قدمًا في خيار اليمين الصهيوني، وتمّت تصفية السلطة الفلسطينية، هل ستكون دولة (إسرائيل) وأجهزتها الأمنية وكلّ مركباتها السياسية والقانونية والاقتصادية والدينية الحريدية قادرة على مواجهة التحديات الجديدة، التي ستكون اصعب وأعقد من كل المراحل، التي مرَّت بها الدولة الكولونيالية؟
يبدو أنَّ القيادة الصهيونية الحاكمة تقرأ التطورات من زاوية أحادية الجانب، من رؤيتها هي للواقع، دون قراءة الرؤية الفلسطينية، والابتعاد عن فهم ومعرفة حدود المرونة السياسية، والقدرة الكفاحية الفلسطينية الكامنة، والمؤهلة في كل لحظة على قلب الطاولة على رأسها، لأنَّ كلَّ عمليات التطهير العرقي الصهيونية، لن تتمكن من طرد الفلسطينيين، لأنَّهم تعلَّموا درسًا تاريخيًّا وهو عدم ترك أرض وطنهم الأم مهما كانت التضحيات، وعدم التنازل عن الحد الأدنى من حقوقهم الوطنية المتمثّلة باستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194، والمساواة الكاملة لأبناء الشعب في داخل الـ48. وهو ما يضع القيادة الصهيونية بمركباتها الأيديولوجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية في أزمة عميقة، لا حل لها من حيث المبدأ إلا الذهاب إلى أحد خيارين لا ثالث لهما: إمّا التمسُّك بخيار حل الدولتين، والعودة لتأصيله، وهو الأقل ضررًا، وإمّا الدولة الواحدة، وعندها مطلوب منها تغيير كل معادلاتها ومخططاتها، لأن آفاق المشروع الصهيوني ستكون نحو الأفول والاندثار، لأنّه سيصطدم بالبعدين الديمغرافي والسياسي والقانوني وحتى الأمني. خاصة أنَّ الشروط ستختلف، والمعادلات السياسية لن تبقى كما هي عليه الآن، والعالم يسير تدريجيًّا نحو التغيير، والعرب لن يبقوا في دائرة التراجع والانكفاء والهزيمة، والمستقبل كفيل بالجواب على الصهيونية وخياراتها العدمية والإرهابية.









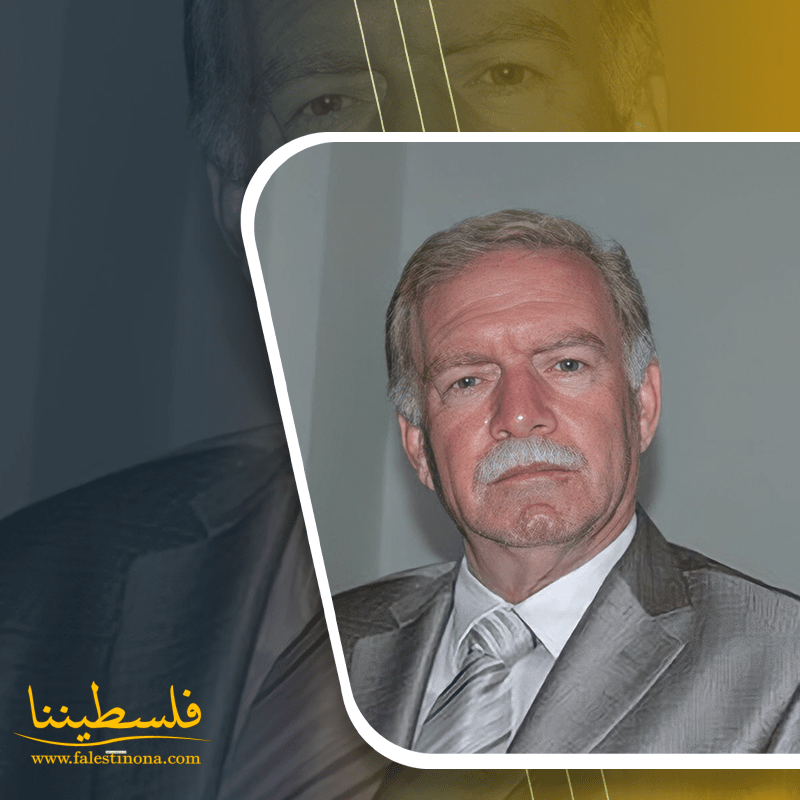
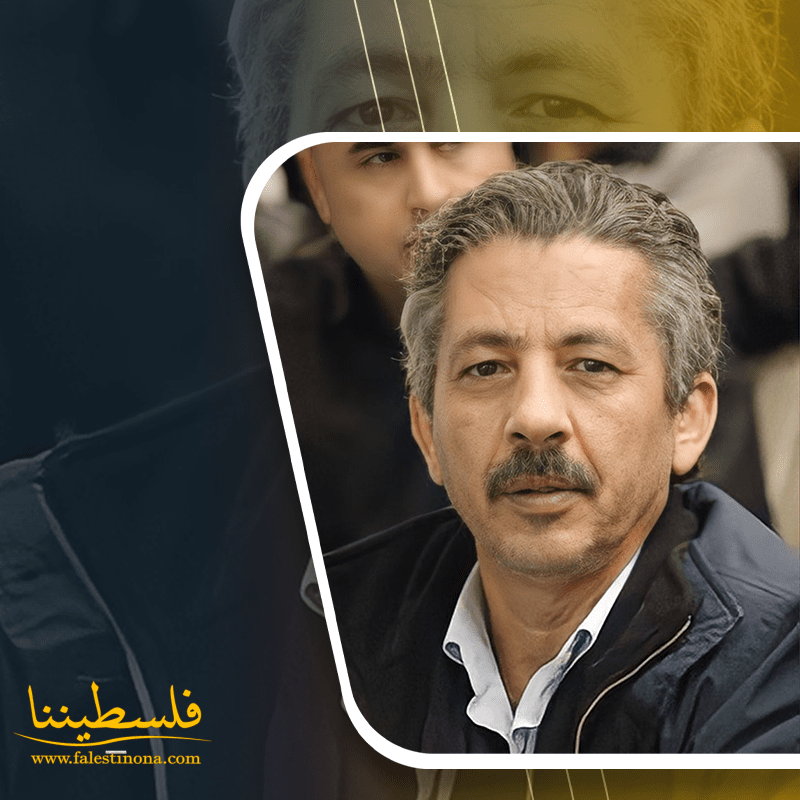






تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها